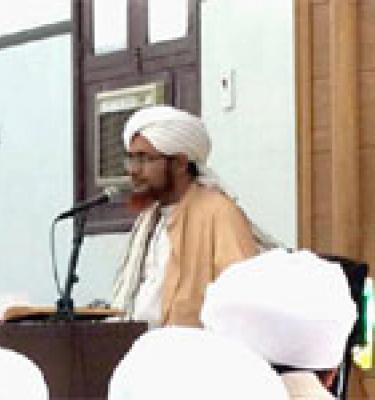تفسير سورة الكهف(1434) -3- من قوله تعالى: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ..(6))

درس يلقيه الحبيب عمر بن حفيظ في تفسير سورة الكهف بعد الفجر ضمن دروس الدورة التعليمية التاسعة عشرة بدار المصطفى 1434هجرية.
نص الدرس مكتوب:
﷽
(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8))
الحمد لله، قد قرأنا سورة الكهف في صباح يوم الجمعة، وقد أرشدنا إلى ذلك مَن أُنزلت عليه هذه السورة، نبينا محمد، أنور الخلائق بصيرة، وأهداهم مسلكا وسيرة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومَن سار مسيره، وانْقطر بتلك القطيرة، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وكان من إرشاده في أحاديثه لنا:
- ما صحّ في الحديث أنّه ﷺ قال: "مَن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورٌ إلى الجمعة الأخرى".
- وجاء أيضاً في الحديث الصحيح: "مَن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا من مكان قراءتها إلى البيت العتيق".
- جاء في رواية ثالثة: "مَن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نور إلى عنان السماء يبعث فيه يوم القيامة -أو يكون معه يوم القيامة-".
- جاء في رواية رابعة: "مَن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان معصوماً إلى ثمانية أيام، حتى لو خرج فيها الدجال لم يتّبعه ولم يُضلّه".
إلى غير ذلك ممّا ورد في قراءة سورة الكهف خصوصاً في هذا اليوم، فالحمد لله الذي وفقنا لقراءتها ونسأله أن يقبلها منا.
وقد ابتدأنا بتذكّر معاني السورة الكريمة ووصلنا إلى قوله جلَّ جلاله وتعالى في عُلاه: (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6))، الحقّ تبارك وتعالى بعد أن ذكر:
- المِنّة الكبرى بإنزال هذا الكتاب على هذا العبد المقرّب الأطيب الأنور صلى الله عليه و على آله وصحبه وسلم،
- ودعوته بالإنذار والتبشير،
- ورَدَّ على مَن يتّخذ الاعتقاد الباطل في ذات الله تبارك وتعالى وينسب إليه الولد: (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5))،
- مع بشائر حملها للمؤمنين: (أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3))، اللّهمّ اجعلنا منهم.
خاطب صاحب الرسالة: أنّك يا حامل هذه الأمانة، بما أودعنا قلبك من خالص الرّحمة، يشقّ عليك حال المُكذّبين والمُعرضين والجاحدين، لما تخافه عليهم من غضبنا وسخطنا ودخول النار وما لا يُطيقونه من العذاب.
(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ) -وبَخَعَ بمعنى أنه دلّل أو أوصل الأمر إلى ما يكاد أن يغلب عليه، فمن معانيه: بَخَعَ نفسه، شَقّ عليها وحمّلها حتى كادت أن تتلف وأن تهلك، ولذا فسّر الكثير من المفسرين (فلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ) -مهلكٌ نفسك- (عَلَىٰ آثَارِهِمْ (6)) وراء هؤلاء القوم، (عَلَىٰ آثَارِهِمْ) يعني وراء تكذيبهم وإنكارهم وجحدهم.
(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ) -إن لم يُصدّقوا بهذا الحق الذي جئت به، وبهذه الحقيقة التي لا حقيقة سواها- (فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6))، أي لأجل الأسف، توصل نفسك إلى أن تَبْخَعَها أي تشقّ عليها، تُتعبِها من الأسف حتّى تكاد أن تهلك.
(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ) -أي من وراء ما كان منهم من هذا التّكذيب والجحود- (إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6)) وهو إذن يأتي بمعنى الحال، وأنه المفعول لأجله، لأجل الأسف، وفي هذا بيان ما يجب أن ينطوي عليه قلب المؤمن الدّاعي إلى الله تبارك وتعالى:
- وهو أن يحرص كل الحرص على الناس من حواليه، ويشقّ عليه تعرضهم لمقت ربهم، تعرّضهم لسخطه،
- فيحمل نفسه على استقصاء الجهد والمُستطاع في إنقاذهم وفي تخليصهم،
- فيصير حاله أنّه كلما توصل به إلى إنقاذ الناس من الشر، من الكفر، من المعصية، من الذنب، من الإثم إلى النور والهدى والخير؛ فلا يتراجع عن البذل وعن التضحية لما يجد في قلبه من حُرقة بالغة لأحوال الناس رحمةً بالخلق واقتداءً بنبيّ الحق واتباعا له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6))، فعلى كلّ مؤمن فينا أن ينظر مدى تأثّره بما كان منه من مخالفة لأمر الله، وتعرّض لسخط الله من خلال نيّاته أو أعماله أو أقواله التي صدرت منه؛ نظراته ومسموعاته ومُعاملاته وحركاته وسكناته، ثم كيف يُفيض هذه الرحمة كما رحم بها نفسه فيرحم مَن حواليه، حتى يهتمّ بأنّ على ظهر الأرض مليارات، إن ماتوا على الحالة التي هم عليها الآن تخلّدوا في النار الموقدة، (الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ) [الهمزة:7].
فكيف يكون الأمر هيناً؟ كيف يكون الأمر يسيراً؟ ونرى الناس يتسابقون في واقع حالهم إلى التعبير عن الإنسانية، والتعبير عن المعروف، والتعبير عن حمل الفضيلة، عندما تقع النّكبة والكُربة بهذه المدينة أو تلك، وهم على مستوى الأفراد والأحزاب والهيئات والجمعيات والدول يُسارعون إلى تقديم المعونات والإنقاذ وإلى العمل الخيريّ، إلى غير ذلك ممّا يتحدّثون عنه، أمر جميل لو قام على حقيقته.
كيف لا نتأثّر بتعرّض الناس لغضب خالقهم وسخطه ولِحلولهم في النار التي وقودها الناس والحجارة؟! والتي تذيب الجبال الصلبة الصماء؟! اللهم أجرنا من النار.
ولذا قالوا هذا وجه من أوجه تحمّله عليه الصلاة والسلام للمشاقّ فيمَن آذاه، فإنه يوقن بأنّهم إن ماتوا على ذاك الحال، صاروا إلى النّار وخُلّدوا فيها؛ فما كان من وُصول السّهام إليه، أو شَجِّ جبينه، أو جَرْحِ وجنتيه، أو نُزول قطرات الدم من وجهه الشريف ﷺ، يهون عليه في نفسه مُقابلَ إنقاذ هؤلاء من النار إلى الجنة، لأن الأمر عنده يقين لا مِرية فيه ولا رَيب.
وأنت ترى أنّ صاحب الكرامة الإنسانية، إذا أيقن بسقوط واحد في مهواةٍ وشدّة، لا يُبالي بأن يتعرّض للَطمَة منه أو رَفْسَة مُقابلَ أن يُخلّصه من هذه الشدة؛ فيرى نفسه أنّه سهل عليه أن يؤخذ شيء من حقه أو يُنتقص شيء من قدره مقابلَ ما سلّم منه هذا الإنسان من الهلاك الكبير؛ ولا شكّ أن أعظم الهلكة، التّعرّض لغضب الله جلّ جلاله والخلود في ناره -أجارنا الله منها-.
ومع هذا التأثّر ومع هذا التحمّل؛ فمُوازنة بينه وبينَ التّسليم لأمر الله تبارك وتعالى، كما نرى في عدد من الآيات سلّتْ النبي ﷺ، حامل هذه الرحمة، ويقول له ربه:
- (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) [يونس:99].
- (لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ) [الشعراء:3-4].
ولكن الله علّمه أن له حكمة في أن يُدخل مَن شاء الجنة ومَن شاء النّار -جلّ جلاله وتعالى في عُلاه- وأنه لا يُريد أعناقا خاضعة، ولكن قلوبا خاضعة، لا مُجرّد خضوع الأعناق ولكن يريد القلوب التي تخضع له سبحانه وتعالى، ولو جاءت آية قهريّة لَخَضَعت الرّقاب كلها، ولكنّ الله إنّما ينظر من الناس إلى قلوبهم، ويريد أن تخضع قلوبهم، ويُحبّ أن يُقبل المُقبل عليه بمحبّة وشوق وفرح واختيار، ولهذا قال: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) [البقرة:256].
(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6))
-يقول الله تأمّل في حِكمتنا البالغة- (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7))؛ فجعل الله ما على الأرض؛ من أشجار، ومن قصور، ومن غير ذلك ممّا تتزيّن به الأرض.
قال تعالى: (زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ) -نَختبرهم- (أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7))، أي أحسن نظرا ورأيا وعقلاً وفهماً، عليه يترتب حسن العمل:
- فإنّ الغافل والجاهل، إذا نظر إلى زخرف هذه الزينة، أقبل عليها وبذل فكره وعقله وعمره لها، وانقطع عن ربّه -جلّ جلاله- ولم يُبالِ أن يرتكب في تحصيل هذه الزينة والفرح بها أيّ ذنب، أو تَرْك أيّ واجب، والعياذ بالله تبارك وتعالى.
- وصاحب العقل والكِيَاسة والنّظر، يعلم أن هذه الزينة ليست مقصودًا في ذاتها ولا معوّلا عليها في شأنها، وإنّما يحتاج الإنسان منها في الدّنيا إلى ما يُقيم به المهمّة التي خُلق من أجلها لِيستعدّ للقاء الله.
وفي تعبيره تعالى بقوله: (زِينَةً لَّهَا) إشارة إلى أنّ هذه الأشياء التي تُزخرف بها الأرض ليست زينة ابن آدم؛ فمن اعْتنى بزخرفة بيته أو سيارته أو مزرعته، فما زيّن نفسه، إنما زيّن الأرض؛ فليست زينة لنا، (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ) -زِينَةً لَّكم أو زِينَةً لَّهَا؟!- (زِينَةً لَّهَا (7))، لهذه الأرض، اذْهَب أنت وعمك وحالك، وقريبا ستموت ويُدفنونك، فتخرج إلى قبرك، وانظر ما عملك بعد هذا؟ هذا ما هو زينٌ لك هذا أصلا، هذا لا يزينك بشيء، لا يرفع قدرك.
زينتك أنت معرفة الإله، زينتك تقوى الله جلّ جلاله، هذا زينتك أنت؛ أمّا الخارجي هذا، كلّه زينة الأرض، تذهب وتتركه، أو يهلك وأنت تنظر إليه، ولا يرفع من قدرك شيء، ولا يخفض فَقْدُه من قدرك شيء، ليس هذا زينتك.
زينتك أنت الإيمان والعلم والعمل الصالح، اذهب تزين بها، هذه الزينة تبقى لك ومعك إلى قبرك ويوم حشرك مُزيَّن بها، أمّا ما صُنع لنا من أعلام وأشجار والقصور وديار وسيارات، وبعد ذلك، أنت ما الذي معك من زينة، هذه زينة الأرض. فأين زينتك أنت؟ فإذا بقيت أنت من دون زينة، ما أغنت عنك زينة الأرض.
وزينة الأرض لا تبقى بحال، (وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8))،
- صَعِيدًا: قاعاً،
- جُرُزًا: لا يقبل النّباتَ ولا يقبل الإرتقاء ولا يقبل الحُسن بعد ذلك.
- (وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) [الإسراء:58].
حتى يعمّ الدّمار الحسّيّ جميع بقاع الأرض، بقعة بعد بقعة، حتى تكون آخر الأرض خرابًا، المدينة المنوّرة؛ وحتّى المدينة المنورة يأتي عليها أيّام كما جاء في الحديث: "لا يكون فيها إلا الوحوش والسباع خاوية"؛ هكذا أخبر، وهذه حكمة الله وهذا حكمهُ على الأرض وما عليها، (وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8))، هكذا يُبيِّن الحقّ جلّ جلاله وتعالى في عُلاه.
وبعد هذه المقدمة العظيمة عن ذكر المهمّة الكبرى، والنّعمة العظمى، ونُزول الكتاب، ووُجود العبد المُنيب الأوّاب، الحامل لأعباء الكتاب الذي لا يستطيع تحمّله جبال ولا غيرها (لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) [الحشر:21]، وحمَلها قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وبلّغه إلينا عليه الصلاة والسلام، وشأن الإنذار والتّبشير وافتراق الخلق المكلّفين على ظهر الأرض؛ إلى مؤمنين وكفّار، ابتدأ يقصّ قصة الكهف أو أصحاب الكهف علينا سبحانه وتعالى، واعْتنى بالقصة بنفسه، بعد سؤال مما جرى أيضاً في مكة من مُحاورات:
- وكان بعضهم قد قرأ من الأخبار أو تعلّم شيئاً من علوم التاريخ أو أخذ شيئاً من أخبار الملوك السابقين إلى غير ذلك، وإذا تكلم ﷺ ببعض أخبار مَن مضى فيما أُوحِي إليه للعبرة والفوائد، يرجع إلى المجلس ويقول: أنا أُحدِّثكم حديثاً أحسن من حديث محمد؛ ويقصّ عليهم قصص بعض الملوك ممّا قرأه ودرسه، ثم يؤذي النبي ﷺ ويُلقي عليه من المُحاورات ما يردّ عليه ﷺ بالحجة القاطعة؛
- حتى الْتَجَأ جماعة من المعاندين من قريش إلى اليهود وقالوا: أنتم أهل الكتاب وأخبرونا بخبرِ هذا الإنسان بيننا؛ فقالوا لهم: اسألوه عن فتية مضوا في الزمن الماضي وفي ماضي الدهر، وعن ملك ملَكَ الأرض، وعن الرّوح، فإنّه لا يُجيب عنها إلا نبيّ؛ فرجعوا يقولون لقومهم: جئناكم بالأمر الفاصل بيننا وبين محمد، وألقوا السؤال على النبي محمد عن هؤلاء الفتية أصحاب الكهف، وعن ذي القرنين هذا الملك، وعن الروح؛ فانتظر صلى الله عليه وسلم حتى نزل الخبر من السماء وأجابهم: (وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ) [القمر:2] -والعياذ بالله تبارك وتعالى-.
فيأتي معنا قَصُّ الله علينا هذه القصة التي اعتنى بها، رزقنا الله الاعتبار والادِّكار بما فيها، وجعَلنا من المتدبرين لآياته المنزلة على خير بريّاته، المتنوّرين بنورها، المهتدين بهدْيِها.
اللّهمّ ثبّتنا على الحق فيما نقول، ثبّتنا على الحق فيما نفعل، ثبّتنا على الحق فيما نعتقد، وانظر إلينا في أول جمعة من جمعات شهر رمضان الكريم المبارك التي يبيت المنادي منك يُنادي طيلة ليلتها: هل من سائل فأعطيه سُؤلَه؟ هل من مُستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجةٍ فأقضيَ حاجته؟ اللّهمّ بارك لنا في يومنا هذا، وبارك لنا في ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وارزقنا اغْتنامها، اللّهمّ وثبّتنا على ما تحبّ، واجعَلنا في مَن تحبّ.
بسر الفاتحة
إلى حضرة النبي محمدﷺ
06 رَمضان 1434