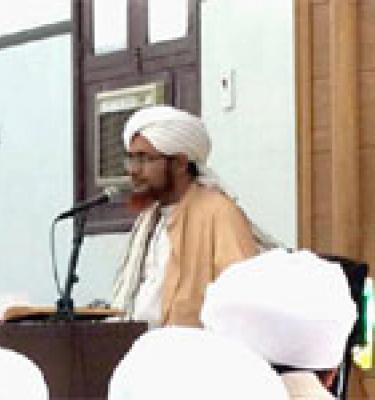تفسير سورة الكهف(1434) -2- من أول السورة

درس يلقيه الحبيب عمر بن حفيظ في تفسير سورة الكهف بعد الفجر ضمن دروس الدورة التعليمية التاسعة عشرة بدار المصطفى 1434هجرية.
نص الدرس مكتوب:
﷽
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ (1) قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5))
(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ) [الإسراء:1]، وختم سورة الإسراء أيضاً بالحمد والأمر بالتَّكبير؛ ثُمَّ ابتدأ سورة الكهف بالحمد، وفيه:
- أنَّ التَّسبيح هو:
- المقدِّمة والباب إلى الوُلوج إلى معاني الحمد.
- فإنَّ التَّسبيح تقديسٌ وتنزيه.
- وإنَّ الحمد، شكرٌ وثناء.
فالتَّسبيح بداية، والحمد نهاية؛ لذا تجده يتقدَّم دائماً التَّسبيح على التَّحميد، فنقول: "سبحان الله والحمد لله"، وفيه إشارةٌ إلى:
- أنَّ صاحب التَّسبيح يَصلُحُ ويَكمُلُ في ذاته.
- وصاحب الحمد يكون نافعاً ومفيداً لسواه.
فيَبتدئ الكمال في الذَّات، ثُمَّ يكون الإنسان أكمل إذا صار نافعاً للغير ومفيداً للغير.
افتَتَح ربُّنا تعالى سورة الكهف بالحمد له: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا (1))، وفي حَمْدِ الحقّ -سبحانه وتعالى- نفسَه معانٍ واسعة كبيرة ومِنَن على الخلق. قال الإمام زينُ العابدين في تحميده: "الحمد لله الذي حَمِدَ في الكتاب نفسَه"؛ وذلك أنّه لا يستطيع أن يقوم بحقّ حمدِه أحدٌ من الإنسّ ولا الجنّ ولا الملائكة كما ينبغي لجلال وجهه إلَّا هو -سبحانه وتعالى-.
فهو بذلك حَمِدَ نفسه، ففتح الأبواب في الفضل والعطاء للحمّادين الذين يحمدونه -سبحانه وتعالى- بأن يقبل منهم الحمد؛ فيندرجُ في حمده لنفسه، فيَكمُلُ نقصه وضعفه والعجز الذي فيه من وصفهم "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَمِدَ فِي الْكِتَابِ نَفْسَهُ".
(الْحَمْدُ لِلَّهِ)، الثَّناءُ الجميلُ والشُّكر العظيم مُستَحَقٌ لله، فإنَّه أهل الحمد -جل جلاله- بكلِّ المعاني، وما يُحمَد سواه على أيّ وجه صحيح إلّا عَادَ معنى ذلك الحمد لكلّ مخلوق إلى معنى حمد الخالق -جلَّ جلاله- من حيث أنَّ كل مخلوق كان عدماً:
- فمهما أُوتيَ إيجاداً بعد العدم، وأُوتِي كمالاً أو فضلاً، وأُنعم عليه بشيء مما يستحقّ عليه الحمد.
- فحامدُه إنّما حَمِد في الحقيقة مُوجدَه، ومُعطِيه هذا الفضل الذي استحق به أن يُحمد؛
إذًا فكل حمدٍ صحيحٍ لأيّ كائن ومخلوق؛ راجِعٌ إلى حمد الخالق المُوجِد المُنعم -سبحانه وتعالى-؛ فالحمدُ حقيقة بكل معانيه لا يَنصرفُ إلّا للقدُّوس مولانا الأعلى الخالق -جلَّ جلاله-؛ لأنَّ كل فضل فيما سواه فهو منه، وهو موجده وهو خالقه..
- فإذا مدحت الصَّنعة؛ فإنّما مدحت الصَّانع.
- وإذا أثنيت على الصَّنعة؛ فإنّما أثنيت على الصَّانع.
فكذلك كل حمد لشيءٍ من الكائنات؛ إنّما يرجع إلى حمد المُكوِّن الذي كوَّن هذا الكائن، وأعطاه هذا الوصف الذي استحقّ الحمد عليه؛ فالحمد في الحقيقة لله.
ثُمَّ إن هذا الحمد بابَ قُربةٍ عظيمة إلى الله تعالى، بل هو من أقوى أسباب استجلاب الفضل والمزيد من عند الله سبحانه وتعالى؛
يقول سيدنا الإمام -زين العابدين- في تحميدتهِ: "واستفتَحَ بالحمد كتابه وجعل الحمد دليلاً على طاعته، ورضي بالحمد شكراً له من خلقه"، وربط -سبحانه وتعالى- بذلك المزيد ومواصلة العطاء؛ ولذا ينبغي أن يُستفتح كل دعاءٍ لله؛ بالحمد.
وفي الحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سمع رجلاً كان صلّى ثُمَّ أخذ يدعو، فقال: "عجِلتَ، إذا أردت أن تدعو؛ فاحمد الله وأثنِ عليه ثُمَّ صلِّ عليَّ ثُمَّ ادعُ"
فبينما هم جلوسٌ إذ أقبل آخر فصلّى ركعتين ورفع يديه، فحمد الله وأثنى عليه وصلّى على النّبي، ثُمَّ أخذ يدعو والنَّبي يسمعه، فقال: "أَوْجَبَ إن خَتَم". فقال بعض الصَّحابة -من حرصهم على معرفة الخير وإيصال الخير لبعضهم البعض- قالوا: بِمَا خَتَم يا رسول الله؟ قال: "إن خَتَم بآمين أَوْجَبني". أَوْجَب استجابة الدعاء، هذا دعاء مستجاب إن ختم بآمين. "أَوْجَبَ إن خَتَم" فقام الصحابة إلى عند صاحبه الدَّاعي يقول: اختِم بآمين وأَبشر، فختم دعاءه بآمين، قال: ما أَبشر؟! قالوا: هذا رسول الله سمِعك حمِدت الله وصلّيت عليه ثم دعوت، فقال: "أَوْجَبَ إن خَتَم". قلت: وبم يَختم يا رسول الله؟ قال: "إن خَتَم بآمين". فختم الدُّعاء بآمين، وحقّ له بشارة المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
بل في أعظم المواقف على الإطلاق وأشدِّها، هو موقف الغضبة الكبرى يوم القيامة؛ حينما يتشفَّع المصطفى مُحمَّد، إنّما ينطلق في الحمد والثَّناء على الله بمحامد لم يَحمد بها أحد قبله، لا نبيّ مُرسل، ولا ملك مُقرَّب، ولا غيرهم من المخلوقات، يفتح الله على رسوله باباً من معاني الحمد يحمده به لم يحمده به أحد قبله؛ هذا النَّبي المصطفى.
بل قال في حديثه الصحيح: "يُلْهِمُنِي إيّاها لا أعلمها الآن"، قال: محامد، أنا الآن ما أعلمها ولا أعرفها؛ في تلك السَّاعة يُلْهِمُنِي الله إيّاها -تلك المحامد- ونحن نعرف الجواب على تلك المحامد، أنَّ الإله الحق المحمود يقول لنبينا: "يا محمد، ارفع رأسك وَسَلْ تُعطَ، وقُل يُسمع لقولك، واشفع تُشَفَّع". فإنّما كان دعاؤه في الموقف الخطير، في ساعة يقول الأنبياء فيها: "إنَّ ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري"، ويقول نبينا: "أنا لها"؛ فيا فوزنا بهذا النبي، "أنا لها"، ويسجد، قال: "فأحمد ربي بمحامد يعلّمني إياها ويلهمني إيّاها لا أعلمها الآن، حتى يُقال لي: ارفع رأسك وتُقبل الشفاعة"؛ فمفتاحُها هذا الحمد.
ولهذا اختار الله أن يكون الّلواء الذي يحمله حبيبه في القيامة اسمه "لواء الحمد". قال: "ولواء الحمد بيدي يوم القيامة"، ويُدخِل الله تحت هذا اللواء جميع الأنبياء والمرسلين والصالحين من أممهم، المؤمنين أجمعين، "آدم فمَن دونه تحت لوائي يوم القيامة"؛ فمَن أكثرَ منّا الحمد بمعانيه لله في الحياة، كان قريباً من ذلك الّلواء، وكان في الصُّفوف الأولى تحت ذلك الّلواء.
وفي وصف هذه الأُمَّة أنَّهم الحمّادون:
- يدخلون الجنّة قبل غيرهم من الأمم، وأوّل من يدخل الجنّة من هذه الأمة كثيرو الحمد -الحمّادون لله -تبارك وتعالى-، المُستشعرون مِنَّة الله عليهم، وإفضالَهُ عليهم، وجودَهُ عليهم، فهم دائماً يحمدون الله.
- وفي وصفهم في التوراة: "يحمدون الله على كل شدّةٍ ورخاء"؛ في الشّدائد وفي الرَّخاء يحمدون الله، في المرض وفي الصّحة يحمدون الله، في الفقر وفي الغنى يحمدون الله.
- وفي الحديث أنه قال لبعض أصحابه: "كيف حالك؟" أو "كيف أصبحت؟" فقال: بخير يا رسول الله. فقال: "كيف حالك؟" أو "كيف أصبحت؟" قال: الحمد لله بخير، فقال: "هذا الذي أردت منك"، أول مرة قال: بخير، ما قال: الحمد لله. فالنّبي ردّ السؤال عليه، فلمَّا قال: الحمد لله، قال: "هذا الذي أردت منك"؛ استَخرِج منك الحمد لِتفوز بثواب الحمد وبركة بالحمد..
- وفي الحديث الصّحيح أيضاً يقول نبينا: "والحمد لله تملأ الميزان"، يعني ثوابها لقائلها إذا قُبلت منه يملأ كفة الميزان في القيامة، وكفَّة الميزان أوسع ممَّا بين السّماء والأرض.
- حتى "سبحان الله" وحدها ما ذكر هذا الثواب فيها؛ إلّا قال: "وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السّماء والأرض"، مع الحمد.
- "والحمد لله" وحدها تملأ الميزان؛ وكفَّة الميزان أوسع مما بين السّماء والأرض؛ ثَقَّل الله موازيننا وجعلنا من الحمّادين.
الحمد لله على نعمة الإيجاد، وعلى نعمة الإمداد، على نعمة الإسعاد بـ"لا إله إلا الله". على نعمة الإسلام والإيمان، على نعمة العمر، على نعمة العافية، على نعمة السّمع والبصر، على نعمة إدراك رمضان، على كلّ نعمة لله علينا نعلمها أو لا نعلمها، وما لا نعلم أكثر ممّا نعلم، وأعظم ممّا نعلم، وأكبر ممّا نعلم؛ الحمد لله.
ثُمَّ إنَّه يستحقّ تعالى الحمد بكل المعاني وبكل الوجوه بإفضالاتٍ له ومِنَنٍ وجلالٍ وجمالٍ وكمالٍ لا حدّ له ولا غاية -سبحانه-.
ولكنَّه ذكر في هذه الآية باباً من أبواب الحمد، ووجهاً من أوجه الحمد له، نحمده لماذا؟ يقول: -انظروا إلى هذه النِّعمة الكبيرة- (الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ..(1))؛ فجعل النِّعمة الكبيرة التي نحمده عليها: نُزول هذا الكتاب، وُجود هذا الكتاب بين أظهرنا. أهذا أمر يسير؟! كلام العليم القدير بين يديك، تتصفحه من أوّله إلى آخره، محفوظًا، منقًّى، مهما حاول أعداؤه وأعداء رسوله أن يزيدوا حرفاً واحداً أو يَنقُصوا حرفاً واحداً؛ افتُضِحوا واكتُشفوا، ما قدروا، (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر:9] فها هو بين أيدينا كما نَزل، وكما خرج من بين شفتيّ النَّبي الأجلّ، من أول سورة إلى آخر؛ مئة وأربع عشرة سورة، كل الحروف كما خرجت من بين شفتيّ النبي الموصوف بأحسن الوصوف ﷺ، محفوظٌ موجودٌ بين أيدينا نقرأه؛ الَّلهم لك الحمد.
أيُّ كنز هذا معنا؟! أيُّ شرف هذا لنا؟! فمن عَرف قَدَر الكتاب، تولّع به، وطَرِب به، وأحبَّه، وأكثر تلاوته؛ فحاز بذلك سعادة الدنيا والآخرة
- مَن جعله أمامه قادَهُ إلى الجنَّة،
- ومَن جعله خلف ظهره ساقَهُ إلى النَّار.
فالحمد لله على نعمة وجود هذا الكتاب بيننا، جعلنا الله ممّن يعرف قدره ويعرف أمره فيَمْتَثِل، ونهيه فيَنْزَجِر ويبتعد، ويعرف أسراره ويعرف معاني الخطاب فيه من ربّنا لنا -اللّهمّ آمين-. اللهم ألِّف بيننا وبين الحرف من كتابك والكلمة والآية والسُّورة ائتلافاً لا يُفارقنا طرفة عين، وَبِهِ يُوصف أخيار الأُمَّة، خاصتهم من الذين اتصلوا بالقرآن اتصالاً خاصاً؛ فيُقال: امْتَزَج القرآن بِلَحمه ودَمِه.
وهكذا وجدنا شأن القرآن وتولّع قلوب الصَّحابة به؛ فأخيار التَّابعين، فتابعِيهم بإحسان، حتى أدركنا من المشائخ مَن كان قويّ الحفظ لكتاب الله، فإذا نام قرأ القرآن، والأعجب وهو في نومه يقرأُ القرآن، أنَّه في كثير من أحيانه حيث وقف في النَّوم الأوّل يبدأ في النوم الثاني -عندما ينام المرَّة الثانية، يبدأ من حيث وقف في المرة الأولى-
وكان بعض مشائخ مشائخنا، بين يديه بعض القائمين بالخدمة، أخذ يُكبِّس رجله فنام، وإذا به يقرأ القرآن، وهذا يسمعُهٌ يقرأ، فيظنّه مستيقظاً، حتى كان نصف الليل استيقظ للقيام، فوجد الرجل، قال: ما لك واقف إلى الآن؟ قال: منتظراً تقول لي يكفي، قال: أنا نمت. قال: أنا أسمعك تقرأ، لا إله إلا الله! لم ينكر شيئاً أنّه نائم؛ لأنَّ صوته بالقرآن يجلجل في طول منامه حتّى قام من النَّوم وهو يقرأ كتاب الله -جلّ جلاله وتعالى في عُلاه-، ربطنا الله وإيّاكم بهذا الكتاب.
- : "اقرأوا القرآن" -يقول نبينا- "فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه".
- وفي الحديث الآخر: "أهل القرآن هُم أهل الله وخاصّته".
ومِن أعظم ما تكون به النّجاة في القيامة شيئان: القرآن والصِّيام، يُحاجَّان عن صاحبهما، يجادلان عنه للنّجاة من العذاب.
- يقول القرآن: "يا ربّ، منعتُه النَّوم بالليل فشفّعني فيه".
- فيقول الصِّيام: "يا ربّ، منعته الأكل بالنَّهار فشفّعني فيه".
فيقول الصَّوم: "منعته الأكل بالنَّهار فشفّعني فيه". يقول القرآن: "منعته النوم بالّليل فشفّعني فيه"؛ حتى يُشفَّعان فيه، ولا يُبقيان مجالاً لأن يصيبه عذابٌ أبداً -القرآن والصِّيام-، تقبَّل الله منّا الصِّيام وثبَّت أقدامنا على محبَّة القرآن وتلاوته على النَّحو الذي يُرضيه عنَّا، والعمل بما فيه، وجعلنا من أهله -آمين-.
(الْحَمْدُ لِلَّهِ..)، نحمده على جميع نعمه؛ لكن خذ واحدة كبيرة منها، (أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ..)، (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ..(1))، وقولُه: (عَلَىٰ عَبْدِهِ) امتنانٌ خاصّ لأخصّ الخواصّ وسيّد جميع أهل الصّدق والإخلاص سيّدنا مُحمَّد، أضافهُ الحقّ إليه، وخلع عليه خِلعة العَبديَّة بهذا التَّكريم: (عَلَىٰ عَبْدِهِ).
(أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ..) قالوا: ونتأمّل أنّه في أشرف المواطن يصفه بالعَبديَّة؛ فهو خير عابد وأكرم عبدٍ لله على الله -سبحانه وتعالى-.
- يقول: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ) [الفرقان:1].
- (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ..(1)).
- (فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ) [النجم:10].
- و(سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) [الإسراء:1].
ففي أشرف مراتب العطاء والعلو يصِفُهُ بالعَبديَّة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولمّا أدرك المُدرِك أسرار هذا الفقر والشرف الأعلى صار يقول:
فَلَا تَدْعُنِي إِلَّا بِـ يَا عَبْدِهَا *** فَإِنَّهُ أَشْرَفُ أَسْمَائِي
- والناس يعيشون في الدنيا ومنهم من يُستعبد للهوى؛ فهو عبد الهوى.
- ومنهم من يُستعبد للجاه؛ فهو عبد الجاه.
- ومنهم من يُستعبد للمال؛ فهو عبد المال.
- ومنهم من يُستعبد للشهوات؛ فهو عبد الشهوات.
- "تَعِسَ عبدُ الدينارِ، تَعِسَ عبدُ الدرهمِ، تَعِسَ عبدُ القطيفةِ، تَعِسَ عبدُ الخَميصةِ، تَعِسَ وانتكَسَ، وإذا شيكَ فلا انتَقَشَ"؛
لكن المخلَّص من كل هذا فيصيرعبداً لله بكل المعاني: نظرُه لله، سمعُه لله، كلامُه لله، سكوتُه لله، عطاؤُه لله، مَنعُه لله، مَحبَّتُه لله، بُغضُه لله؛ هذا عبدٌ عجيب هذا! هذا عبد الله، وقد ذكر الله أحدَ عشر وصفاً، وصف بها المتحقِّقين بالعبادة له والعبوديّة له تعالى، قال: (وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا * وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا * وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ…) [الفرقان:63-68]، إلى آخر الأوصاف؛ وصف عباد الرحمن.
لكن كل هؤلاء الأكارم الأماجد في عبوديَّتهم لله تعالى، بجميع هذه الأوصاف وفيما آتاهم الله من عبودية له؛ تخلَّصوا بها من عبودية الهوى والشّهوات والدنيا والأرض والسماء والآخرة وكل شيء؛
فصاروا عباد له، خُلَّص، هم في كل هذا، في مقام دون الأنبياء؛ فالأنبياء في عبوديتهم فوقهم..
- عُبوديّة الأنبياء في أقوالهم.
- عُبوديّة الأنبياء في أفعالهم.
- عُبوديّة الأنبياء في مقاصدهم.
فوق هؤلاء، الله! والأنبياء كلّهم دون مُحمَّد، فالعبد المَحْض، الخالص، جامع الخصائص؛ مُحمَّد بن عبد الله بن عبد المُطَّلب.
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ..(1))، وإذا كان في هذا الإمتنان العظيم من الله على سيّدنا المُصطفى مُحمَّد؛ فَفاضَ علينا أيضا هذا الإمتنان مِنْ حيث أنَّ هذا الكتاب الذي وَرِثْناه وَوَصَل إلينا فَنِلناه، (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) [فاطر:32]، أورثنا الكتاب -القرآن- (الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) وهُم هذه الأُمَّة، اصطفاهم الله على الأُمَم فأورَثَهُم هذا الكتاب؛ هذا الكتاب الذي ورِثْنَاه، وصل إلينا من قِبَل وعلى يد العبد الخالص.
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ) فكيف وَصَل إلينا؟ فمهما كانت المِنّة في هذا الّلفظ على سيّدنا، فَلَنا شرفٌ أنَّنا من هذا السيّد تَلقَّينا هذا الكتاب.
- بل قال الله له: (لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ) [الإسراء:106].
- وقال: (لِّتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ) [الرعد:30].
- وقال -سبحانه وتعالى-: (يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ) [الجمعة:2].
- وقال: (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ) [البقرة:151]، يُطَهِّركم ويُنَقِّيكم من الشوائب التي تَعلق بكم بأصنافها؛ فيجعلكم عُبَّادًا لَنَا، خُلَّص، تستحقون أن تنالوا قُربنا ورضانا وجنَّتنا وعطاءَنا الواسع؛ الحمد لله.
- (وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ * فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) [البقرة:151-152].
(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ)، هذا المنُّ الكبير، والحمد لك على الكتاب هذا، قال: ما خصائص هذا الكتاب؟! ما أوصاف هذا الكتاب يا ربّ!
- (وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا(1))، (قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) [الزمر:28].
- (لَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا)، سالما من المُتناقضات، ومن الاختلافات، ومن الشُّبُهات، ومن الإشكالات، ليس فيه نقص، سليمٌ، تامٌّ، قويمٌ، ثابتٌ.
(وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا(1))؛ الله أكبر! (قَيِّمًا..(2))، فسّر بعض المفسرين:
- (قَيِّمًا): إنّهُ مستقيم؛ فيندرج هذا في المعنى السابق.
- حتى قال بعضهم: أنَّ فيها تقديم وتأخير، والأصل: (أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ (1) قَيِّمًا)، (وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا(1))
- ولم يرتضِ هذا الفخر الرازي، وأنكر هذا، وفسّر معنى القيّم كما فسّره أيضاً غيره، ليس بمعنى مجرد المستقيم، فإنَّ في قوله: (وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا) غِنًى عن ذلك؛ ولكن (قَيِّمًا) مع كونه في ذاته مستقيماً، بَيِّناً، عظيمًا، مُعجِزًا، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله؛
لا نَزَال نتحدَّى به أهل الشرق والغرب: يا أهل التَّفكير! يا أهل المبادئ! يا أهل النَّظريات! يا أهل الاكتشافات! ائتوا بسورة من مثل هذا الكتاب، ائتوا بمثل سورة واحدة، ائتوا! هاتوا! إنسُكم وجنُّكم، هاتوا! تحدٍّ قائم، من أيّام بُعِث إلى اليوم، إلى أن تقوم السَّاعة، (قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا) [الإسراء:88]، تجمَّعوا كلهم وتعاونوا كلهم وتكاتفوا؛ لا يمكن أن يأتوا بمثل سورة من كتاب الله -سبحانه وتعالى-، لا في بَهائها ولا في بلاغتها ولا في معانيها ولا في دلالاتها، لا يقدرون! ماهذا هذا التَّحدّي الكبير؟! -سبحان الله-؛ معجزة دائمة لنبيّنا عليه الصلاة والسلام، ومع كونه (وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا (1)) هو (قَيِّمًا (2))، يعني:
- يُقوِّم غيره، يُقوِّم مَن آمن به، مَن صَدَّقه، مَن تأمَّله، مَن تدبَّره، مَن عَمِل بما فيه، يُبعِّد العِوَج الذي في الغير أيضاً، ما فيه عوج ويُبعِّد عِوَجَك، يُبعِّد عِوَج المِعوَجّ، يَردُّه مستقيمًا، (إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) [الإسراء:9]، هذا معنى.
- كذلك المعنى الثاني: (قَيِّمًا) مُهيمنًا على بقيَّة الكتب، يقول هذا قَيِّم على الصَّبي، وهذا قَيِّم على آل فلان؛ قائم فوقهم وقائم عليهم. وكذلك قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ) [المائدة:48]، (قَيِّمًا).
يقول -الفخر الرازي- فهذا هو الترتيب الصحيح: (وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ (1) قَيِّمًا..(2)) ما فيها تقديم ولا تأخير ما بُمكن؛ لأنَّه أولًا للوصف في حدّ ذاته أنَّه كامل وتامّ، وهذا وصف ثاني زائد أنَّه بعد تمامه وكماله، صار يُتمِّم ويُكمِّل غيره، صار يُقوِّم غيره.
وهكذا إنَّما يبتدئ الإنسان باستقامته أولاً، وبصلاحه أولاً؛ حتّى يمكن أن يُصلِح ويمكن أن يُقوِّم، ولذا يقول قائلهم:
يَا مَعْشَرَ القُرَّاءِ يَا مِلْحَ البَلَدْ *** مَا يُصْلِحُ المِلْحُ إِذَا المِلْحُ فَسَد
إذا هو الملح فاسد؛ كيف يُصلح الطعام؟ نضعه فوق الطَّعام يُفسد علينا الطَّعام بدلا من أن يُصْلِحَه! وكذلك المفسِد؛ يقول المُفسدون والفاسقون في القيامة، لِمَن تَبِعَهم في الدُّنيا: (فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ) -لأنّنا تَبِعناكم، أنتم أغْوَيْتُمُونا؟ يقولوا- (قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ) -أصلاً نحن في أنفسنا ضَّالين، كيف نهديكم؟ لو كنّا مُهتدين لَهَديناكم؛ لكن أصلاً نحن فاسقين، ضالين! أنتم تمسَّكتم بنا، ادخلوا معنا النَّار، ما في كلام ثاني- (قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ) [إبراهيم:21]، لا يوجد إلّا النَّار، نار، نحن وإيّاكم، لماذا تتّبعوننا؟! في زمانكم أولياء، في زمانكم صالحين، في زمانكم.. ما اتَّبعتموهم! جئتم وراءنا، نحن وإيّاكم إلى النَّار، كان أمامكم أهل الجنَّة ويدعونكم، وأنتم تولَّيتم عنهم، وأعجبناكم هناك! مادام أعجبناكم هناك، هنا ادخلوا معنا إلى النَّارِ الْمُوقَدَة، (الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ) [الهمزة:7) -والعياذ بالله تبارك وتعالى-.
(قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ) [إبراهيم:21]؛ لكن أصلاً نحن غير مُهتدين، فكيف نهديكم؟ اليوم تريدوننا أن نتحمَّل عنكم شيئا من العذاب! لو اتّصلتم بأهل الوَجاهة عند صاحب المُلك، ممكن اليوم يُخاطبونه ويشفعون عنده، يُخفّف عنكم ويُخلّصُكم، ولكنكم جئتم عندنا، ونحن ليس لنا قَدَر عنده، ولم ينَظَر إلينا، واليوم تريدوننا أن نُنجّيكم؟! هنا يوم عقابه ويوم عذابه، اسكتوا ساكتين، مَن قال لكم أن تَتْبَعونا؟
وبعد ذلك يتجمَّعون هم وإيَّاهم يقولوا: اسمعوا، نحن وإيَّاكم أضَلَّنا الشَّيطان -إبليس بنفسه هذا- يقولون: صحيح. يقولون: قولوا لربّنا يأخذ حقَّنا منه؛ فيُؤتى بالشَّيطان، يُنصب له كرسيّ من نار، يقول: اقعُد، يقعد بين الجنّة والنَّار -على كرسي النَّار- ويُخاطب، عمل الخطبة عليهم فيهم، ويضحك.
- (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) -هل ترى سلاسل الآن مع الذين لم يصوموا رمضان، هل أحد قيّدهم بالسَّلاسل لِيَفطروا بالقُوَّة؟ أبداً- (إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي) -هؤلاء الذين لا يُصلّون، هل في أحد جاء لهم بسلسلة أو أدخّلهم الحَبْس بالقوَّة، وقال لهم لابُدَّ أن يتركوا الصَّلاة؟! لا أحد عمل لهم هكذا- (إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ) وعَقَقَة الوالدين كذلك، وأنواع أهل المعاصي كلّهم، حتى انظر! استَعْرِضْهم في الشَّرق والغرب، هل في أحد منهم بسلسلة ممسوك؟ أبداً- (وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم) -أنتم الذين جئتم ورائي، واليوم تتكلّمون؟ ورائي، ورائي، أنا وإيّاكم، تعالوا هنا إلى النَّار، قال- (فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم) -الآن أمام واقع- (مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ) -يعني: مُنْقِذكم ولا مُنَجِّيكم- (وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ) -ولا أحد منكم يُخَفّف عنّي شيئاً من الذي فيه، أنا وإيَّاكم معًا إلى الجحيم- (مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ) -قال الله- (إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [إبراهيم:22].
- في المقابل: (وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ) [إبراهيم:23].
فرق بين الفريقين! -الله! الله! الله!- كم يُذَكّرنا الله بهذا المصير العظيم والمستقبل الكبير! نِسيانُهُ هي الغفلة، نِسيانه هي السبب أن يتسلَّط علينا الفُسَّاق والأشرار والسَّقطة؛ ولكن إذا بَقِيَ في أذهاننا استحضار هذا المستقبل والمصير كنَّا على بصيرة، عَرفنا أن نختار لأنفُسِنا، وفرّقنا بين القَوْل والقَوْل، وبين الدَّعوة والدَّعوة، وبين البَيان والبَيان.
قال سبحانه وتعالى: (وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۜ (1) قَيِّمًا) -وذَكَرَ خُلاصةً في هذا الوحي وهذا الكتاب المُنزَّل- (لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ..(2)). قال: مُهمّة هذا الكتاب العظيم، غير ذي عوج، المُقيم بغير ذي القَيِّم، مُهِمّته يُحذِّر الناس من أخطر ما يُمكن أن يَصِلوا إليه على الإطلاق؛ (لِّيُنذِرَ بَأْسًا) عذاباً، شدةً، وأمراً فظيعاً عظيماً، (بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ) من عنده سبحانه وتعالى، وأنت تعلم أنَّ كلًّا يُعذِّب على قدر قُدرتِه وعظمتِه؛. فلو تَهَدَّدَك بالَّتعذيب صَبيّ صَغير، لن يقع له تأثير ولا تُبالي به، لأنَّك تعرف قُدراته، وإذا جاء ليُعذّبك سَتَلْوِي رقبته وتُمسك يده وتَرميه هناك؛ لأنَّه صغير، لكن إذا واحد قويّ، جَلْد، ضخم، كبير، بدأ يُهدّدك، تفزع ليس مثل الصّبيّ؛ فإذا كان صاحب السُّلطة والقُدرة يكون خوفك أكثر.
فإذًا هذا جبَّار الجَبَابِرة، ملك السَّماوات وخالق كل شيء من عنده يعذبك، يا الله! يا الله! مَن يُطيق عذاب الله؟! قال: (فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ) -لا أحد يَقدر يُعذِّب مثله، كما إنه لا أحد يَقدر يُنَعِّم مِثلهُ، لا أحد يَقْدر يُعذِّب مِثله- (وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ) [الفجر:25-26].
يقول: (لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا (2))، لِيُخلِّصكم من البأس، من العذاب، من الشِّدة، من العقاب، من الورطات الخطيرة، من أشد ما يُقاسي الإنسان، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) [الصف:10].
(لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ) -من عندِهِ- (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2))، (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ) -اللّهمّ اجعلنا منهم-.
ودائماً إذا ذَكر ربُّنا في كتابه الإيمان؛ ذَكر العمل الصالح، ويَربُط المؤمنين بالعمل الصالح؛ فَإذا اجتمعا فالبشائر كثيرة، وفيرة، كبيرة؛ لِمَن تَحقَّق بالإيمان والعمل الصالح -إيمان وعمل صالح-:
- (وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) [البقرة:25]. -في سورة البقرة- كل ساعة تُحصّل "الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ"؛ الجنة لهم، والفوز لهم، والقربة لهم، والفضل لهم، والمكانة لهم، الله! الله! الله!.
- (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107)) -الله الله الله-.
- (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) [البينة:7].
فإنْ كان فيك عقل؛ لا تُقدِّم شيء في حياتك على أنْ تُقَوّي الإيمان، وتُحسِن العمل الصالح؛ هذا نجاحك وفلاحك واتْرُك الكلام الطَّويل العريض وفلسفات النّاس، قوِّ الإيمان، ثبِّت العمل الصّالح؛ وأنت النّاجح، أنت الفالح، أنت الفائز، أنت الظّافر، أنت المُنعَّم، أنت الحائز خير الحياتين وسعادة الدَّارين، قوِّ الإيمان، ثَبِّت العمل الصالح.
(وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2))؛ أجر حسن، ثواب حسن، الله يُسمِّيه ثواب حسن، مثل ماذا هذا؟ الله! الله! الله! مهما وُصف لك فهو أكبر؛ لأنَّ هذا وصف رباني، (أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا) أجر حسن، هم يعيشون بين النَّاس في الدنيا؛ لكن أهل قُوّة الإيمان وحُسن العمل الصالح لهم أذواق، ومُنازلات، وراحات، وطمأنينات، لا أحد يقدر أن يصفها أو يستوعب حقيقتها بتعبير؛ هم يعيشونها في الدنيا، والعجب أنَّها مُستمرّة معهم ودائمة، عجيب! وإنْ طرأ ما طرأ من ظروف الحياة ومشاكلها، هذه معهم.
-سيّدنا بلال- أيام كان تحت التَّعذيب والشِّدة في مكة، يَسأله بعضهم بعد ذلك، يقول: يا بلال! أيَّام كنت تحت السِّياط، والحِجارة المحمّاة، وبطحاء مكة، في الرّمضاء الحارة، تُسحب وتُقلّب وتُضرب، ما كنت تشعر بالألم؟ كنت تترنم: أحد أحد، أحد أحد، تتغني، أما كنت تشعر بالألم؟ قال: كل ذاك الألم خَلَطْتُه بحلاوة الإيمان؛ فزادت حلاوة الإيمان على شدة الألم، الله! الله! الله! هذا الخير معهم في كل أحوالهم، حتى وقت الشِّدّة! هذه الحلاوة عندهم ومستمرة -هو بنفسه- عند الموت، زوجته تقول: وا كرباه! فتح عينيه وهو في السَّكرات، قال لها: لا، بل واطرباه! -ما في كرب- غداً ألقى الأحبَّة مُحمَّداً وحِزبه، قال: أنا آتي عند حبيبي الطيب، في المراتب العُلا، لماذا الكرب؟ ما فيه كرب. بل وا طرباه! ما هذا؟! (أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا).
(وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا..(3)) نِعَم، تَتَّصل بنعيم الجنَّة، معرفة تدوم معهم، لها لذَّة وحلاوة، معرفة بالله وبصفاته وأسمائه تدوم معهم؛ بل تزداد إلى الموت، وبعد الموت يَتَنَعَّمون بها، في القيامة يَتَنَعَّمون بها، وفي الجنة يَتَنَعَّمون بها.
(أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا.. (3)) هل هناك أحد سيعطيك هكذا غير الله تعالى؟ اذهب صدِّق أصحاب التَّجارب والمشاريع المختلفة وادخل معهم؛ ما في حقيقة أجر حسن تمكث فيه أبداً! ما هذا؟
- وإنْ أعطوك قصراً، فيه كم من قُصُور؟ لو أعطوك،
- ولا يقدرون أن يُذهبوا عنك الهمّ ولا الغمّ ولا النَّكد،
- وما يجري لك من همّ وغمّ وأنت بين أيديهم في مسارهم، أو من كُرَب وشدائد؛ ما تتعرّض فيها للثَّواب؛ لأنَّك مُنعوج مُنحرف، وتكون في العذاب المُعَجَّل قبل العذاب الأكبر -والعياذ بالله -تبارك وتعالى-.
إذا لم ترجع إلى رُشدك وهُداك وتعلم مَن هو ربك، وليس في أيديهم أن يُعطوك أجراً حسناً تمكث فيه أبداً؛ بل كم أخلفوا وُعُودَهم وانْقلبوا في الدنيا! تريد مصانع أو تريد وزارات أو تريد هيئات أو تريد مؤسسات أو تريد دول؟ أغْرَوْا بعض الناس، وقالوا لهم كذا؛ واشتروا دينهم واشتروا أمانتهم وجعلوهم يمشون مع ما يريدون، وبعد ذلك قالوا لهم: مع السلامة..
حتى الذي وَعَدُوهم بهِ في الدنيا، لم يعطوهم إياه؛ بل ربَّما انقلبوا عليهم، وهم عذَّبوهم بأنفسهم، الله! فهذا وَقعَ في كمّ من شركات؟ في كم من مؤسسات؟ في كم من وزارات؟ في كم من دول؟ لكن خُذ وعد مَن لا يُخلف الميعاد
وإن ما رُضُوا عليك وحاولوا الوفاء معك، قالوا: إيه! هذا هو صاحبك الذي تعتمد عليه، مات أو أنت متّ، وكمّل كل شيء، ما الذي باقي؟ يُحاسبونك، ما تدري هذا الذي كنت فيه يُؤدّي إلى نعيم أو إلى عذاب! لكن آمن به واعبده، وخُذْ أجراً حسناً تَمْكُث فيه أبداً (مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3)).
وأعاد الذِكر: قَدَّم الإنذار ثُمَّ التَّبشير، يقول سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ..) [يس:11]:
- لأنَّ التَّخلية قبل التَّحلية،
- ولأنَّ المهم الأوَّل النَّجاة من العذاب ثُمَّ النّعيم بعد ذلك؛ لكن مَن لم ينجُ من العذاب ليس له نعيم، أين يصير إلى النَّعيم؟ فما له معنى أن يُوعَد بالنَّعيم وهو مُعرَّض للعذاب! ولكن عند النَّجاة هو الأمر المهم، النَّجاة أولاً ثُمَّ الفائدة، رأس المال أولاً ثم الرِّبح، وأمّا إذا فات رأس المال، كيف يجيء الربح؟ هو نفس رأس المال قصر؛ ولهذا قدَّم الإنذار ثم التبشير.
(وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ) -اللهم اجعلنا منهم- (أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا) حسن، طيب، عجيب؛ طمأنينة، قُربة، محبة، خشية، إنابة، إخبات، ذِكر، وذِكر في العالم الأعلى؛ جبريل يَذكُره، ميكائيل يذكره، حملة العرش يذكرونه، ما هذا الأجر الحسن! وبعد ذلك لمَّا يُذكر هناك، بالمجد والكرامة إلى الأبد…
نحن رأينا وسائل الإعلام في الدُّنيا، تذكر واحد هنا، تُبالغ في مدحه، في الأسبوع الثاني تَذُمُّه، تُبالغ في ذمّه، يا الله! سمعنا أيام كان بعض الحكم الشمولي في البلد، كانوا يُرسلون -نفس الحكومة بالقوّة- إلى خطيب الجمعة، كان ذلك الأيام الخطبة عندنا واحدة في تريم، خطبة واحدة، يرسلون إليه خطبة وفي أثنائها دعاء لرئيس لهم وتمجيد له، حضرناها.. وحضرنا مرة في الجمعة هذه، ثم تخالفوا بينهم وبدأوا يتقاتلون، وجاءوا له بالقوة في الجمعة الثانية خطبة يَسُبُّونه!! هذه حكومات الدّنيا، هذه إذاعات الدّنيا، هذا فناء أهل الدّنيا..
لكن إذا ربَّك ذكر واحداً بالذكر الجميل: "يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه"، يُحبُّه جبريل، يُنادي في أهل السماوات: "إن الله أحبّ فلان بن فلان فأحبوه". هذه الإذاعة العجيبة؛ إذا قالت إحبّوه فإلى الأبد، ويعيش محبوب ويموت محبوب ويُحشر في القيامة محبوب وإلى الجنة مع المحبوبين؛ هذه الكرامة، هذا الشرف، تُضَيِّعها من شأن واحد يذكرك في الإنترنت أو في مجلة أو في قناة؟! يا مجنون! اطلُب الذِّكر الدائم، الباقي، الجميل، الحسن. (وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3)).
بعد ذلك عوَّد الإنذار على صنفٍ من هؤلاء الأشرار والكفار: (وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4))، -وقد أنذر جميع الكفّار وجميع المشركين؛ لكن هؤلاء على الخصوص ردّ الإنذار عليهم.. وإشارة إلى أنَّ هؤلاء أكبر أهل الإجرام في التجرؤ على الملك العلّام- (وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ)، ولا يمكن أن يَتَّفق هذا مع العلم أصلاً، هذا جهل خالص:
- (مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمُ..(5))؛ الذين قَلَّدوهم واتَّبعوهم في أنَّ لله ولد، ما لهم علم! (ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ) [الأحقاف:4].
- (مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ)؛ بل دعوى تتناقض مع العقل، أإله يلد أو يُولد؟ كيف هذا؟! خالق أو مخلوق هذا؟! هذا وصف مخلوق، وصف واحد مصنوع، ووصف شيء متجانس مع الحادثات والكائنات، هذا غير معقول أصلاً!! ولهذا حتى هم يُرَدِّدون بأفواههم؛ أمَّا العقول لا يُمكن أن يستقرّ فيها هذا..
يقول: (وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ) -ما قال من قلوبهم، المنطق مُتناقض معها! ما يمكن هذا- (تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5))، والله أمرنا نكون مع الصّادقين لا مع أهل الكذب.
- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [التوبة:119].
- (وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ..(5)).
- (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ) [الإخلاص:3-4] هذا هو العلم.
(كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ) -عظُمت، عظُمت في فظاعتها وشناعتها، وقوة جراءتهم على الخلَّاق، المُقدَّس، الأقدس، العليّ، العظيم، الحكيم، الرَّحمن، الرَّحيم سبحانه وتعالى- (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5))؛
فهذه خمس آيات من هذه السورة، نسأل الله ينفعنا بها وبما فيها، وما تكلَّمنا فيه هو مفتاح لمعناها، ومعناها: إذا أخذتم هذا بقوة وطهَّرتم قلوبكم، وواظبتم على الوقوف على باب مُنزل هذه الآيات مِن طريق مَن أُنزلها عليك؛ فستعرفون المعنى بعد ذلك؛ أمَّا هذا الذي نذكره ويذكره المُفسّرون هو مفتاح للمعنى، سبب موصل إلى المعنى.
- أمَّا المعنى فهناك، إذا قُمتم بحقِّ هذا، وطهَّرتم بواطنكم وسرائركم، وعكفتم على باب مَن أنزلها من طريقٍ وتبعيَّة وائتِمامٍ بمَن أُنزِلَت عليه؛ هناك يأتيكم معناها.
وإذا ذاقَ الذائق منكم معناها *** طاب حالُه في مَغناها
وهناك العيشُ وبهجته *** فلِمُبْتَهِجِ ولمُنْتهِجِ
اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشرّ ما عندنا، اللّهمّ ببركة القرآن والذي أنزلت عليه القرآن ورمضان الذي أنزلت فيه القرآن، افتح لنا باباً في فهم القرآن العظيم وتدبّره والوقوف على معانيه والاطلاع على سرِّه، وألّف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسُّورة ائتلافاً لا يُفارقنا طرفة عين، يظهر سِرَّه في القلوب والعقول والأرواح، يا مُجيب الدَّاعي، يا مُغيث المُستغيث، اجعله إمامنا واجعله هادينا، واجعلنا ممّن تهديهم بالقرآن وتُنوّرهم بالقرآن، وتُطهّرهم بالقرآن، وتُزكّيهم بالقرآن، وتحشرهم مع القرآن، وتجعلهم عندك من أهل القرآن، يا كريم يامنان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسرِّ الفاتحة
إلى حضرة النبي الأمين
03 رَمضان 1434