شرح الموطأ - 210 - كتاب الحج: باب هَدْي من فاته الحج، وباب من أصاب أهله قبل أن يفيض
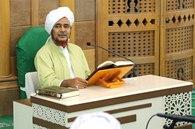
شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب هَدْي من فاته الحج، وباب من أصاب أهله قبل أن فيض.
فجر الثلاثاء 19 ذي القعدة 1442هـ.
باب هَدْي مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ
1135- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي.
1136- وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ، كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ. فَقَالَ: عُمَرُ اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَانْحَرُوا هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
1137- قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً، وَيَقْرِنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ، هَدْياً لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْياً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ.
باب مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
1138- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً.
1139- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْر بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي.
1140- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
1141- وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَرَجَعَ إِلَى بِلاَدِه؟ فَقَال: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لِيَعْتَمِرْ وَلْيُهْدِ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ وَيَنْحَرَهُ بِهَا، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ، ثُمَّ لِيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا.
نص الدرس مكتوب:
الحمد لله مُكْرِمِنا بدينه وشريعته وبيانها على لسان حبيبه وصفوته، سيِّدنا مُحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم وبارك وكرَّم عليه وعلى آله وصحبه وأهل مودته ومُتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين المُترقين في الفضل إلى أعلى ذِروته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المُقربين وجميع عباد الله الصَّالحين من كل مَن أكرمه الرَّحمن بصفاء طويته، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الرَّاحمين بفضله ومِنّته.
وبعدُ،
فيذكر لنا الإمام مالك -عليه رضوان الله تعالى- الحكم لمَن فاته الحج.
-
ومعنى فاته الحج: فاته الوقوف بعرفة.
فإنه الرُّكن الذي إذا فات فقد فات الحج، ومن هنا جاءنا الحديث "الحجّ عرفة" فهو أهم أركان الحج وأعظمها، والذي لا يمكن أن يقوم غير مقامه، والذي يفوته فإن له وقتًا مخصوصًا وساعاتٍ مُعيّنة من قِبل الحق -جلّ جلاله وتعالى في عُلاه-، وهذا يدلنا على اعتبار الأعمال بحسب موافقتها لمراد الحق جلّ جلاله وتعالى في عُلاه. وإلا فعرفة هي عرفة من حيث حجرها وجبالها وترابها هي هي، في اليوم التّاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثّاني عشر وما قبل وما بعد، ولكن لا يكون الوقوف بها حجًّا ولا ركنًا من أركان الحج، ولا عبادةً خالصةً مُتعلقة بهذه الشَّعيرة والفريضة إلا في هذا الوقت المحدد؛ الذي هو من بعد زوال الشَّمس في يوم التّاسع إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر.
إذًا؛ فإنما يكون الاعتبار للأعمال بحسب ما وافقت من مُراد الحق -جلّ جلاله ورضاه- وما رتّب ودبّر، فلا طريق لأحد أن يتعبّد بعقله المجرّد، ولا أن يُحكِّم رأيه فيما عيّن الحق تعالى وحدّد -سبحانه وتعالى-. وبذلك يُعرَف معنى العبودية، والتحقُق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمَّد رسول الله، يعطينا عن مسألة هذا الوقوف بعرفة، وإلا فعرفة هي بنفسها موجودة يمكن أن تقف بها، ولكن لا يكون الوقوف بها ركنًا من أركان الحج ولا عبادة لها تعلُّق بهذه الشَّريعة إلا في هذا الوقت مُعيّنًا.
وكما قال لنا تعالى في أداء الصَّلوات الخمسة: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) [النساء:103]؛ محددًا بوقته، ولا مجال لأحد أن يقول: أنا أقدّم بلا عُذر، أو أُؤخر بلا عُذر، وأجمع الصَّلوات كلها في وقت واحدة، واجعل وقت الصُّبح قبل أن أنام لأنني بعد ذلك ما أستطيع أقوم ولا مجال لشيء من هذا.
-
ومن هنا قال أهل السُّنّة: إنما وجبت العبادة وتبيّنت وتفصّلت بالوحي والشَّرع لا بالعقل، وإنما وظيفة العقل أن يدلُك أنك عبد لك إله. فإذا دلّك على ذلك؛ فسلِّم للإله واخضع للمولى -تعالى في عُلاه-، وانقَد لما أنزله وأوحاه.
فهكذا من فاته الحج؛ أي: الوقوف بعرفة. فأجمع على ذلك أهل العلم أن مَن لم يقف بعرفة في هذا الوقت المُحدّد؛ فقد فاته الحج. إلا ما يُذكَر عن بعض تابع التَّابعين أنه إن أدرك الوقوف مع الإمام بمُزدلفة؛ فقد أدرك الحج. ولم يقل بهذا أحد من الأئمة الأربعة ولا عامة أهل العلم، بل الأمر كما أشار إليه الحديث الشَّريف "الحجّ عرفة"، فلا بُدّ من الوصول إلى عرفة قبل أن يطلع الفجر في يوم النحر. إذًا، آخر وقت الوقوف؛ آخر ليلة النحر؛ فينتهي بطلوع الفجر. مَن لم يُدرك ذلك؛ فاته الحج.
وهكذا قال سيِّدنا جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع. ليلة جمع: ليلة مُزدلفة. فجمع اسم من أسماء مُزدلفة.
وذكّرت جمعًا خلا في جمع ** وحال قُرب من عُريب الجزع
وهكذا قال أبو الزُّبير: قلت لجابر: قال رسول الله ﷺ ذلك؟ قال: نعم؛ أي: هذا الذي عرفته عن رسول الله ﷺ في حكم مَن فاته الحج بعرفة.
-
"الحجّ عرفة، فمَن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمعٍ فقد تم حجّه".
-
"مَن وقف بعرفات بليلٍ فقد أدرك الحج، ومَن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليُحل بعُمرة وعليه الحج من قابل"، جاء في رواية الدَّار قُطني.
إذًا فهذا هو الحُكم المترتب على مَن فاته الوقوف بعرفة. ويأتي الحُكم في مَن فاته ذلك ما أشار إليه من أنه:
-
يتحلّل من أعمال الحج بعمل العُمرة وهو الطَّواف والسَّعي والحلق أو التقصير
-
ثم يكون عليه القضاء، فيقضي من العام القابل مهما أمكنه ذلك.
فمَن فاته الحج يتحلل بطواف وسعي وحلقٍ أو تقصير، وهكذا قال الإمام مالك والإمام الشَّافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم. وجاء في رواية عند الإمام مالك، وهو قول المُزني: أن يلزمه يفعل جميع أفعال الحج لأن ما فاته سقط، وما لم يفته فعليه أن يأتي ببقية الأعمال ولكن لا يُحسب حجًا، وعليه أن يحج من العام القابل.
-
وهكذا ويلزمه فيه القضاء، وكذلك يلزمه الهدي عند الأئمة الثلاثة.
-
وقال أبو حنيفة: لا هدي عليه، فإنما الهدي على مَن قصَّر في الحج؛ أما هذا فعليه قضاء الحج، فيقضي الحج كله في العام القابل فما عليه شيء.
-
وهكذا يقول الإمام النَّووي: من فاته الوقوف لزمه دمٌ كدم التَّمتع في جميع أحكامه، ويلزمه أن يتحلل بعمل عُمرة. ما هو عمل عُمرة؟ الطواف والسَّعي والحلق، ولا يحسب ذلك عُمرة، وعليه قضاء الحج، سواءً كان إحرامه بحج واجب أو تطوّع، ويجب القضاء على الفور وسواء كان الفوات بعذر أو بغير عذر لكن:
○ الفوات بعذر؛ يرفع الإثم عن صاحب لا إثم عليه.
○ وأما الذي كان بتساهل منه وتقصير؛ فعليه الإثم مع وجوب أن يتحلل بالعمرة ويفديه ويقضي في العام القابل.
يقول -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-: "أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا"؛ أي: يريد الحج "حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ"، والنَّازية فالنَّازية؛ عين قريب الصَّفراء إلى المدينة أقرب. "حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَإِنَّهُ قَدِمَ" مكَّة فتأخّر لذلك، "وَإِنَّهُ قَدِمَ" مكة "عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ" في اليوم العاشر؛ فاته الوقوف بعرفه، اشتغل بطلب الرواحل حتى أدركها وأخذ يمشي ففاته الوقوف بعرفة. "فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ"؛ لسيِّدنا عُمَر، "فَقَالَ عُمَرُ بن الخطاب: اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ"؛ يعني: طف واسعَ واحلق. "اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ"؛ يعني: تأتي بأعمال العُمرة فتتحلل بذلك "ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلاً فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي"؛ فعليه أن يذبح شاةً، وإن لم يقدر فيصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهكذا تم الإجماع على أن الوقوف بعرفة ركنٌ من أركان الحج ومَن فاته فعليه حجٌّ من قابل، والعُمرة لا يمكن أن تفوت إلا الشأن لمَن اُحصر؛ حكم المُحصَر من تحلّله لعدم قدرته. فصار للحج وقت محدد من العام لا يؤدّى في غيره، قال تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ) [البقرة:197].
فإذا قال: طالما فاتني الحج هذا العام، سأبقى في مكاني مُحرِم إلى أن يجيء العام القابل فأكمل الحجّ هذا!
-
قال الأئمة الثلاثة: لا، بل يلزمك أن تتحلل بعمل عُمرة، وأن تعقد نية للعام القابل في الأشهر القادمة للحج؛ من شهر شوال فما بعده.
-
وقال الإمام مالك -رضي الله عنه-: إذا بقيت هكذا في محلك؛ عليك مُحرَّمات الحرام كلها سنة كاملة، فتطول شعورك وأظافرك.. وتحج في العام القابل بدل هذا العام.
-
قال الأئمة الثلاثة: لا، لا يصح أن تبقى بهذا الحرام إلى العام المقبل فإنه يحتاج إلى إحرام جديد (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ).
-
ويروى عن الإمام أحمد رواية كالمالكية: أن من فاته الحج وأراد أن يبقى بإحرامه فهو مخير، وإلا فليتحلل بعمل العُمرة ويحج من عام قابل.
-
وقال المالكية:
-
إذا قد دخل مكة أو قاربها فالأفضل له التحلل، وكرهوا له بقاء إحرامه.
-
وإن كان بعيدًا عنها يُخيّر بين البقاء محرمًا وبينه أن يحلّ.
-
وجعلوه مخيرًا على حدٍّ سواء إلا إذا دخل مكَّة أو قاربها، فالتحلل أفضل له.
يقول: "وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ"، كما جاء في رواية إمام البُّخاري في التاريخ عن هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ يقول: أنه فاته الحج، فقال له سيِّدنا عُمَر نفس الحكم: طف بالبيت وبين الصَّفا المروة. "جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ، كُنَّا نُرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ" وأنتم قد كمّلتم عرفة وأنتم الآن في مِنى "اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَانْحَرُوا هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا" هذه أعمال العُمرة "وَارْجِعُوا، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ"، وذلك هو الذي عليه جمهور أهل العلم.
"قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلاً، وَيَقْرِنُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ"، هديًا لقِرانه الحج مع العُمرة، وهديًا لما فاته من الحج. كذلك وإن كان قارنًا ولكن الآن يكمل أعمال العُمرة وعمرته صحّت، عُمرته صحّت، وبقي الحج. وقال أبو حنيفة: بل عليه أن يطوف مرّتين، وأن يسعى مرتين، مع أنه فاته الوقوف.. وبعد ذلك يقضي في العام. وقال غيره: بل إنما يطوف طوافًا سواءً كان قارنًا أو غير قارن، يطوف طوافًا واحدًا ويسعى سعيًا واحدًا ثم يحجّ من قابل. وقال: "وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ، هَدْياً لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْياً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ".
باب مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
قال: "باب مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ"؛ أي: قبل أن يطوف طواف الإفاضة. وذكر: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً". وهكذا هذا مذهب الإمام مالك، كمثله مذهب الإمام أبي حنيفة في وجوب نحر البدنة، وهو بين التحلّلين عند الشَّافعية والحنابلة إنما يلزمه شاة، يلزمه شاة ما يلزمه بدنة فيه. فالدم الذي بين التحلُلين -بين التحلل الأول والثاني- إذا قد فعل اثنين من بين الرمي والحلق أو الطَّواف؛ يعني رمى وحلق ولم يذهب بعد إلى مكَّة، فجامع أهله؛ فعليه شاة. إذا كان بين التحللين وهو دم تخيير وتقدير عندهم. إن شاء ذبح شاة، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام. وذلك واجب على من وطئ مرة أُخرى أو كان ما بين التحلُلين كما هو في شأن الحلق والقَلْمِ، وما تعلق بذلك من دُهنٍ؛ يلزمه أن يذبح شاةً أو يصوم ثلاثة أيام أو يُطعم ستة مساكين، كل مسكين مُدّين.
قال: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً." هذا مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك.
و"عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله تعالى عنهما- قَالَ: لاَ أَظُنُّهُ إِلاَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي". "وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ".
"وَسُئِلَ مَالِكٌ -عليه رحمة الله- عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَرَجَعَ إِلَى بِلاَدِه؟" ما طاف الإفاضة بعد، "فَقَالَ: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ، وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لِيَعْتَمِرْ وَلْيُهْدِ"، هذا واجب عليه عند مالك أن يعتمر ويخرج الهدي، "وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ" أي: من الحرم، "وَيَنْحَرَهُ بِهَا، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ" من خارج وما أدرك الهدي إلا وسط حدود الحرم "مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ، ثُمَّ لِيُخْرِجْهُ" خارج الحرم "إِلَى الْحِلِّ" ثم "فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا". هذا مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى.
رزقنا الفقه في الدِّين والاتباع للنبي الأمين، وأقام الله شعائر الحق والهُدى والدِّين القويم في كل عام، وعمَر الله بيته الحرام والمشاعر العِظام بكثرة الوفود والعطاء بغير حدود، وكشف الله الضُّر عنّا وعن المسلمين وجميع البلايا والآفات، وأصلح الظواهر والخفيات وبلَّغنا فوق الأمنيات من واسع الخيرات في الحياة وعند الممات وبعد الممات بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.
24 ذو القِعدة 1442

