شرح الموطأ - 207 - كتاب الحج: باب العمل في الهَدْي حين يُساق
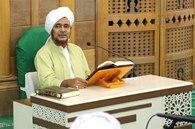
شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب العمل في الهَدْي حين يُساق.
فجر السبت 16 ذي القعدة 1442هـ
باب الْعَمَلِ فِي الْهَدْي حِينَ يُسَاقُ
1114 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْياً مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ، وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ، يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ، حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ، ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا، فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصُفُّهُنَّ قِيَاماً، وَيُوَجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ.
1115 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ، وَهُوَ يُشْعِرُهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
1116 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.
1117 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ الْقُبَاطِيَّ وَالأَنْمَاطَ وَالْحُلَلَ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا.
1118 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلاَلِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ؟ فَقَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
1119 - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ، الثَّنِىُّ فَمَا فَوْقَهُ.
1120 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ، وَلاَ يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ.
1121 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِىَّ لاَ يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ للهِ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئاً، يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ، وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ.
نص الدرس مكتوب:
الحمد لله مُكرمِنا بالشريعة العظيمة، وبيانِها على لسان عبده المصطفى مُحمدٍ ذي المراتب الفخيمة، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم فيك واتبعهم في الطريقة القويمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهلِ المنازل الشريفة والمراتب العظيمة، وعلى آلهم وصحبهم ومن تابعهم، وعلى ملائكتك المُقربين وعبادك الصَّالحين أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعدُ،
يواصل سيدُنا الإمَام مَالِكْ عليه -رحمة الله تعالى- في الموطأ الأبوابَ المتعلقة بالحجِّ والهَدْي، فيقول: "باب الْعَمَلِ فِي الْهَدْي حِينَ يُسَاقُ"، ويُمشى به من الحِلّ إلى الحرم.
وهو كذلك عند المَالِكْية لا يُسمى هَدْيًا إلا إن ساقه من الحِل إلى الحرم.
-
فالأَولى فيه ما ساقه مِنْ بلده.
-
ثمّ ما اشتراه في الطريق.
-
ثُمَّ ما اشتراه مِنْ مكة وخرج به إلى عرفة في الحِل.
-
ثُمَّ ما اشتراه مِنْ عرفة.
فإن اشتراه مِنْ مِنَى أو مِنْ مكة ولم يخرجه إلى الحِل:
-
فليس بِهَدْيٍ عند المَالِكْية.
-
وقال الشَّافعية: يحصل أصل الهَدْي ولكن كماله أن يسوق شيئًا من الحِل إلى الحرم، وأفضله ما كان مِنْ بلده، كما فعل رسول الله صلَّى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم.
فسَوقُ الهَدْي مِنْ شعائر الله، كما أشارت الآية: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ) [الحج:36].
-
وهكذا يقول الحَنَابِلَة: إن سَوق الهَدْي من الحِل إلى الحرم مسنونٌ كما قال الشَّافعية.
ويأتي فيه أيضًا التقليد قال: أنَّ "عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْياً مِنَ الْمَدِينَةِ"؛ أي: خرج به من مسكنه "قلّدَه"؛ يعني: الهَدْي، بوضع نعلين في رقبته، وتقليدها سُنَّةٌ عند جميع الفقهاء، وهو تعليق نعلٍ أو نعلين أو جلد ليكون علامة للهَدْي، تُعلق عليها في رقبتها فتُعلم أنّها هَدْيٌ، وبأيّ شيءٍ حصل به العلامة قلّدها به صَحَّ،
-
والأَولى أن تُقلّد بنعلين
-
ويَصِحُ بنعلٍ واحدة وبكل ما كان علامةً على أنّها هَدْي.
فكان إذا خرج بالهَدْيِّ من المدينة "قَلَّدَهُ"؛ أي: جعل عليه القلادة، فيُسنُّ وضع القلادة للإبل والبقر. قال الشَّافعية: والغنم يُجعل علامة غير النِعال، ما هو خفيفٌ يَسُهل عليها، فتكون أيضًا علامة أنها هَدْي.
قال: "قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ" وتقدم معنى الإشعار، أن يكشِط الجلد مِنْ جهة يسار السّنام، ثُمَّ يمسح بالَّدم فيبقى علامة على أنّه هَدْي.
"قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ"؛ الإشعار أصله مأخوذ من الإعلام، والعلم بالشيء، وفي هذا الإشعار تنبيه للفَطِن على أنَّ هذا من الهَدْي. وسُمي الشّاعر شاعرًا أيضًا لفِطنته ودقة معرفته. وهو أن يضرب صفحة سنام الهَدْي بحديدة حتى يتلطخ بالدم ظاهرًا،
-
فقالوا أنّ هذا الإشعار سُنَّة.
-
وكان يقول أبو يوسف ومحمد من الحنفية: إنّه حَسَن.
-
ويُذكر عن الإمام أبي حَنِيفَة أنّه كرهه، ولكن قال عنه بعض أصحابه: إنما كره ما أحدثه النَّاس في وقته من تجاوز الجلد والمبالغة في الإشعار بما يؤذي أو يُعرّض الأنعام للتعب أو الهلاك، فهو الذي أنكره أبو حَنِيفَة؛ لأنه لا يمكن أن يُنكر شيئًا ثبت عن رسول الله ﷺ وفعله بيده صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه وعلى آله.
ومن هنا قال أبو يوسف ومِحمد بِن الحسن من الحَنَفِية: أنه حَسَن. وهكذا حُكم الإشعار، التقليد والإشعار، قال: "يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ" تقليد الهَدْي جعلُ القِلادة والعلامة عليه، ثُمَّ إشعاره، إنما يكون الإشعار في السّنام للإبل والبقر؛ وليس في الغنم إشعار.
وذكر الإمام النَّووي في (المناسك): هل الأفضل أن تقدم الإشعار على التقليد؟ قال: فيه وجهان:
-
أحدهما: يقدم الإشعار؛ لِما جاء في صحيح مُسلم.
-
والثّاني: نص الشَّافعي تقديم التقليد كما أشار هنا، يقلد أولاً ثُمَّ يُشعر.
كما صحّ عن ابْنِ عُمَرَ فيما رواه لنا الإمام مَالِكْ عليه رضوان الله تعالى، "وَذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ" فإن السُّنّة إنما يكون الإشعار والتقليد لِمن يريد الإحرام عند إحرامه.
وقال: "وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ"، وتلك السُنَّة في كل عمل يُتقرّب به إلى الله تعالى إذا تيسّر فيه استقبال القبلة، وذلك أفضل. "وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ، يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ" وهذا أفضله، ويُجزئ النّعل الواحدة وأيُّ شيءٍ جُعِل علامة. "وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الأَيْسَرِ" واختلفوا هل الأفضل مِنَ الشق الأيسر أم مِنَ الشق الأيمن؟
-
فقيل: أنهما سواء.
-
وقيل: يُقَدم الأيسر.
-
وقيل: يُقَدم الأيمن.
-
وقيل: لا إشعار مِنَ الأيمن أصلًا وإنما يكون مِنَ الشق الأيسر.
فهذا ملخص أقوال الفقهاء.
وجمع بعضهم بين الروايات قال: الإشعار مِنَ الجانب الأيسر إلا أن تكون صِعابًا مُقرَّنةً لا يستطيع أن يدخل بينها، فيُشعرها مِنَ الجانب الأيسر أو الأيمن، فما تيَسّر له أن يُشعره منَ الجانب الأيسر فعل وإلّا فمن الأيمن، حتى جاء في عارضة الأحوذي أنه رُوي عن رسول الله ﷺ كان يدخل مِنْ بين البعيرين مِنْ جهة رأسها، فيصيب من أحدهما الجانب الأيمن ومِنَ الآخر الأيسر.
-
وهكذا، يقول الإمام مَالِكْ: محل الإشعار هو الأيسر، لأنه إذا أشعرهُ ووجهُه إلى القِبلة وهو يُمسك الخِطام بشماله فيكون الذي أمامه ليُشعره الجانب الأيسر.
-
وجاء في بعض كتب الحَنَفِية: أنه يُشعر واحدًا مِنَ الأيمن و واحدًا مِنَ الأيسر.
قال: "ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ" ذلك الهَدْي الذي أهداه "حَتَّى يُوقَفَ بِهِ " بالهَدْي "مَعَ النَّاسِ" الحُجاج "بِعَرَفَةَ" يوم عرفة، وإلى مجيء الجِمال مِنَ الأماكن البعيدة، قال تعالى: (وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ) [الحج:27] الله يحفظ على الأُمة شعائرها وشعارها ودينها.
"ثُمَّ يَدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ"، مِنْ عرفة إلى مُزدلفة إلى مِنَى، "فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ" صبيحة يوم النحر، يوم العاشر مِنْ ذي الحجة، يوم العيد، "نَحَرَهُ"؛ يعني: بعد أن يرمي جمرة العَقبة، "قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ" وذلك هو الأفضل، فإن معظم أعمال الحجّ في ذاك اليوم، اليوم العاشر، والسُنَّة أن يُرتّب بينها، ويجوز أن يقدّم أيّ واحد على الآخر، فإنه ما سُئل عن تقديم شيء وتأخيره إلا قال: "افْعَلْ ولا حَرَجَ"، ولكن السُنَّة أن يكون على الترتيب كفِعله ﷺ؛ رميّ أولًا، ثُمَّ نحرٌ، ثُمَّ حَلقٌ، ثُمَّ طواف، فيضبطونها أنّها على ترتيب (رَن حط):
-
فالراء رمزٌ للرمي.
-
والنون للنحر.
-
والحاء للحَلق.
-
والطاء للطواف.
رن حط، فيرمي أولاً، ثُمَّ يَنحر، ثُمَّ يحلق، ثُمَّ يطوف، هذا الأفضل، وإنّ قدم واحدًا على الثاني جاز، كما كان يقول ﷺ: "افْعَلْ ولا حَرَجَ"،" ما سُئل عن شيء قُدّم ولا أُخِّر؛ أي: من أعمال الحج في يوم النحر إلا قال: "افْعَلْ ولا حَرَجَ".
فقال: "قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ"، كما قال تعالى: (وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [البقرة:196].
"وَكَانَ"؛ يعني: ابِن عُمَر "يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ" أيضًا لأجل الاتباع "يَصُفُّهُنَّ قِيَاماً" وهذا الأفضل، النَحر للجِمال، "يَصُفُّهُنَّ قِيَاماً" (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ) [الحج:36]. "وَيُوَجِّهُهُنَّ"؛ أي: الهدايا "إِلَى الْقِبْلَةِ"؛ يعني: يستقبل بذبيحته القِبلة، وهذا هو الأفضل، فاستحبَ الجمهور استقبال القِبلة، حتى كان ابِن عمر يكره أن يُؤكل مما لم يُستقبل به القِبلة، فهو مُستحبٌ عند الجمهور.
"ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ" وذلك أن الهَدْي المسنون يجوز الأكل منه ويُطعم، مثل الأُضحية.
-
إذا كانت سُنَّة جاز أن يأكل منها، وأن يُطعم.
-
ويجب عليه أن يُطعم الفقراء أيَّ شيءٍ من لحمها.
-
أمّا إن كانت منذورة كالهَدْي إذا كان منذور، أو بسبب تقصيرٍ في الحجّ فكلُّه يجب أن يُبذل ولا يأكل منه شيئًا؛ لأنّه واجب.
وعند الإشعار يُسمي الله ويُكبّر (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ) يصفُّها ويذكر اسم الله عليها، وذلك عند النحر يصفّها، وينحرُها (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا) إشارة إلى أنّه تمّ النحر وسقطت الأرض (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [الحج:36].
(لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا) ما يصل إلى الله تبارك وتعالى اللحوم ولا الدماء هذه، ولكن الذي يعتبره ويقبله ويثيب عليه ويرضى به، التّقوى منكم، ما في قلوبكم (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ) [الحج:37].
فما ترتَّب الفضلُ في النحر وإراقة الدماء إلاّ على أساس التقوى، وقصدِ وجهِ عالم السّر والنجوى، جلّ جلاله وتعالى في علاه.
قال الإمام الحدَّاد في وصف أعمال الحج يوم النحر:
وجئنا مِنى في خير كلِّ صبيحةٍ *** لرميٍ إلى وجه العدو المجاهر
حَلْقٍ وإهداء الذبائح قُربةً *** إلى الله والمرفوعُ تقوى الضمائر
(وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ)
……………………… *** …… والمرفوعُ تقوى الضمائر
وبِتْنا بها تلك الليالي ويالها *** ليالٍ لقد طابت بِطِيب التَّزاوُر
ألا يا ليالي الخير عودي وأسعدي *** لكي يحيا منّيِّ كل ميتٍ وداثر
الله يحفظ على المسلمين شعائرهم ومشاعرهم، وهيبتها، ومكانتها، وقصدها، والاجتماع عليها.
قال: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ"؛ يعني: للإشعار "وَهُوَ يُشْعِرُهُ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ" (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ) [البقرة:185] ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فمن تولّى إشعار هَدْيه يقول: بسم الله والله أكبر، وهكذا يقول بعض أهل العلم: يُستحب أن يُكبّر عند التوجّه مع سَوق الهَدْي، الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
قال: "وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ وَأُشْعِرَ وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ"؛ أي: هذا كمال الهدي، ولكن عند الحَنَابِلَة والشَّافعية: لا يجب أن يجمع في الهَدْي بين الحِل والحَرم، لكن ذلك هو الأكمل.
وقال: "وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ"؛ يعني: يكسوها "يُجَلِّلُ بُدْنَهُ" جمع بَدْنة "يُجَلِّلُ بُدْنَهُ"؛ يعني: يطرح على ظهرها الجِلال، فالتَجليل مُختصّ بالإبل مِنْ ِكساءٍ رقيقٍ يُجعل على ظهر الجِمَال. "الْقُبَاطِيَّ" وصف ذلك الجِلال والكِساء الذي يضعه على جِماله أنّه قُباطي، ثوب رقيق مِنْ كَتان يُعمل بمصر، نسب إلى القِبط، "الْقُبَاطِيَّ وَالأَنْمَاطَ" جمع نمط، ثوب أيضًا منْ صوف ذو لون مِنْ ألوان يُقال له: أنماط، ولا يُقال للأبيض نمط، "وَالْحُلَلَ" جمع حُلّة، برود يمانية، لا تُسمى حُلّة إلا إذا كانت ثوبين من جنسٍ واحد. "ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا"؛ يعني: بعد أن ينحر الهَدْي يأخذ هذه الجِلال والأكسية "إِلَى الْكَعْبَةِ فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا" لأن كسوتها من القُرَب، وكان كما يُذكر أهل التاريخ أن أول مَنْ كساها تُبَّع الحِمْيَري ثُمَّ لم تزل تُكسى.
قال: "عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ: مَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ بِجِلاَلِ بُدْنِهِ حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هَذِهِ الْكِسْوَةَ ؟" هذه الكسوة المعروفة، ما صار يُحتاج إلى هذه الجِلال يُهدى بها إلى الكعبة فتُكسى بها، "فَقَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا."؛ لأنَّ جِلال البُدْن كانت كِسوة الكعبة، وكان أولى بها مِنْ غيرها، فلما كُسيت الكعبة رأى أن الصدقة بها أولى، لأن الهَدْي وإن كان له تعلُّق بالبيت فإنّ مصرفه إلى المساكين مستحقّي الصدقة، فكذلك الجِلال الذي عليه.
قال: ويُحتمل أن يكون كسوة سيدنا ابِن عُمَر للكعبة قبل أن يعلم أن رسول الله ﷺ كان يُقسم جِلال بُدْنه، فلما علِم ذلك رجع إليه فقسَّمه وأعطاه للفقراء، اتباعًا للنبي ﷺ.
فإن كانت البُدن سُنَّة غيرَ منذورة:
-
فيجوز الأكل منها، وكذلك الانتفاع بلبنها، وكذلك الانتفاع بجلدها مِنْ دون بيع.
-
وإن كانت فرض فيجب أن يتصدّق بالجميع.
يقول: "وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : فِي الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ، الثَّنِىُّ فَمَا فَوْقَهُ" لا يصِحُ إلا ما كان ثنيًا، يعني ما له:
-
من المَاعز سنتان ودخل في الثالثة، وكذلك من البقر.
-
ومن الجِمال ما له خمس سنين ودخل في السادسة.
-
ومن الضَّأْن ما له سنة ودخل في الثانية.
وقال: "وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَشُقُّ جِلاَلَ بُدْنِهِ"؛ يعني: لا يقطعها منْ موضع لِئَلا تَفسُد، تكون قابلة لأي انتفاع، نعم. وقال: "وَلاَ يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ"؛ يعني: لا يكسوها الجِلال إلا ذاك اليوم، لأنّه قبل ذلك لو جلَّلها لتَغطى الإشعار الذي أشعرها به، لن يُرى ولا عُرفت، ولكن عندما يغدو بها إلى عرفة يُجلّلها، "حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ". وجاء عن ابْنِ المُبارك أن ابِنْ عُمَر جلّل بِذي الحُليفة، فإذا مشى عليه نزع الجِلال، فإذا قَرُب من الحرم جلّلها، فإذا خرج إلى مِنَى جلّلها، فإذا كان حين النحر نزعها.
قال: "وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِىَّ لاَ يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ للهِ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئاً، يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ" كريم عليه، عزيز عنده يريد أن يُكرّمه بذلك وأن يُعظمه، قال: "فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ، وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ" أن نُخرِج له أحسن ما عندنا، وأن نُؤثِره بأشرف وأجمل وأثمن ما عندنا فنختاره لله، جلَّ جلاله وتعالى في علاه.
رزقنا الله تعظيم شعائره، والاقتداء بنبيّه، والاهتِداء بهديه، والدخول في دائرته، والحضور في حضرته، بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.
17 ذو القِعدة 1442

