شرح الموطأ - 206 - كتاب الحج: باب ما يجوز مِن الهَدْي
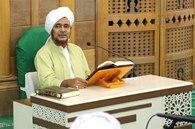
شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب ما يجوز مِن الهَدْي.
فجر الأربعاء 13 ذي القعدة 1442هـ.
باب مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْىِ
1107 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى جَمَلاً كَانَ لأبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
1108 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ : "ارْكَبْهَا". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: "ارْكَبْهَا وَيْلَكَ". فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ.
1109 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ: أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ، وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ، فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا.
1110 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْدَى جَمَلاً فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
1111 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِىَّ أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةٌ.
1112 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ النَّاقَةُ، فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا.
1113 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِحٍ، وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرْوَى فَصِيلُهَا، فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.
نص الدرس مكتوب:
الحَمدُ للهِ مكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسانِ عبده خير الورى، سيدنا محمد الراقي إلى أعلى الذرى، وعلى آله وأصحابه طرًّا، ومن سار بمسارِهم مخلصًا للهِ سرًا وجهرًا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمُرسلين سادات الكبراء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنّه أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، لا إله إلا هو واهب خيري الدنيا والأخرى.
وبعدُ،
يواصل الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- ذكر الأحاديث المتعلقة بالحج، ويذكر في هذا الباب: أمر الهدي،
-
وهو: ما يُهدى إلى الحرم المصون من الإبل، أو البقر، أو الغنم لتذبح هناك، ويُوزّع ويُقسّم لحمها.
-
والهدي يكون سُنّة لمن قصد بيت الله تبارك وتعالى، وأراد الدخول إلى حرم الله، فيستحب له أن يُهديَ إلى الحرم شيئًا من الإبل، أو البقر، أو الغنم.
-
فأفضلها الإبل، وتجزئ الواحدة عن سبعة، وكذلك البقر.
-
ثم الشياه وإنما تجزئ الشاة عن واحد في الأضحية.
-
-
ثم أنّه قد يكون عليه واجب الهدي، وذلك بأن يرتكب محظور من محظورات الإحرام، التي فيها الهدي فيكون دم جبران ونقص. وجعل الحنفية أن دم التمتع، ودم القرآن دم الشكر؛ أنه يُخرج شكرًا للهِ تعالى على ما بَلَّغَ إلى هذا الموطن المبارك، ويَسّر العمرة والحج.
-
ويكون مندوبًا بعد ذلك كحال الذي يدخل بل المستطيع، وإن لم يذهب إلى الحج، فَيُسَن له إذا قدر أن يبعث مع الذاهبين إلى الحج، أو يُوَكّل أحدهم بأن يشتري شيء من النَّعم ويذبحها عنه في مكة المكرمة.
يتحدث في هذا الباب عن هذا الهدي، الذي جعله الله تبارك وتعالى من القُربات إليه، وفيه التمتع بنعمته التي أباحها للمؤمنين من طعم هذه الحيوانات، لحوم هذه الحيوانات، أباحها لعباده لمصلحتهم أن يجعلها طعمة لهم. ثم إذا خُصّص ما يُنحر من الإبل، أو البقر، أو الغنم الى الكعبة المشرفة تحوّلت إلى شعيرةٍ معظمة، وذات مكانة محترمة قال تعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ)[الحج:36] وكانوا يُطلقون البَدنَة على ما أهدوه إلى الحرم، كما سمعت في رواية الحديث.
حينئِذٍ تأتي الأحكام المتعلقة بهذا الهدي، وما يُهدى إلى الحرم من النَعم الإبل، والبقر، والغنم… الثمانية الأزواج المذكورة في القرآن الكريم؛ فإذًا سَوْق الهدي لمن قصد مكة حاجًا أو معتمرًا سُنّة مؤكدة، وقلنا أن الذي لا يحج وهو مستطيع فَيَسُن له أن يرسل مع الحجاج هديًا، ولا يحرم عليه شئ كما تقدم معنا إذا أرسل الهدي، وقد بعث ﷺ هديًا إلى الحرم وهو بالمدينة المنورة، وأمّا عام حجّ فساق معه الهدي، وبلغ ما ساقه معه من المدينة، وما أحضره له سيدنا علي من اليمن إلى مِئة بدنة، نحر منها يوم النحر بيده الكريمة ثلاث وستين بدنة؛ ثم أمر سيدنا علي أن يكمل نحر البقية.
وفيه أن ﷺ أمر أن تؤخذ من كل واحدة قطعة، فأطعمها أمهات المؤمنين وقراباتِهِ الذين معه في حجة الوداع، صلّى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.
إذًا، فاتفق الأئمة -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى- على سُنِّية الهدي لمن قصد مكة، وخصوصًا بنسكٍ أو عمرةٍ أن يهدي هديًا.
-
وتمام الهَدي: أن يحمله من الحلِّ إلى الحرم
-
ويمكن أن يشتريه في الحرم، أو في مكة
ولكن سَوق الهدي هو السُنَّة؛ وهو أن يسوقه من خارج الحرم إلى داخل الحرم.
فذَكر لنا: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى جَمَلاً"، والجمل هو ذكر الإبل في اللغة، "كَانَ لأبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ"، الذي قُتل كافرًا يوم بدر "فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ".
و جاءَ أنّه ﷺ ساقَ البُدن، وأمر عليًا أن يسوق له بُدنًا أُخَر إلى مكة في عام حجة الوداع، ونَحرها يوم النحر. فإذًا أُهدِيت بمناسبة الحج؛ فنحرُها في أيام النحر: يوم العاشر، ويوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. فهذا أيام نحر الهَدي الذي يُهدى في مناسبة الحج. وقد أهدى ﷺ في جملة هديه جملًا لأبي جهل في أنفه برّة من فضة ولمّا كان ذلك من الجِمال الحسنة القوية أهداها ﷺ.
وروى لنا الحديث الثاني عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً"، وليس معه غيرها يركب عليها إلا هذه البدنة التي هيأها للهدي للحرم "فَقَالَ: ارْكَبْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: ارْكَبْهَا وَيْلَكَ"؛ ففيه: جواز الركوب إلى الهّدي لمن احتاج إلى ذلك -وكما أشار في روايات تأتي معنا- أن يكون بالرفق، وبالمراعاة لها حتى لا تتضرر بركوبه عليها.
وقد جاء أيضًا أن امرأة من الصحابيات قد حرصت على أن تحج مع رسول الله ﷺ، فكلّمت زوجها، فقال: لا أجد ما أحملك عليه؟ قالت: جملك الفلاني.. قال: إني قد جعلته في سبيل الله، والثاني عليه ناضحه، فلمّا رجع رسول الله ﷺ أخبرته قال: أما أنه لو أركبك إياه لكان في سبيل الله! فهو وإن كان هَديًا ومُعد في سبيل الله فركوبك إياه من جُملة ذلك، قالت: فما أصنع؟ قال: "إن عمرةً في رمضان كحجة معي" صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
فكونها بَدنة، قد عرفه ﷺ بالنسبة للرجل هذا كونها مقلّدة، لأنه يتعلق بالهدي أن يُعلم ويُميّز أنه مُهدى للحرم، وكان القبائل في الجاهلية لا يتعرّضون لشيءٍ أهديَ للحرم، فيُجعل عليه علامة إشعار وتقليد؛
-
أمّا الإشعار فيكون للإبل وللبقر، وذلك أن يكشط من جلدها عند السنام في الجانب الأيمن؛ ثم يسلت ذلك الدم ويبقى هذه علامة أنها هدي تهدى إلى حرم الله، ولا يكون ذلك في الغنم.
-
والإشعار أن يُجعل علامة بأن تُقلّد نعلًا أو نعلين وتُجعل على رقبتها فيُعرف إن هذه أُهدِيت لحرم الله تبارك وتعالى.
ويخفف على الغنم بأن يقلّدها ما يسهل عليها حمله ولا يثقل ولا تتعب. وقد جاء عنه ﷺ الإشعار، وجاء عن التقليد؛ القلائد وبعثها إلى الحرم الشريف. فهو يرى أنها مقلدة ويعرف، ولكنه رأى الرجل يمشي وهذه الناقة تركها لأنه أهداها إلى الحرم فقال له: "ارْكَبْهَا وَيْلَكَ".
وكان ﷺ في حجة وداعه إذا رأى من الناس من لا مركوب له، أمرهم أن يركبوا على هديه ﷺ الذي أهداه، فيقدمها لهم، يَتبلغون بها إلى مكة المكرمة ﷺ.
فجاء برواية الإمام مسلم: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة، قال له رسول الله ﷺ: ويلك اركبها! فقال: بدنة يا رسول الله، قال: ويلك اركبها! ويلك اركبها" وهو ﷺ يعلم أنها بدنة؛ فما كان يحتاج إلى مراجعة رسول الله ﷺ. ولذلك أدَّبه بقوله "ويلك" الكلمة الدارجة على ألسن العرب للتوبيخ والعتاب، ولا يراد بها أصل معناها وهو حصول الهلكة على صاحبها، وإنما اعتاد العرب قولها توبيخًا.
إذًا:
-
فبيّن لنا الحديث أن الركوب على الهدي جائز كما هو واضح في هذه الرواية.
وجاء أيضًا في غيرها وأشرنا إلى بعضها. فمن العجيب ما قال بعض أهل الظاهر مثل هذا الحديث إن الركوب على الهدي واجب! وهذا قول غريب. وقال عطاء: كان ﷺ يأمر إذا احتاج إليها سَيِّدها أن يحمل عليها، ويركبها غير منهكها؛ من دون أن ينهكها، ولا يثقل عليها، ويتعبها ويؤثر عليها.
-
والقول الثاني في هذا الركوب على البدنة: الجواز مطلقًا، وهذا الذي جزم به الإمام النووي وغيره، وفي غيره أيضًا من الكتب وهو المروي أيضًا عن الإمام مالك.
-
وفي رواية كذلك عن الإمام أحمد بن حنبل القول: أن جواز ركوب الهدي مقيد بالحاج لا مطلقًا.
وهكذا كما هو معلوم من خلال النصوص أن الناس كانوا يحترزون من ركوب الهدي، ولكن ﷺ رأى ذوي الحاجة فأمرهم أن يركبوا، وهذا دليل الذين قالوا: أنه مُقيَّد بوجود الحاجة بأن لم يجد ويثقل عليه المشي، ولم يجد مركوبًا غير هذا الهدي، فلا ينبغي إذًا أن يركب الهدي إلا إذا احتاج إلى ذلك.
-
وفي قول أيضًا آخر غريب: أنها لا تُركب إلا عند الاضطرار نقل عن بعض التابعين.
-
وهكذا قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه لا يركب على الهدي إلا للضرورة.
إذًا لغير الضرورة من العلماء من كَرِهَ ركوب الهدي احترامًا وإكرامًا. ويروى المنع مطلقًا في رواية عن الإمام أبي حنيفة فهذا اختلاف العلماء في ركوب الهدي .
ثم ذكر لنا حديث: "عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُهْدِي فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ بَدَنَتَيْنِ، وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً بَدَنَةً"، يقول الراوي وهو عبد الله بن دينار: "وَرَأَيْتُهُ" يعني: ابن عمر "وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ"؛ ففيه:
-
مباشرة المهدي الذبح بنفسه وذلك خير وسُنّة وليس بواجب.
-
وإن الإبل تُنحر قيامًا وهذا من باب الأفضل، وهو عمله ﷺ فقد عُقّلت له الإبل، وصُفّت له وتناول المدية وقد وصل من مزدلفة إلى مِنى فرمى؛ ثم وقف في المنحر لينحر فصُفّت له الإبل وعُلّقت.
قال أهل السيرة: وكانت الإبل تراه فتُقدّم رقابها، تتسابق إليه تقدم رقابها، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تريد أن يكون نحرها بيده لا بيد غيره، حتى نحر ثلاث وستين بيده الكريمة.
-
وإذا لم ينحر بيده صاحب الهدي فيُسَنّ أن يشهد وقت ذبحها، كل ذلك من السنن.
مثل الأضحية يتولى ذبحها بنفسه أو يشهدها، كما قال للسيدة فاطمة: قومي اشهدي أضحيتك، فإن الله يجعلها في ميزانك يضاعفها سبعين ضعفًا، وإن الله يغفر لك لأول قطرة من دمها.
وذكر فضل الأضحية فقال له الصحابي: يارسول الله أهذا لآل محمد خاصّة فهم أهل لما خُصّوا به من الخير أم للناس عامة؟ قال: لآل محمد خاصّة وللناس عامة، أو قال: ولأُمتي عامة، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
في هذا الحديث ذكر نحرها قيامًا، وعليه جمهور الفقهاء بالنسبة للإبل ففيها النحر، أمّا البقر والغنم فيها الذبح والنحر؛ أن ينحر لبّتها بالسكين الحاد لتخرج منها الدماء ثم يواصل بعد ذلك بقية ذبحها.
إذًا، فالسُنّة بالنسبة للإبل: نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، يضربها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، قال: "فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ"؛ في مكة المكرمة، أخو عتاب هذا الذي ولاه النبي ﷺ على مكة لمّا فتحها عتاب بن أسيد، وهذا خالد بن أسيد، "وَكَانَ فِيهَا"؛ يعني: في دار خالد "مَنْزِلُهُ"؛ أي: منزل عبد الله بن عمر، إذا حجَّ أو اعتمر، كلما يأتي فينزل فيها، كلما جاء للنسك
"قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ" في العمرة "طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا". فجاء في رواية: حتى خرجت سنّة الحربة من تحت حنكها.
-
فالنحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر.
-
والذبح قطعها في أعلاه تحت اللحيين.
-
فالذكاة في النحر طعن بلبّة، فلا يرفع السكين حتى يتم النحر.
قال: "أن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَهْدَى جَمَلاً فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ" رضي الله عنه. "وعن أبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِىَّ أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بُخْتِيَّةٌ"؛ الجِمال البختية جِمال طوال الأعناق ويكون لها في الغالب سنامان غلاظ، فهي بُختية، بالنسبة للناقة، وللجمل يقولون له: بُختي، هذه نوع من كبار الجمال، وهنَّ طوال الأعناق وغلاظ، يكون لها سنامان غالبًا، فهذه البختية.
-
والمعنى: يُجزئ في الهدي أنواع الإبل؛ بُختية كانت أو غيرها.
والقوي من الإبل يقال له: نجيب، وهذا النوع طوال الأعناق يقال له: بُختي.
و "عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نُتِجَتِ النَّاقَةُ، فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا"؛ يعني: ولدت "حَتَّى يُنْحَرَ" الولد "مَعَهَا" لأنه تبع لها، "فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ"؛ يعني: ما يركب عليه، "حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا"؛ فما أنتجته الناقة المهداة يكون تبع لها.
وذكر لنا بعد ذلك حديث: "عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوباً غَيْرَ فَادِحٍ"؛ غير ضار بها ولا مثقّل عليها، "وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرْوَى فَصِيلُهَا"؛ يعني: ولد الناقة؛ الفصيل" فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا" ولدها.
رزقنا الله الاقتداء والاتباع، والاهتداء بهَديّ حبيبه خير مذكّرِ ومعلمٍ وداع، وأصلح الشأن لنا وللمسلمين، ودفع عنّا الآفات وعن المؤمنين، وحوّل أحوالنا إلى أحسن الأحوال بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي محمد ﷺ.
14 ذو القِعدة 1442

