شرح الموطأ - 205 - كتاب الحج: باب ما جاء في صيام أيام مِنى
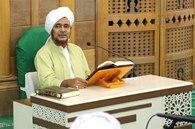
شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب ما جاء في صيام أيام مِنى.
فجر الثلاثاء 12 ذي القعدة 1442هـ.
باب مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى
1103 - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى.
1104 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنًى يَطُوفُ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ.
1105 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى.
1106 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، أُخْتِ عَقِيلِ بْنِ أبِي طَالِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ، قَالَ: فَدَعَانِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ إنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ هَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِنَّ وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ.
قَالَ مَالِكٌ: هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.
نص الدرس مكتوب:
الحمدُ لله مُكرِمنا بالشَّريعة، وبيان أحكامها على لسان عبده مُحمد الذي وهبه الحُسن جميعه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وكرَّم على عبدك المُصطفى سيدنا مُحمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، أهل النفوس الزَّكية المُطيعة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل العرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، والملائكة المقربين، وجميع عبادك الصَّالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
أما بعدُ،
فَيتحدث سيدنا الإمام مَالِكْ رضي الله عنه عن صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى، وأيام مِنَى تُطلق على الثلاثة الأيام: اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحِجة، وهي التي تُسمى الأيام المعدودات، وتسمى أيام رمي الجِمار، وقد يضاف إليها يوم النحر، ولا يتعلق به المبيت بمِنَى مِنْ قبله ولكنه أيضًا من الأيام المتصلة بأيام مِنَى، وعلى هذا يكون قول مَنْ عدّ أيام مِنَى أربعة أيام. والمعروف المشهور أنها الأيام الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، ومن تعجّل صارت له يومان، كما قال تعالى: (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ) [البقرة:203]. ويوم العيد يوم النحر، هو يوم الرمي، يوم رمي بمِنَى، وبهذا الاعتبار عُدّ من أيام مِنَى عند بعضهم.
وجاء في ما روى ابِن أبي شَيبة، والإمام أحمدْ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابِن ماجة، والحاكم عدد رووه: أنَّ يعمر الديلي يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو واقفٌ بعرفة: "الحَجُّ عرفاتٍ، الحّجُ عرفاتٍ، فمن أدركَ ليلةَ جمعٍ" جمع مزدلفة، من أسماء مزدلفة: جمع "قبل أن يطلعَ الفجرُ فقدْ أدركَ أيام مِنَى ثلاثة"، (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ)، وهذا نص: "أيام مِنَى ثلاثة"، (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ) [البقرة:203].
وهكذا وقد علمنا أنَّ صوم يوم النحر مُحرَّم بالإتفاق كذلك، وفي صيام أيام التشريق تسمى:
-
أيام التشريق.
-
وأيام مِنَى.
-
والأيام المعدودات.
-
وأيام رمي الجمار.
وأنها أيضًا لا يجوز صومها،
-
فهو المعتمد عند الشَّافعية، وهو أيضًا مذهب الحَنَفِية أي مُطلقًا.
-
ويجوز عند الإمام مَالِكْ
-
والإمام أحمدْ في رواية عنه صومها لمُتمتع أو قارن مِنْ أجل صيام ثلاثة أيام في الحجّ، إذا لم يَصُم قبل يوم الوقوف فيصوم هذه الثلاثة الأيام لتكون ثلاثة أيام في الحجّ.
وكذلك ما جاء في صيام الأيام المعدودات إذا كانت عن فرضٍ فلا فرق عند الشَّافعية والحَنَفِية بين أن تكون عن فرضٍ أو عن نفلٍ فلا يجوز صومها. وسمعتَ ما جاء في رواية عن الإمام أحمدْ بن حَنبَل وفي قول عند الشَّافعية وما جاء عن المَالِكْية: أن المُتمتع والقارِن إذا لم يَصُم قبل ذلك فَيصوم هذه الأيام، وجاء في صحيح الإمام مسلم: أيام منى "أيّامُ أَكْلٍ وشُربٍ وذِكرِ اللَّهِ".
وهكذا جاء عن ابِنْ عمر وعائشة أنهما قالا: لم يُرخَص في أيام التشريق، يعني: في صيامِهن، لم يُرخص في أيام التشريق يعني يُصمنَ إلا لمن لم يجد الهَدي. وهكذا ما أشرنا إليه عند الحَنَابِلَة والمَالِكْية، والرواية الثانية عن الإمام أحمدْ أنه لا يجوز صومها، ولو لم يجد الهدي فيصوم فيما بعد ذلك.
ولهذا لو أنَّ ناذرًا نذر أن يصوم سنة، ما تدخل أيام التشريق فيه لأنها أيام نُهي عن الصيام فيها، كما لا يدخل أيام عيد الفطر وعيد الأضحى.
وجاء أيضًا عن الإمام مَالِكْ: أن النذر يصح في اليوم الأخير؛ لأنه يجوز فيه التعجيل، فيصح أن ينذر الصوم آخر يوم، يوم الثالث عشر، ولكن الرواية الأخرى عنه أنه كغيره بالنسبة للنذر وإنما يكون للمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي.
ثم ذكر لنا الحديث "عنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى." وذكر لنا الحديث أنه ﷺ نهى عن صيام أيام مِنَى، التي هي ثلاثة بعد يوم النحر. ويقول عن "ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ" السَّهمي ممن أسلم قديمًا وهاجر الحبشة مع أخيه قيس بْنَ حذافة، وكانت وفاته في ِمصر في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عنه، وجاء أنه الذي أسره الروم وأسروا معه عدد مِنَ الأسرى نحو ثمانين أسير، أسرهم الروم في الجهاد فأرادوه على الكُفر فأبى، حبسوه ثلاثة أيام بلا طعام، قدّموا له الخَمر ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب، فدعاه المَلِك وقال له: لماذا لم تأكل ولم تشرب، أما يجوز عندكم في الشريعة إذا يخشى على نفسه الهلاك أن يأكل لحمَ الخنزير؟ قال: لكني أردت أن لا تُسرّون بأكلي شيء مِمّا حرَّم الله عليّ وتُكرهوني على ذلك، تعجب في قوة إيمانهم، قال له: إذًا تخرج عن دينك هذا ولك نصف ملكي وأُزوجك ابنتي، قال له: لو تعطيني مُلكك كله على أن أخرج عن هذا الدين لحظةً ثم أعود إليه ما قبلت، فأمر بإيقاد زيت، أوقدوا الزيت في الطست، قال: ضعوا قبله من أصحابه، فوضعوا الأول والثاني، لمَّا أرادوا يحملوه ويضعوه دمعت عيناه، قالوا إنه بكى ورقّ، قال: ردوه إليّ، قال: إذًا ترجع عن دينك وتَسلم؟ قال: أبدًا، قال: فلمَ بكيت؟ قال: بكيت أني رأيت الاثنين اللذيْن رميتهم أمامي بسرعة خرجت أرواحهم، ماتت، فأنا أُحب أن يكون لي مائة نفس إلى نفسي تُعذَب في سبيل الله، يُفعل بها هكذا في سبيل الله، تعجَّب فيه، قال له: تُقبِّل رأسي وأطلقك، قال له: تُطلق المسلمين كلهم؟ ثمانين أسير معه، تُطلقهم؟ قال: نعم، فعل، فخرج بالأسرى معه، قال احملوا نفسكم وخرج هو وإياهم قال: قلت في نفسي عدو الله إذا كان يُسلِّم أرواح هؤلاء المسلمين ما عليّ أن أقبّل رأسه أنا لا أُعظِّمه ولا أحبه؛ ولكن أُنقذ أخواني منهم، فخرج، بلغت القصة -في أيام سيدنا عُمَر- إلى سيدنا عُمَر فانتظروهم حتى جاؤوا فاستقبلهم سيدنا عُمَر ومن معه مِنَ الصَّحابة فسألوه عن القصة فأخبرهم، فقال: حقٌ على كل مسلم أن يُقبِّل رأس عبد الله بِنْ حذافة وأنا أبدأ، لِما أظهر مِنَ الإيمان واليقين والثبات، ولِما تَسبّب بعد ذلك في تخليص ثمانين نفر مِنَ المسلمين.
"بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنًى يَطُوفُ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ"؛ يعني يدور بين النَّاس وينادي: "إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ" ثم قال: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ) [البقرة:203]، فكان مِنَ الذين جعلهم ﷺ مبلّغين هذا الحُكم عنه في أيام مِنَى، وقد أمره يدور على النَّاس في منى حتى لا يظن أحدٌ منهم جواز التقرب إلى الله بالصَّوم في هذه الأيام، فبعثه "أَيَّامَ مِنًى يَطُوفُ يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ".
قال سيدنا علي -رضي الله عنه-: القوم زاروا الله عز وجل، فهم في ضيافته في هذه الأيام، وليس للضيف أن يصوم دون إذن مَنْ أضافه! هؤلاء ضيوف الرحمن جلَّ جلاله، وزاروه، وجاءوا أكملوا وقوفهم ورميهم، قال: خلاص محلكم أنتم ضيوف ما لكم الصوم، "أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ". دعا عباده إلى زيارة بيته فأجابوه، وقد أهدى كلٌ على قدر وِسعه، وذبحوا هَديهم فقِبله منهم، وجعل لهم ضيافةً ثلاثة أيام، فأوزعَ زوَّاره طعامًا وشرابًا. قالوا: وعادة الملوك إذا أضافوا أطعموا مَنْ على الباب كما يطعمون مَنْ في الدار، والكعبة هي الدار.
قال: "وَذِكْرِ اللَّهِ"؛ أي: ينبغي أن يُكثر فيها الذكر بأي ذكرٍ، ومن أعظمه في أيام مِنَى ترديد الدعاء: ربنا ءاتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، فإنَّ الحق ذكره بعد ما ذكر الإفاضة مِنْ مِنَى؛ (وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ* ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ)؛ أي: مِنْ نصيب (وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ* أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ) [البقرة:198-202]، فهي أيام التكبير، وأيام الدعاء، وذكر الله عز وجل.
وكان سيدنا عُمَر في خلافته لما حجَّ، وكان في أيام مِنَى كلما أراد أن يخرج كبّر مِنَ المَسْجد، فكبّر بتكبيره من في المَسْجد، يسمعهم أهل السوق فيكبّر بتكبيرهم من في السوق، فترّتجّ منَىً تكبيرًا حتى يُسمَع لجيجُ الصوت مِنْ أطراف مكة ويُقال الآن خرج الأمير يرمي، الله أكبر، لأنه ليس بين الصَّحابة من يقول هذه مبالغة أو هذه بدعة، "إنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أصَمَّ ولا غائِبًا".. لم يكون بين الصَّحابة من يقول هذا ولا مَنْ يعتقد هذا… فترتَّج مِنَى تكبيرًا بتكبيرهم رضي الله عنهم وهم تلامذة من؟ تلامذة زَين الوجود صلَّى الله عليه وسلَّم وبارك عليه وعلى آله.
وأورد لنا حديث: "أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى". ولماذا أدخل هذا الحديث؟ لأنه قِيل أنَّ يوم الأضحى مِنْ أيام مِنَى، ولهذا دخل الحديث هذا، الحديث عن صيام يومين، فطر وأضحى، أين أيام مِنَى؟ الأضحى قيل أنه من مِنَى فلهذا جاء بهذا الحديث.
وروى لنا أيضا حديث: "عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ"، وجد أبوه في وقت طعام، فدعاه، "قَالَ: فَدَعَانِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ إنِّي صَائِم"؛ يعني: يُظهر العذر، "فَقَالَ في هَذِهِ الأَيَّامُ" وكانت أيام التشريق، "الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِنَّ وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ. قَالَ مَالِكٌ: هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ"، يعني: في هذه الأيام تقول تصوم التي أمرنا ﷺ أن نفطر فيهن.
رزقنا الله الاستقامة، وأتحفنا بالمِنَن والمواهب والمزايا والكرامة، وأخذ بأيدينا وقرّبنا إليه زلفى وأسعدنا بأعلى السعادة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار المُقامة، وحفظ الله للمؤمنين مشاعرهم وشعائرهم ومعالم دينهم، وأدام حفظ الحرمين الشريفين وخلّص بيت المقدس من سلطة أعداءه وأعداء رسوله، وفرّج كروب المسلمين في المشارق والمغارب وألهمهم الرشد، ودفع عنا وعنهم جميع البلايا في الظواهر والخفايا بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النَّبي محمد ﷺ.
13 ذو القِعدة 1442

