شرح الموطأ - 191 - كتاب الحج: باب أمر الصيد في الحَرَمِ، وباب الحكم في الصيد
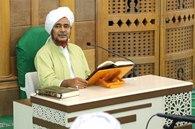
شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب أمْر الصَّيْدِ في الحَرَمِ، وباب الحكم في الصيد.
فجر الأربعاء 21 شوال 1442هـ.
باب أَمْرِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ
1025 - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَىْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ فَقُتِلَ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ، وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَزَاءُ الصَّيْدِ، فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ فَيَطْلُبُهُ، حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
باب الْحَكَمِ فِي الصَّيْدِ
1026 - قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ) [المائدة:95].
قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلاَلٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ.
1027 - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ: أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا، أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْماً، وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ، فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِيناً، صَامَ عِشْرِينَ يَوْماً، عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
1028 - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلاَلٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
نص الدرس مكتوب:
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأحكامه، ومبيّنها على لسان عبده محمد أشرف أنامه. اللهم صلِّ وسلم وبارك وكرّم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، الذين فاض عليهم الإكرام من إكرامه، وعلى من والاهم فيك واتّبَعَهُم بإحسانٍ فَحُظِيَ بحسن اقتِدائه واقتِفائه وائتِمَامه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات خلق الله -تبارك وتعالى-، المُبيِّنين لحكم الله في حلاله وحرامه، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان، وعلى ملائكة الله المقرّبين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، المُتفرّد بالقضاء في الأمر وإبرامه.
وبعدُ،
يواصل سيدنا الإمام مالك في الموطأ الكلام عن أمر الصيد في الحَرَمْ، يقول: "باب أَمْرِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ"؛ فصيد الحَرم المكّي ثم المدني: حرام، لا يجوز لأحد أن يتعرض لشيءٍ من الصيد البرّي وسط الحرم الشريف في مكة المكرمة وماحواليها إلى الحدود المُحرَّمة من كل جهة، حَرَمًا؛ حرّمها الله -تبارك وتعالى-، وكذلك الحدود التي حدَّها ﷺ في المدينة المنورة، فحُرمة الصيد في كلٍّ منهما.
- ويختصّ الحرم المكي بالجزاء في ذلك الصيد، وأنّ من صاد شيئًا فعليه جزاءٌ مقابل ذلك الصيد، وكفّارة يُخرِجُها.
- ويأثم من قتل شيئًا من الصيد في الحرم المدني، ولا يلزمه في ذلك جزاء ولا كفارة بل يلزمه التوبة والندم.
فإنه ﷺ حرّم المدينة كما حرّم إبراهيم مكة.
قال -عليه رضوان الله تبارك وتعالى-: "باب أَمْرِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ"؛ فصيد الحرم حرام على من كان حلالًا، وعلى من كان مُحرِمًا، سواءً كان حلالًا أو محرِمًا، وقد جاء في ذلك النص في السُّنة الغرّاء، والاجماع من الصحابة فمَن بعدهم. قال ﷺ في مكة: "إنَّ هذا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ"، ثم قال: "وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ"؛
- ما يجوز تنفيره
- فضلًا عن مَسِّه
- فضلًا عن قتله أو ذبحه
فلا يجوز أن يُنَفَّر، فلو كانت حمامة في الحرم لايجوز لِلمارِّ أن يُنفِّرها، بل يَعْدِلُ عنها ولا يُنفِّرها من بقعتها ومكانها، فإن نفَّرَها أَثِمْ، فلو قتل حمامة لوجب عليه شاة؛ كما أجمَع عليه الصحابة -عليهم الرضوان-، وقدّروا للحمامة في الحَرم أنّ مثله من النَّعم شاة، فجعلوا من قتل حمامة وسط حرم الله عليه أن يخرج كفّارة، شاة يذبحها في حرم الله ويقسِّمُها على الفقراء والمساكين، وهكذا تم الإجماع من عهد الصحابة ومن بَعدهم على ذلك.
وكلُّ ما حَرُمَ صيده على المُحرِم، ما يَحرُم ويُضمَن في الإحرام، يحرُم ويَضمُن في الحرم، سواءً كان الذي عَمِل ذلك حلالًا أو محرمًا وهكذا. إلا اختُلف في قتل المُحرم للقمل؛ هل يجوز أن يقتله أم لا؟ ولا اختلاف فيه بالنسبة للحَرم، ففي قتل القمل في الإحرام اختلاف، وهو مباح في الحرم بلا اختلاف -قتل القمل-، وكذلك إذا وَجد في شيءٍ من آبار مكة، وجد شيئًا من الحيوان المائي وسط الحرم؛ فكذلك اختُلف في جواز قتله، كما في رواية عن الإمام أحمد: أنه مباح، ولكن في رواية أخرى وعند جماهير العلماء: أنه لا يجوز ما دام وسط الحرم، بخلاف صيد البحر للمحرم؛ فمتفق على حِلّه لوجود النص فيه: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) [المائدة:96].
ولهذا يقول الإمام ابن حجر: يحرُم اصطياد كلِّ مأكول برّيٍ وحشيٍ حال كون ذلك الاصطياد؛
- كون الصائد وحده
- أو المَصيد وحده
- أو الآلة (الشبكة) وحدها
في الحرم المكي، ولو كان ذلك الصائد حلالًا ولو على الحلال، قال: إجماعًا، وللنهي عن تنفير الصيد. وهكذا يقول: فإذا قتل الصيد في الحرم وهو حلال أو حرام؛ فعليه الجزاء، وهكذا يقول عامة الأئمة -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى-: قالوا أنه إجماع الصحابة والتابعين.
وقال تعالى: (ولَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة:95]، معنى (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)؛
- يحتمل (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ): إمّا مُحرمون بحجٍ أو عمرة.
- (وَأَنْتُمْ حُرُمٌ): أي وسط الحرم، ومن كان وسط الحرم يقال له: مُحرِم، كما قال شاعرهم في قتل سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله عنه-:
قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا *** وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولا
معلوم أنه ما كان مُحرمًا بحج ولا بعمرة، ولكنه في حرم المدينة المنورة، كان وسط الحَرَم، فمعنى قوله مُحرمًا؛ أي وسط الحرم، (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة:95].
ويأتي أيضًا بمعنى كونه في الشهر الحرام، وليس هذا بالمقصود في الآية، إنما المقصود (ولَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)؛ إما مُحرمين بحج أو عمرة، أو حاصلين أو حاضرين في حدود الحرم، داخلًا في الحرم، وأنتم حُرُمْ. (ولَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [المائدة:95]؛ هذه جزاء فيه كفارة مثل ماقتل من أنواع الصيد، مثله من النَّعَم، هل يساوي أو يماثل الإبل أو البقر أو الغنم، فإن كان دون ذلك ففيه القيمة.
وهكذا، إذًا في صيد الحَرَم الجزاء على من يقتله، يُجزى بمثل ما يُجزى به الصيد في الإحرام، قال تعالى: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) [المائدة:95]؛ أي: يرى عَدلان أنّ هذا يساوي ماذا، وقد أسلفنا أنّ الصحابة -عليهم رضوان الله- رأوا أنّ الحمامة في الحرم تساوي شاة، وأنّ مثيلها من النعم شاة، فبذلك حكم الأئمة من بعدهم أن من قتل حمامة في الحرم فعليه أن يذبح شاة، كما جاء عن سيدنا عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس، وما كان هناك خلاف، فكان كالإجماع؛
- فمن اصطاد نعامة فعليه أن يُخرج جَملًا
- ومن اصطاد بقرًا وحشيًا أو حمارًا وحشيًا فعليه أن يُخرج بقرة
- وهكذا من اصطاد دون ذلك من الحيوان الذي يشابه الغنم فعليه أن يخرج شاة مقابل ذلك
- ومن صاد دون ذلك مما لامثيل له ولم يكن حَمَامًا فعليه قيمة ذلك أن يخرجه ويتصدق به في الحرم.
"قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَىْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ"؛ يعني سواءً كان الصائد مُحلًا أو مُحرمًا، "أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ فِي الْحَرَمِ"؛ سواءً كان المُرسل أيضًا حلال أو مُحرم، "فَقُتِلَ"؛ ذلك الكلب الذي أُرسل من الحرم، "ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ"؛ يعني نفَّره فخرج من حدود الحرم فقتله -الكلب-، "فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ"؛ لأحد في الصور كلها، لماذا؟ "وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَزَاءُ الصَّيْدِ".
"فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ"؛ خارج الحرم، ولكن صادف أن جرى الصيد فدخل حدود الحرم، "فَيَطْلُبُهُ"؛ يعني: الكلب يطلب الصيد، "حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ"؛ ممنوع أكله، وقال مالك: ولكن "وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جَزَاءٌ"؛ لأنه لم يرسله في الحرم ولا إلى الحرم، ودخول الكلب والصيد الحرم ليس من فعله، خارج عن فعله، "إِلاَّ أَنْ يَكُونَ"؛ هذا الصائد، "أَرْسَلَهُ"؛ يعني: الكلب على الصيد، "وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ"؛ أنت بجانب الحرم أما تعرف حق الجوار؟ وأنّ المجاور للشيء يُعطى حكمه؟ لماذا بجانب الحرم تُرسل؟ اذهب بعيد هناك واصطاد، لا تصطاد بجانب الحرم، فإذا اصطاد بجانب الحرم فدخل فإنه يأثم وعليه الجزاء كذلك، "فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ."؛ فهذه فروع في مسائل فقهية مُختَلَف فيها عند المالكية وغيره.
- فإما أن يكون الصائد في الحِل والصيد في الحرم.
- أو يكون الصائد في الحرم والصيد في الحل.
فإذا كان في الحرم، فأخذ الصيد في الحرم أو الحِلْ فعليه جزاؤه؛ لأن الصيد قد كان مُتحرِّمًا بحرمة البيت، فإذا صاده أو أخرجه منه فأخذه في الحِل فقد انتهك حرمة الحرم، وأخذ صيدًا مُتحرِّمًا -لا إله إلا الله-، وكلام الإمام مالك هاهُنا واضح فيما يَقرُب من الحرم، فيمنع الاصطياد من قرب الحرم.
- وهكذا قال في الموطأ الإمام مالك: أنه عليه الجزاء.
- وقال بعض المالكية: أنه لايحرم عليه أن يصيد قريبًا من الحرم، فإذا قتله خارج الحرم وسَلِم من قتله في الحرم فهو مباح.
وهكذا، جاء إذا كان إما الصائد وإما المصيد وإما الآلة والشبكة وسط الحرم، فكله يؤدي الى حرمة ذلك الصيد، وإلى الاختلاف في وجوب أيضًا الجزاء على ذلك الصائد.
وقد شوهد ما بين الحيوانات التي يأكل بعضها البعض من وحوش البَرْ أنها إذا كانت بجوار الحرم، فجرى الحيوان الذي يُراد أن يُؤكل من الحيوان الآخر فدخل حدود الحرم، وقف الحيوان الآخر ولم يعتدي عليه وهو وسط الحرم، وهي حيوانات تعرف حُرمة مكان هذا الحرم الشريف ولا تقتل بعضها البعض وسط الحرم، فكيف بالمؤمن يتجرأ على حرم الله جلّ جلاله وتعالى في علاه؟!
لكن إذا أرسله من بعيد، ما يظن أنه يأخذ الصيد وسط الحرم ولا أن يصل الصيد إلى الحرم فصادف غير ذلك؛ فهنا لا جزاء عليه، ولكن مهما كان الكلب قتل الصيد وسط الحرم فلا يجوز أكله، إنما يخرج فقط من وجوب الجزاء إذا كان أرسله من مكان بعيد، لا يُظَنُّ في مثله أن يدخل الحرم. وهكذا أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم، فهو معصوم بمَحلِّه، بحرمة الحرم ولهذا قالوا: أَمِنَتْ فيه الوحوش.
وإذا أرسل كلبه وهو وسط الحرم فصادَ خارج الحرم، فهو مأثوم ولا يحلُّ له ذلك، ولكن هل عليه جزاء أم لا ما دام الصيد وقع خارج الحرم؟ فقال أكثر الفقهاء: أنه لا جزاء عليه لكون القتل وقع خارج الحرم، وإن كان هو أرسل كلبه وهو وسط الحرم، لكن الصيد كان خارج الحرم، فأرسله إلى خارج الحرم فصاده، فهذا من جهة الجزاء. ويقول: الحكم في الصيد؛ لأن الآية الكريمة حكمت بأنه (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ) [المائدة:95]؛ أي: يرى عدلان من المسلمين، من المؤمنين، من أهل العلم، أن هذا الحيوان يعادل ماذا من الإبل والبقر والغنم، (فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ).
باب الْحَكَمِ فِي الصَّيْدِ
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) [المائدة:95]؛ والصيدُ الذي تَوحّش عند بعضهم سواءً كان مأكول أو غير مأكول، وقال الشافعية وغيرهم: أن المراد بالصيد؛ الحيوان البرّي المأكول المتوحّش، وقيل: المراد فقط ما توحش سواءً كان مأكولًا أو لم يكن، فيضمن إذا قتل سَبُعًا مثلًا لا يؤكل، وهذا قول أبي حنيفة، وأنه إنما تكون الكفارة فيه شاة؛ لأنه لا يؤكل.
- ثمّ في قول لأبي حنيفة وقال الزُّفَرْ: يجب أن يكون مُقدّرًا بلغ ما بلغ من النَّعم، فيُخرَجْ كفارة على هذا الصيد.
- ولكن قال الإمام الشافعي وغيره: أن الصيد ما يؤكل لحمه، فلا يجب الضمان في قتل سَبُعْ.
- وكذلك قال الحنفية بالنسبة للفواسق الخمس: أنها تُقتل ولو في الحرم ولا كفارة فيها، هذا باتفاق.
- ولكن فيما عدا ذلك؛ فيقول الإمام أبو حنيفة: أنّ الفواسق الخمس هذه المذكورة في الحديث إذا قتلها وسط الحرم لا ضمان عليه، أما غيرها ولو كان سَبُعْ فعليه الضمان.
- وقال الشافعية: المراد بالصيد المتوحش المأكول.
قال تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) [المائدة:96]؛ فيقتضي حِلَّ صيد البحر بالكلية صحيح، وحِلَّ صيد البر خارج الإحرام، وثبت أن الصيد ما يَحِلُّ أكله.
(وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا)؛ معناه: يصير حلالًا إذا لم تكن حرامًا، معناه يَحِلُّ أكله، حلال لكم، قال: فبهذا استدلَّ الشافعية ومَن وافقهم على أنه لا يسمى صيد إلا إن كان يحلُّ أكله، فصيد البحر كله يحلُّ أكله، لكن صيد البر مَا (دُمْتُمْ حُرُمًا)؛ منه ما يحلُّ ومنه ما يحرم، فالذي يحلُّ لغير المُحرِم هو الحرام عليه وقت ذلك الإحرام، وفي الاتفاق على الفواسق أيضًا دليل لهم: "خمسُ فواسِقَ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ" يقول -عليه الصلاة والسلام-، وقال أبو حنيفة: السَّبُعْ صَيدْ،
ليثٌ تربّى رِبيةً فاصطِيدَ
ويذكر في بيت يُنسب لسيدنا علي، قيل ما يثبت عنه، يقول:
صيدُ الملوكِ أرانبٌ وثعالبُ *** وإذا ركبتُ فصيدي الأبطالُ
ولم يثبت هذا عن سيدنا علي.
فقال الإمام أحمد كالإمام الشافعي: الصيد ما جمع ثلاثة أشياء:
- أن يكون مباحًا أكله
- ولا مالك له
- ممتنعًا متوحشًا
فهذا هو الصيد.
- فما ليس بمأكول لا جزاء فيه، كسباع البهائم والمستخبث من الحشرات.
- إنما جُعلت كما يقول الإمام أحمد: الكفارة في الصيد المحلّل أكله، فهذا هو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد.
- ولكن عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام مالك: أن الصيد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، إلا المستثنيات.
(وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) [المائدة:96]؛ أي: وأنتم حُرُمْ، يعني: حال كونِكم محرمين، إمّا دخلتم في الحَرَم، أو أحرمتم بحجٍّ أو عمرة في أي مكانٍ كان.
"(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً)"؛ لم يقل: ومن ذبحه، لماذا؟ ومن قتله، لماذا؟ لأن المُحرم ما يَحل ذبيحته، فكلّه مقتول، سواءًا بإرسال صيد و إلا بتركه والذبح، وإن ذبح فهو مقتول هذا كله؛ لأنه ما يعتبر مُذكّى -أي: شرعًا-، "(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [المائدة:95]".
"خمسٌ يقتُلُهنَّ المُحرم في الحِلِّ والحرم"؛ فهي مقتولاتٌ كلها مُحرَّمات. وهكذا يقول بعض أهل الفقه: لو نذر أنَّه يذبح شاة وجب عليه ذلك، ولو نذر أن يقتل شاة.. كيف تقتل شاة؟ ما يلزمه فيها شيء، فرق بين القتل والذبح.
"(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً)"، فقوله: "(لَا تَقْتُلُوا)"؛ يفيد المنع من القتل ابتداءً، والمنع منه تسببًّا، فليس له أن يتعرّض إلى الصيد ما دام مُحرمًا، لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور، وسواءً كان صيد الحِلّ أو صيد الحرم ما دام مُحرمًا.
"(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً)"؛ يقولون أنَّ قيد العمد ليس للاحتراز، (فَجَزَاءُ مِثْلِ) أو: "(فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)"، ما المراد بالمماثلة؟ "(مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)"؛ اعتبار الخِلقة والهيئة، كما يقول الإمام مالك والإمام الشافعي: مثيله في الخِلقة والهيئة.
وعند الإمام أبي حنيفة (مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) بالقيمة، قيمته تجيب بقرة؟ أو تجيب بدنة؟ أو تجيب شاة؟ إيش قيمة هذا الصيد الذي قتله؟ فالمماثلة باعتبار القيمة عند أبي حنيفة، ويقال: يُقوَّم الصَّيدُ حيث صِيدَ، فإنْ بلغ ثمن هدي يُخيَّر بين أن يُهدي ما قيمته قيمته، وبين أن يشتري بها طعامًا، هذا عند الإمام أبي حنيفة.
"قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً) [المائدة:95]"؛ وهو للترتيب عند الشافعية لا للتخيير، باعتبار الخِلقة والهيئة عند الأئمة الثلاثة وباعتبار القيمة عند الإمام أبي حنيفة المماثلة (مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)؛
- مثله في الهيئة والخلقة عند الأئمة الثلاثة.
- ومثله في القيمة عند الإمام أبي حنيفة -عليه رحمة الله تبارك وتعالى-.
وهكذا..
- فقضوا في النعامة ببدنة لأنها تشبهها.
- وحكم أبو عبيدة بن عباس في حمار الوحش ببدنة، وحكم عمر -رضي الله عنه- فيه ببقرة.
- وحكم عمر وعلي -رضي الله عنهما- في الظبي شاة، بمثله شاة.
وهذا قد تم فيه الحكم فعليه مَنْ بعد. وإلا (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ) من أهل العلم اثنان يقول هذا يساوي كذا، وهذا يشابه من النعم كذا.
وأشبه النَّعَم بالنعامة البدنة من جهة الخلقة، وجاء مرفوعًا: "في الضبع كبش" (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ).
فإذًا: عند أبي حنيفة يقوَّم الصيد في المكان الذي قُتل فيه، أو في أقرب المواضع إذا كان في البرية، فيقوِّمه ذوا عدل ثم هو مخيَّر في الفداء:
- إن شاء ابتاع بها هدْيًا؛ إن كان يأتي ببقرة أو بَدَنة أو غنمة وذبحه.
- وإن شاء اشترى به طعامًا وتصدَّق على كل مسكين نصف صاع من بُرٍ أو صاعٍ من تمر،
- وإن شاء صام
هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة.
فيقول محمد بن الحنفية كما يقول الشافعي: يجب في الصيد النظير، فيما له نظير:
- في الظبي شاة
- وفي الأرنب عناق
- وفي اليربوع جفرة -التي بلغت أربع أشهر-
- في النعامة بدنة
(فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ).
لأنَّ القيمة ما تكون من النَّعم؛ وما ليس له نظير، يقول لمحمد بن الحنفية أنَّه تلزم فيه القيمة كمذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، مثل العصفور، ولكن فهمتَ أنَّ أكثر أهل العلم يقولون في الحَمَام ما قضى به الصحابة وأنَّه شاة.
سؤال: إذا كان مذهبه شافعي وأراد أن يخرجه قيمة؟
الإجابة: عند العجز، إذا عجز عن إخراج البدنة يخرج القيمة، لأنَّه جَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، فإنْ عجز ما وجد، ينتقل إلى القيمة.
وفي حمار الوحش بقرة، وعن أحمد فيه بدنة، يقال في حمار الوحش بدنة، وقد يُفرَّق بين الكبير من حمار الوحش والصغير، فإذا زاد كبره عن عامة البقر وعن الغالب في البقر فقد قال جماعة من الأئمة: أنَّه فيه بدنة هذا حمار الوحش، وكما في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل.
وفي الرواية الأخرى مثل الشافعية وغيرهم أنَّه كما جاء عن سيدنا عمر: أنَّ في حمار الوحش بقرة، وفي الظبي جديٌ، وفي الأرنب عَنَاق، نعم.
(فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) يحكم بالمثل أو الجزاء، يحكم بالجزاء فيه أو بالمثل، (ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ) ذوا عَدْلٍ: يعني حكمان عَدلان منكم معشر المسلمين، (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) إذًا يجب في الصيد نظيره من الإبل والبقر والغنم، ثم يجعله هدي، أو طعام، أو صوم عند أبي حنيفة مُخَيَّر، قال محمد من الحنفية: الخيار إلى الحكمين فيهما،
- إذا حكما بالهدي يجب النظير
- إذا حكما بطعامٍ أو صيام فعلى ماقال أبو حنيفة
- إن لم يجد قوَّمه ثم اشترى به طعامًا طعمةً للفقراء
- ثم لعجزٍ عدل ذلك صومًا، أعني به عن كل مدٍ يومًا.
(يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ)؛ (هَدْياً)؛ أي: يهديه هديًا، (بَالِغَ الْكَعْبَةِ)؛ أي: يجب أن يذبحه في حدود الحرم، لا أن يذبحه عند الكعبة أووسط الكعبة يدخل يذبحه لا! يعني: حرم الكعبة، يعني يذبحه ويتصدَّق به في حدود الحرم، لا أن يروح عند الكعبة (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) يدخل الحرم يجيب هديه يذبح، هذا لا يجوز، ولكن معنى بالغ الكعبة: يعني بالغ الحرم الكعبة.
- وهكذا يقول المالكية: أنَّ جزاء الصيد لمساكين الحرم إذا كان بمكة، أو كان من الصيد فكل مكة، قال تعالى: (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ)،
- ومن كان من فدية الرأس فحيث حلق الرأس عند الإمام أحمد، حيث حلق الرأس يلزمه الفدية.
كما ذكر الإمام النووي: أنَّ ماوجب لارتكاب محظور أو ترك مأمور لايختص بزمان؛ يجوز في يوم النحر وغيره، اما المكان يختص بالحرم، يجب ذبحه بالحرم فلا يجوز أن يذبحه خارج الحرم، ولا أن يقسِّمه خارج الحرم على المعتمد لقوله تعالى: (هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ).
(أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ) أو كفارة بدل ذبح الصيد (طَعَامُ مَسَاكِينَ)، ما هي الكفارة؟ هي طعام مساكين، فلفظة (أَوْ) هذه عند أكثر العلماء للتخيير، وفي رواية للإمام أحمد وبعض السلف أنها ليست للتخيير؛ ولكن فيها من الترتيب.
(أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً) يرى كم يأتي قيمة ذلك الحيوان من الطعام فيخرجه طعامًا، فإن عجز عن ذلك فيحسب عدد الأمداد ويصوم بعدد أيامها، وهذا تعب.. (لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ) عليه الجزاء ليُكَفِّر ويذوق سوء عاقبة هتكه لحُرمة الحرم الميمون، وجب ذلك ليذوق وبال أمره، وجب الجزاء بأقسامه الثلاثة ليذوق وبال أمره، والوبال: ما فيه الثِّقَل والمكروه.
"قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلاَلٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْ قَتْلِهِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.".
"قَالَ مَالِكٌ: وَالأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ."
"قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ: أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا، أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْماً، وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ، فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِيناً، صَامَ عِشْرِينَ يَوْماً، عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِيناً."
يعني: لكل مسكين مُدًّا، فعلى عدد الأمداد يصوم.
"قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلاَلٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ."، وهو كذلك، والله أعلم.
رزقنا الله الإيمان والإنابة، والخشية والاستقامة، وأتحفنا بالمنن والمواهب والمزايا والكرامة، وفرّج كروب المسلمين، ودفع البلاء عن المؤمنين، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.
21 شوّال 1442

