شرح الموطأ -186- كتاب الحج: باب ما جاء في التمتع، وباب ما لا يجب فيه التمتع
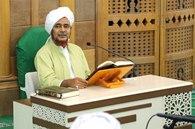
شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب ما جاء في التمتع، وباب ما لا يجب فيه التمتع.
فجر الأربعاء 14 شوال 1442هـ.
باب مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ
981 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أبِي سُفْيَانَ - وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ - فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي. فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ.
982 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.
983 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ، وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ.
984 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا وَسَكَنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ.
985 - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ، حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ، أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ هُوَ مُتَمَتِّعٌ، وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَإِنْ أَرَادَ الإِقَامَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَدْيُ، أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ، وَلاَ يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.
986 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُول: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ فِي ذِى الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.
باب مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ
987 - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ, أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ.
988 - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلاَ صِيَامٌ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا.
989 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا - كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا - فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِى دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ دُونَهُ، أَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْي أَوِ الصِّيَامِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة:196].
نص الدرس مكتوب:
الحمد لله مُكرمنا بأنوار الشريعة والهدى، ودالِّنا على الحق ببيان عبده المصطفى المقتدى، صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وأصحابه السعداء، وعلى من والاهم في الله وتابعهم بإحسان فيما خفي وما بدى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، من لهم شرَّفَ الرحمنُ ومجَّدا، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعدُ،
يواصل سيدنا الإمام مالك -رضي الله عنه- ذكر أبواب الحج، ويذكر: "باب مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ" التمتع بالعمرة إلى الحج، كما قال تعالى: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)[البقرة:196]، ومعناه أن يعتمر في أشهر الحج من ليس من أهل مكة، ثم يحرم بالحج من مكة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه حينئذٍ ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد شيئًا يذبحه؛ أي: لم يقدر على ذلك، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعةٍ إذا رجع إلى بلده.
وعلمنا أن الحج يؤدّى على إفرادٍ، وقِران، وتمتع، وأن كلاً منها قد جاء عنه ﷺ، وقال بأفضليته بعض الأئمة:
- فقال الحنفية بأفضلية القِران، ومعناه بأن يُحْرِم بالحج والعمرة معًا، أو أن يُدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف عندهم أكثر الأشواط، هذا هو القِران.
- وأما ما قال المالكية والشافعية: فالإفراد أفضل، ومعناه أن لا يُحْرِم إلا بالحج مفرِدًا، ولم يكن قد اعتمر في أشهر الحج من نفس العام، فيؤخِّر عمرته إلى مابعد الحج.
- والذي قاله الحنابلة: أن التمتع هو الأفضل، ومعناه بأن يُحْرِم بالعمرة أولاً ويكملها، ثم يُحْرِم بالحج بعد إتمام العمرة.
فهذه الثلاثة الأوجه التي يؤدّى عليها الحج والعمرة، ويندرج فيها صحة أن يقول المُحْرِم: أحرمت بما أحرم به فلان، فيلحق به، إن كان قارنًا، أو كان متمتعًا، أو كان مفرِدًا، فإن لم يعلم كيف حج فلان، قَرَنَ للاحتياط، وأخرجَ الفدية.
ثم أن ذلك مما ورد عن سيدنا عليّ، أنه لما سمع رسول الله ﷺ: "بمَ أهللت؟" قال: "أهللتُ بما أهلَّ به رسول الله"، فقال: سُقْتَ الهَدْيَ؟ قال: نعم، قال: فكُن على إحرامك حتى تقضي حجّتك.
يقول: "باب مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ"؛ فيكون متمتعًا إذا جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، وفي عام واحد. فلو اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام إلى عامٍ ثانٍ فحجَّ، لم يكن متمتعًا. وأن يفعل العمرة أو شيئًا منها في أشهر الحج. فلم يشترط المالكية أن يُحْرِم بها في الحج بحيث إن أحرم في رمضان ثم عمل شيئًا من أعمال العمرة ولو السعي، ولو بعض أشواط السعي في أشهر الحج صار متمتعًا.
- والشافعية والحنابلة يقولون: لا يكون متمتعًا حتى يُحْرِمَ بالحج في أشهر الحج، فإذا أحرم في رمضان -مثلاً- فليس من أشهر الحج، وأتمَّ العمرة في شوال، فليس متمتعًا.
- وأما المالكية قالوا: إذا عمل شيئًا من أعمال العمرة في أشهر الحج فهو متمتع.
- واعتبر الحنفية الأكثر، إن كان الأكثر عملها قبل أشهر الحج، فليس بمتمتّع، وإن عمل الأكثر من أشواط الطواف والسعي في أشهر الحج فهو المتمتع.
وهكذا، ولا يكون من حاضري المسجد الحرام -كما ذكر الحق تبارك وتعالى- وأما عند الشافعية والحنابلة -كما ذكرنا- أنه لا يكون متمتعًا إلا إن أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في أشهر الحج. فلو نوى الإحرام بالعمرة آخر جزء من رمضان، وأتى بأعمالها في شوال، فليس متمتعًا، ولا يلزمه دم تمتعٍ.
فاشترط في الشافعية في دم التمتع:
- أن يُحْرِم بالعمرة في أشهر الحج.
- ويتمّها.
- وأن يحج من عامه.
- وأن لا يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج منه.
وإذا عاد إلى الميقات فأحرم بالحج منه انقطع تمتعه.
وقال الحنفية: إن عاد إلى أهله، وأتى إتيان إلتمام بمعنى أقام فيهم، انقطعت عمرته، وإلا إن لم يكن فعلى ذلك فهو متمتع. وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، فحاضرو المسجد الحرام هو من كان من أهل مكة، ومن كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين -أقل من مسافة القصر.
وهكذا الكلام عن العمرة، والعمرة ثابتة -كما ذكرنا- فما فُهِمَ من نهي سيدنا عمر -رضي الله عنه- إنما كان يحث الناس على ما رآه أفضل -وهو الإفراد- وهو أراد أن يُعْمَرَ البيت في أشهر الحج وغيره، والإتيان إليه لأجل العمرة، أما التمتع ما يكون إلا بإحرامٍ في أشهر الحج، ويترتب عليه الهدي. فدعا وندبَ إلى الإفراد، وكأنه كان يراه الأفضل، ولم يكن ينهى عن التمتع لتحريمٍ فيه، ولا لكراهةٍ في ذاته، وإنما دعا إلى الأفضل، ففهم بعضهم غير ذلك.
وأورد الإمام مالك هذا الحديث: يقول: "سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أبِي وَقَّاصٍ، وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أبِي سُفْيَانَ - وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ - فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلاَّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي. فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ". وهذا فيمن فَهِمَ وظَنَّ أن سيدنا عمر نهى عن العمرة لذاتها، وليس الأمر كذلك، فإنما أراد فسخ الحج إلى العمرة، أو العمرة في تفضيلها على الإفراد، والإفراد أفضل عنده، وما إلى ذلك، فهذا هو الذي أراده سيدنا عمر رضي الله عنه.
وجاء عن سيدنا عمر -كما جاء في صحيح مسلم- أنه لما سأله سيدنا أبو موسى عما تحدَّث الناس أنه نهى عن العمرة، فقال سيدنا عمر: قد علمت أن النبي قد فعلها، ولكن كرهت أن يظل معرّسين بهن في الأراك، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم؛ بيَّنَ العِلَّة التي لأجلها ما أحب التمتع، ورأى عدم الترفُّه للحاج. يقول: هذا واحدٌ من الأوجه التي بسببها نهى سيدنا عمر عن العمرة"
والخلاصة: أن مجموع الروايات تدل على أنه لم ينكر أصل التمتع قط، ولم ينهَ عنه في ذاته، ولا في أصله، ولكن أرشدَ إلى الأفضلِ، وأحبَّ عِمارةَ البيت في غير أشهر الحج.
"فَقَالَ سَعْدٌ" يبيّن أن سيدنا عمر لم ينه عن التمتع بحد ذاته ولم ينكره في أصله "قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ." أي أنه في عام حجة وداعه كان معه كثيرون ممن حجّوا متمتعين، ولم ينهَ عن ذلك، ولم يزجرْهم عن ذلك، ولم ينكرْ ذلك ﷺ، بل أقرّهم على ذلك، والقرآن يقول: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)[البقرة:196].
ثم جاء:"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ" أي قبل أشهر الحج "وَأُهْدِيَ" أقدم الهدي الواجب عليه في أشهر الحج "أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ." أكد الرد على المنع عن التمتع، وهكذا.
وجاء عن ابن عمر أيضًا تفسيرُ ما جاء عن والده، ولما قيل له: إنك تخالف أباك! قال: إن عمر لم يقل الذي تقولون! ما توهمتم من النهي عن التمتع غير صحيح، قال: إنما قال أفردوا الحج من العمرة، فإنه أتم العمرة لأن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا أن يُهدى، وأراد أن يُزارَ البيت في غير أشهر الحج، فجعلتموها أنتم حرامًا، وعاقبتم الناس عليها، وقد أحلها الله -جل جلاله وتعالى في علاه- فهكذا، فعلمنا الخلاصة: أنه ما قصد سيدنا عمر النهي عن نفس التمتع، وكان يقره، بل صح عنه أنه قال: النبي قد فعله، وأعلم أن النبي فعله، فلم يكن ينكر شيئًا من ذلك، وإنما رأى أن الإفراد، وأراد أن لايهمَل البيت في غير أشهر الحج، إلى غير ذلك من مقاصده.
كما أشارت إليها الروايات الأخرى أنه أراد ألا يترفّهوا و يخرجوا من العمرة، ويترفهوا ويرجعوا مرة ثانية يحرمون بالحج، فما أحب ذلك، وأحب أن يتجرد المتجرد في توجهه حتى يقف بعرفة ويكمل الحج كاملاً، فهذا اختيار منه أو اجتهاد في الأفضل، وليس بنهيٍ عن التمتع.
وجاء أيضًا عن سيدنا عمر -رضي الله عنه- أنه بنفسه أنكر النهي عن التمتع، قال: أنا أفعلها. وجاء أيضًا عنه أنه قال لصبي معه أخبره أنه تمتع، وأنه أنكر عليه بعضُ الناس، وقال له: هُديتَ لسنة نبيك. إذًا، فالأدلة قائمة على أن سيدنا عمر لم يكن ينكر أصل التمتع.
ويقول: "عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ :وَاللَّهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ". وقال: "عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ" قال تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ)[البقرة:197] وهي:
- شوال
- وذي القعدة
- وعشر من ذي الحجة
وليس ذي الحجة كله شهر حج، ما يجوز يحرم بالحج في اليوم العاشر، وإنما هي عشر ليال وتسعة أيام، هذه داخلة في أشهر الحج (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ)، فهي عشر ليال من ذي الحجة، وليس يوم النحر من أشهر الحج، (فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ)، معلوم من أحرم بالحج في اليوم العاشر ما ينعقد حجّه، وحتى عند من قال بأن الشهر كله يُعد من أشهر الحج، هذا من جهة التسمية يسمى شهر حج، لأنه يصح الحج في أوله، ما معناه أنه يصح الإحرام بالحج، وإلا لوجب أن يبقى مُحْرِمًا طول العام إلى العام القادم حتى يقف بعرفة!! فهي إذًا: شوال؛ وذي القعدة؛ وعشر من ذي الحجة.
يقول: "ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ" من هذا؟ "مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ، وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ" إلى أهله، وهو إذًا فعليه أن يحرم بالحج في اليوم السادس ليصوم السادس أو السابع والثامن والتاسع، فيكون صام ثلاثة أيام في الحج. "قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا أَقَامَ" بمكة "حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ." أي: من نفس عامه، فلو لم يحج من عامه، أو خرج من مكة إلى بلده، لم يكن متمتعًا.
"قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا وَسَكَنَ سِوَاهَا" كان من أهل مكة، ولكن انقطع إلى بلد آخر، واستوطن مكان غير مكة، "ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِراً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا" من عامه "إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ"؛ لأنه انتقل حكمه من حكم المقيمين بمكة، ومن حكم حاضري المسجد الحرام، إلى الآفاقيين لاستيطانه خارج مكة، لأنه انقطع إلى غيرها، وسكن سواها، قال: "يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً، وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ." في عدم وجوب الدم، لأنه خرج من حكم أهل مكة، فصار حكمه حكم الآفاقيين باستيطانه خارج مكة.
قال: "وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ،"من الآفاقيين أيضًا "دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ" لكن يريد الإقامة بمكة، والاستمرار فيها، والتوطّن بها، وانتظر "حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ"منها "أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ هُوَ مُتَمَتِّعٌ" هذا لما دخل لم يكن مستوطنًا بمكة، بل ينوي الاستيطان، قد يستوطن أو لا يستوطن، الله أعلم، لكن دخل مكة محرِمًا بالعمرة، وهو من غير أهل مكة بعد، فنِيَّتُه الإقامة ما تنفعه هذا العام، حتى يكون متمتعًا، فإذا استقر بمكة، استوطن من العام القادم، صار من أهل البيت الحرام، وأما في هذا العام الذي وفد فيه، ليس من حاضري المسجد الحرام، لأنه آفاقي، وإنما ينوي الإقامة، فانتظر حتى تقيم أولاً، أنت الآن غير مستوطن، ولا ندري ما يحصل له، هكذا يقول الإمام مالك، "دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِمَكَّةَ، حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ، أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ هُوَ مُتَمَتِّعٌ، وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَإِنْ أَرَادَ الإِقَامَةَ،" لماذا؟ "وَذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَدْيُ، أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ"، وهذا منهم "وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ، وَلاَ يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ".
قد يأتي الشهر الثاني أو الثالث، ويقول خلاص سنرجع إلى البلاد.. فعلى كل حال ليس معدودًا الآن من حاضري المسجد الحرام بمجرّد نيته أن ينوي حتى يستقر فعلًا أو يأتي قبل أشهر الحج ويقيم بمكة، فهذا يصير من حاضري المسجد الحرام كما يجئ في المسألة. قال: "وَإِنَّمَا الْهَدْيُ، أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ"؛ يعني: وقت الإحرام بالعمرة "وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ، وَلاَ يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ" حتى يتهيأ له أسباب الإقامة أو يرجع بعد الحج "وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ."
وجاء: "عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُول: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ فِي ذِى الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ وَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ". وذكر المسألة في الباب الثاني: "باب مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ".
باب مَا لاَ يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ
قَالَ: "مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ, أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ"، إلى بلده "ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ، ثُمَّ حَجَّ." فرجوعه إلى أهله يقطع ذلك، وهكذا
- وكما قال في الحنفية: أنه شرط في التمتع عدم الإلمام بأهله."
- وأما الشافعية قالوا: عدم الرجوع إلى الميقات حتى وإن لم يرجع إلى أهله، ولكن عاد إلى الميقات للإحرام بالحج منه، سقط عنه دم التمتع عند الشافعية،
- ولم يسقط عند الحنابلة وأخذوا بعموم قوله: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
"قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ"؛ يعني: انتقل إليها وسكنها بنية الإقامة والتوطن فيها "مِنْ أَهْلِ الآفَاقِ وَسَكَنَهَا،" يعني: قبل أشهر الحج، "ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ"؛ لأنه قد نوى الإقامة والسكنى قبل أشهر الحج، فصار من أهل مكة، فلما أنشأ العمرة الآن، أنشأها وهو من حاضري المسجد الحرام، ففرق بينه وبين الأول، الأول أنشأ العمرة وهو ينوي الاستيطان، ليس من حاضري المسجد الحرام، أما هذا قد حضر المسجد الحرام، وقد توطن، ثم نوى العمرة من أشهر الحج، فهو من حاضري المسجد الحرام، "وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلاَ صِيَامٌ"؛ لأنه بمنزلة أهل مكة إذ كان من ساكنيها.
سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الأَسْفَارِ،" الرباط: الجهاد في سبيل الله تعالى، والأصل في الرباط، ملازمة ثغر من ثغور المحاربين المقاتلين من المسلمين، خرج بسفر من الأسفار، "ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَهُوَ يُرِيدُ الإِقَامَةَ بِهَا - كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ أَوْ لاَ أَهْلَ لَهُ بِهَا"، ولكنه ساكن في مكة أصلاً، وراح لغرض سفر معين، أو جهاد، وراجع، هذا لا يدخل في المتمتعين، هو لازال من أهل مكة؛ لأنه لم ينوِ الاستيطان في غير مكة، ولم ينوِ الانتقال منها، وإنما ذهب لحاجة، فلا يقطع ذلك أنه من حاضري المسجد الحرام، قال: "فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِى دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ دُونَهُ، أَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْي أَوِ الصِّيَامِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة:196]"، وهذا من حاضري المسجد الحرام إنما غاب عنه لحاجة ثم رجع فلا يؤثر ذلك، والله أعلم.
المراد بحاضري المسجد الحرام:
- قال مالك: أهل مكة، وأهل ذي طوى، حتى عدّ أن أهل منى، لو أقام أحد في منى وأحرموا بالعمرة، ثم أقاموا بمكة حتى حجوا، كانوا متمتعين. فسُئل سيدنا مالك عن أهل الحرم، قال: أيجب عليهم ما يجب على المتمتع؟ قال: نعم، وليس هم من أهل مكة، قيل: فأهل منى؟ قال: لا أرى ذلك إلا لأهل مكة خاصة.
- لكن الإمام الشافعي قال: حاضر المسجد الحرام من كان بينه وبين مكة أقل من مرحلتين، كلهم حاضري المسجد الحرام، إما إن سكن في نفس مكة، وإما قريبًا منها؛ ليس بينه وبينها مسافة القصر، فعدّهم كلهم من حاضري المسجد الحرام.
- فأما مذهب مالك: أهل مكة، الذين يشاهدون المسجد الحرام ويحضرونه فقط هؤلاء أهل مكة، أما البعيدين منه، حتى في مِنى، ليسوا من حاضري المسجد الحرام، لأنهم لايشاهدونه من عندهم، ولا يسهل حضورهم فيه للصلوات وغيرها، فليسوا من حاضري المسجد الحرام.
أصلح الله أحوال والمسلمين، ورقّانا أعلى مراتب علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين، وكفانا ما أهمّنا من أمر الدارين، وما لا نهتم به وأنت أعلم به منّا، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين في لطفٍ وعافية بسِرّ الفاتحة إلى حضرة النبي ﷺ.
14 شوّال 1442

