شرح الموطأ -185- كتاب الحج: باب العمرة في أشهر الحج، وباب قطع التلبية في العمرة
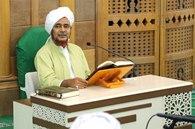
شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب العمرة في أشهر الحج، وباب قطع التلبية في العمرة.
فجر الثلاثاء 13 شوال 1442هـ.
باب الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
973 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ ثَلاَثاً: عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ، وَعَامَ الْجِعِرَّانَةِ.
974 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلاَّ ثَلاَثاً، إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ، وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ.
975 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ، قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.
977 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ أبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يَحُجَّ.
باب قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ
978 - حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ.
979 - قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ: إنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ.
980 - قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ : أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ. قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.
نص الدرس مكتوب:
الحمد لله مكرمنا بشريعته ودينه، وبيانه على لسان حبيبه وأمينه سيدنا مُحمَّد، صلى الله وسلم وبارك وكرّم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل محبة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين، وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
وبعدُ،
يواصل سيدنا الإمام مالك -رضي الله عنه- في الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بالحج وأبوابه، ووقفنا على "الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ". وكان من آخر ما تقدم معنا في موطأ الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- أنه ذكر لنا مسألة من أرسل الهَديَ إلى الحرم الشريف لتُذبح هناك، أنّه ليس عليه أن يمتنع من شيء من محرّمات الإحرام، وعلمنا ما قال الحنفية: ممن إذا أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر وقلّد الهَدي وقد خرج معه، أنه بذلك يصير واجبًا عليه الإحرام، وما قال الحنابلة: أنه عندئذٍ بتقليده للهَدي قد صار مُحرِمًا.
ثم ذكر لنا القلائد، ومنها كذلك الإشعار،
- فالقلائد: ما يجعل في أعناق الإبل والبقر والغنم لتكون علامة على أنها مهداة إلى الحرم، لا يتعرّض لها أحد، فكانوا يهابونها حتى أن أهل النهب من القبائل وغيرهم إذا رأوا عليها القلادة أو الإشعار تركوها وما تعرّضوا لها؛ لأنها هدية الحرم، تعظيمًا لحرم الله -تبارك وتعالى-.
- وكذلك الإشعار؛ هو أيضًا مأخوذ من الإعلام والإنباء والعلامة، وذلك بأن يشخط في أحد جانبي الإبل أو البقر، ولا يكون للغنم إشعار، وإنما يكون للإبل والبقر، فيأخذ من دمها، يكشط من جلدها ثم يضعه على سنامها أثر الدم، فيكون هذا علامة أنها أُشعرت لأجل الحرم.
واستحبّوا الإشعار والتقليد للهَدي الذي يُهدى للحرم، إلا أنّ التقليد عام في الإبل والبقر والغنم، والإشعار خاص في الإبل والبقر.
وما يذكر عن الإمام أبي حنيفة: أنه كره الإشعار، فما كره أصل الإشعار وإنما أنكر ما أحدثه الناس من مبالغة في ذلك تؤدي إلى ضُرٍّ بالحيوان أو تأثُّرٍ له مع حر الحجاز إلى أن يتوفى أو غير ذلك، فأنكر ذلك ولم ينكر أصل الإشعار، فإذا اقتصر في الإشعار على قطع الجلد دون اللحم؛ فهو عنده سُنّة كغيره لمن يُحسِن الإشعار، سُنّة الاشعار عنده للهدي الذي يُهدى إلى الحرم كما هو عند بقية الأئمة -عليهم رضوان الله تبارك وتعالى-.
ثم كان آخر ما ذكر لنا أمس في المسائل: مسألة الحائض والنُفَساء، أنها تصنع كل شيء إلا أن تطوف بالبيت، فلا تطوف بالبيت، ولا يجوز لها دخول المسجد، ولا يجوز لها الطواف بالبيت. وقلنا أنّ عامة الأئمة اشترطوا أن يكون الطائف بالبيت مُتطهّرًا عن الحدثين وعن النجاسة، و لا يجب ذلك في السعي، وقلنا أنه في السعي سُنّة، يُسَنُّ أن يسعى متطهرًا، ولكن لو سعى على غير طهارة فالسعي صحيح بين الصفا والمروة، ولكن الأفضل أن يكون متطهرًا.
وعلمنا بذلك ما جاء في حكم الحائض أو النفساء؛ فما تفعل الحائض في الحج؟ تفعل كل شيء غير ألا تطوف بالبيت الحرام، فإذا أتاها الحيض أو النّفاس كما حصل لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، أنها لمّا خرجوا إلى ذو الحُليفة نَفَست، ثم مشت معهم في الحج، ولادة وسفر إلى الحج على الجِمال، ولا شيء من الدلع ودعوى الأطباء من كل جانب، وشيء من هذا الكلام -عليهن رضوان الله تبارك وتعالى-.
وكذلك حاضت السيدة عائشة، فقال: "اصنعي ما يصنع الحاجُّ غيرَ أن لا تَطوفي"، فإذا كان ذلك قبل إحرامها؛ فتُحرِم المرأة بالحج إما مفردة أو قارنة، ويمنعها الحيض والنفاس من أداء الطواف، تمكث حتى تطهر فتطوف، ولو كان بعد الوقوف بعرفة.
- والطواف والسعي واحد للقارن عند الأئمة الثلاثة.
- وقال الإمام أبو حنيفة: طوافين وسعيين؛ واحد عن الحج، وواحد عن العمرة.
- وقال غيرهم من الأئمة: أنه طواف واحد للحج والعمرة، وسعي واحد للحج والعمرة،
وقال الأئمة الثلاثة أيضًا: بأن طواف القدوم سُنّة، لكن الإمام مالك قال: إنه واجب، فلهذا إذا َقَدِمت مكة وهي حائضة لا تطوف، فإذا وقفت؛ طافت طواف الإفاضة، وليس عليها طواف القدوم. أما عند الإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبو حنيفة؛ لأن طواف القدوم سُنّة، وأما عند المالكية؛ لأنها كانت معذورة سقط عنها طواف القدوم لكونها وردت وهي ممنوعة من دخول المسجد، وهكذا..
- فأما إذا حاضت في أيام النحر ولم تَطُفْ بعد طواف الإفاضة، فهنا عند الحنفية يلزمها دم؛ لأنها أخّرت الطواف، مضى وقت يَسعها أن تطوف فما طافت إلى يوم النحر، اليوم الثاني جاءها الحيض في اليوم الثاني من أيام التشريق، قالوا: هذه أخّرت، وكان يمكنها أن تطوف من قبل.
- فأما إذا حاضت قبل يوم النحر أو بعده بوقت لا يكفي للإفاضة؛ فلا شيء عليها.
- فإذا حاضت بعد الوقوف، وبعد أن طافت طواف الإفاضة؛ تُتِمْ أعمال الحج وتنصرف، ويسقط عنها طواف الوداع.
وذلك ما حصل لصفية أم المؤمنين، فإنها حاضت بعد، سألها أَقَدْ طافت؟ أول قال: أحابستنا هي؟ تحبِسنا إلى أن تطهر، نقعد بعد انتهاء أيام منى، نقعد إلى أن تطهر وتطوف؟ قالوا: إنها قد طافت، سأل قال: أقد طافت طواف الإفاضة يعني؟ قالوا: نعم قد طافت، قال: فلا إذًا، خلاص هي غير حابستنا.
فإذًا؛ يسقط على القول بوجوبه، وهو عند الأئمة الثلاثة واجب طواف الوداع، يسقط عندهم على الحائض إذا أراد رفقتها أن يسافروا، فإذا أرادوا السفر فلا طواف عليها للوداع، ما دام قد طافت طواف الحج، طواف الإفاضة. وهو واجب عند الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، وهو سُنّة طواف الوداع عند الإمام مالك.
فطواف القدوم:
- قال الأئمة الثلاثة: بسنيّته
- ومالك بوجوبه.
وطواف الوداع:
- قال الأئمة الثلاثة: بوجوبه
- والإمام مالك: بسنيّته.
فإذًا، لا يجب عليها شيء إذا كان جاءها الحيض بعد أن طافت طواف الإفاضة، تُتِمْ أعمال الحج وتسافر، فإذا أراد رفقتها أن يسافروا قبل أن تغتسل فتسافر معهم، ويسقط عنها طواف الوداع على قول من أوجبه. وفي قول عند الشافعية: أنه سُنّة كالإمام مالك؛ طواف الوداع. والمعتمد عندهم: أنه واجب، كما هو المعتمد عند الحنفية والحنابلة؛ أن طواف الوداع واجب، أن يكون آخر عهد المسلم بالبيت الطواف.
باب الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
وذكر لنا في هذا الباب: "باب الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ"، وفي ذلك إبطال ما كان عليه الجاهلية، ويقولون: أنه في أشهر الحج لا يجوز العمرة، لا يَصح إلا حج، وأن من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، هكذا كانوا يقولون في الجاهلية، فأبطل النبي ﷺ ذلك قولًا وفعلًا، وجعل أن العمرة تَصِحُّ في أشهر الحج، وجاء به القرآن: (فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَیۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡیِۚ) [البقرة:196].
إذًا؛ فالعمرة في أشهر الحج، قال: العمرة في أشهر الحج جائزة، وعليه الأئمة، وعليه بيان رسول الله ﷺ بقوله وفعله، وذكر هنا الإمام مالك: "أَنَّهُ بَلَغَه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ ثَلاَثاً: عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ،"؛ ولكنها عمرة صُدَّ عنها ورجع، إنما أَحرَم وتحلّل بالذبح والحلق، ورجع.
ثم في عمرة "الْقَضِيَّةِ"؛ المقاضاة، الصلح الذي بينه وبين قريش، القضيّة، إذا قالوا قضية، ليس المراد به قضاء العمرة، ولكن اختلفوا فيه، هل يجب قضاء العمرة على المُحْصَرْ، إذا رُدَّ أو لا؟ فمن قال بأنه لا يلزمهم القضاء، وقالوا: إنما معنى القضية؛ ما قاضى عليه أهل مكة من الصلح معه ﷺ، وجاء في السنة الثانية -السابعة من الهجرة- واعتمر ﷺ، وهذا في ذي القعدة. كذلك ما كان من اعتماره عند رجوعه من الطائف اعتمر من "الْجِعِرَّانَةِ"؛ وكان في ذي القعدة، فهذه الثلاث عُمَرْ له بعد الهجرة الشريفة.
أما قبل هجرته؛ فقد حج حجات، واعتمر عمرات، لكن بعد أن هاجر إلى المدينة لم يعتمر إلا أربع عمر، ولم يحج إلا حجة واحدة، بعد هجرته الكريمة حج حجة الوداع؛ وذلك بعد فرض الحج، لم يفرض الحج إلا في السنة السادسة من الهجرة، فما حَجّ بعد فرض الحج إلا حجة الوداع.
وأما أيام كان بمكة؛ فقد كان يحج كثيرًا، بل يذكر بعض أهل السيرة أنه يحج كل عام ﷺ، وكان يحج من قبل النبوة وبعد النبوة، ومن قبل نزول الوحي عليه ومن بعد نزول الوحي عليه، كان يحج عليه الصلاة والسلام، ومن قبل نزول الوحي عليه كان يذهب إلى عرفة ويقف بها، بخلاف عامة قريش وأهل مكة فلا يخرجون عن حدود الحرم، ويكتفون بالوصول إلى مزدلفة، ويقفون فيها ولا يدخلون، ويقولون: هذا لغيرنا، أما نحن آل الحرم لا نخرج من حدود الحرم وغيرنا يخرجون، حتى ضلَّ على بعضهم بعير له فخرج يتبعه، فوصل إلى عرفة فوجد النبي ﷺ قبل نزول الوحي عليه في عرفة، قال: هذا من الحُمْس؛ يعني من قريش، ما الذي يأتي به إلى هنا؟ فكان ﷺ يُلْهَمُ أن يمشي على سنن إبراهيم، وعلى سنن الأنبياء قبله، وعلى ما أحب الله، لا ما ابتدعته قريش لنفسها، يتفاخرون بأنهم أهل الحرم، ويقولون نحن مالنا خروج من الحرم، غيرنا يذهب خارج الحرم، نحن نبقى وسط الحرم، ويحجّون ويأتون إلى مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، ولكنه ﷺ كان يذهب إلى هناك حتى من قبل نزول الوحي عليه ﷺ، يقف بعرفة، ويمشي، ويدخل مع الحجاج إلى مزدلفة ﷺ.
وأما بعد فرض الحج، بل بعد الهجرة، لم يحجّ إلا حجة واحدة، هي حجة الوداع؛ سمّاها حجة الوداع، وتحدّث بأنها حجة الوداع، ولم يخطر على بالهم معنى الوداع حتى تُوفّي ﷺ، فعلموا أنه وداعه لأمته صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله.
فمن ذَكَر العُمَر ثلاثًا، لم يحسب عمرة الحج، العمرة التي كانت مع الحج، وهي كذلك على قول من قال: إنه كان مفردًا ولم يكن قارنًا، وأما على القول بأنه قارن: فهي الرابعة، فتكون أربع عُمَرْ التي اعتمرها بعد هجرته ﷺ.
"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ ثَلاَثاً" سوى التي قرن بحجته عند غير مالك، وعند مالك؛ هو كان مفرد، وكذلك عند الشافعية؛ أنه كان مفردًا، فما وجدت إلا الثلاث عُمَرْ التي اعتمرها. وكان توجهه ﷺ من المدينة في يوم الاثنين مُستَهَلَّ ذي القعدة في سنة ست، خرج قاصدًا للعمرة وصدّه المشركون عن الوصول، ففي السنة الثانية جاء معتمرًا ﷺ، وأقام بمكة ثلاثًا، ثم عاد إلى المدينة المنورة. وقول البراء أن النبي اعتمر عمرتين قبل الحج؛ فأراد به عمرة القضاء وعمرة الجعرّانة عند رجوعه من الطائف، فلم يحسب عمرة الحديبية؛ لأنهم صدّوه ولم يدعوه يدخل، ما فعل من أعمال العمرة إلا الإحرام، ثم تحلل بالذبح والحلق ﷺ.
إذًا؛ فكانت عُمَرُهُ في أشهر الحج -عليه الصلاة والسلام-، في أشهر الحج كلّها، فهذا رَدٌّ على الجاهلية فيما كانوا يمنعون أن يُعتَمَرَ في أشهر الحج. وحضر معه عمرة القضاء أو عمرة القضية من لم يكن حاضرًا معه في عمرة الحديبية؛ فإنهم كانوا نحو ألف وأربعمئة وشيء في عمرة الحديبية، ثم كانوا في عمرة القضاء معه ﷺ نحو ألفين، اعتمروا معه ﷺ.
وهكذا، قلنا اختلف الأئمة في وجوب القضاء على من صُدَّ عن البيت الحرام وكان قد أحرم.
- فعند الإمام مالك: لا قضاء عليه، وأنه تمت عمرته بتحلله حيث ما أُحصر بنحره وبحلقه وخلاص يرجع، وأنه تمت عمرته ولا قضاء عليه.
- ولكن قال أكثر العلماء: أنه عليه القضاء، فيقضي متى ما تمكّن من الدخول إلى هناك، فإنه ﷺ لمّا تحلل زمن الحديبية قضى مِن قَابِل، سُميت عُمرة القضيّة، وعمرة القضاء كذلك في تسمية أخرى
- وعند الشافعية كذلك عندنا قول كمثل الإمام مالك: أنه لايلزم فيها القضاء.
وذكر لنا بعد ذلك حديث هشام بن عروة: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلاَّ ثَلاَثاً، إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ"؛ فحملوا على أنه أحرم في شوال لكن لم يُؤدّي العمرة إلا في ذي القعدة، فهذه عُمَرُهُ -عليه الصلاة والسلام- من بعد هجرته إلى المدينة المنورة.
إذًا؛ فالعمرة لا ميقات لها زماني، جميع العام صالح للعمرة، إلا بالنسبة للحاجِّ فهو في أيام الحج في اشتغاله في الحج ما يستطيع أن يعتمر، إذا كان مثلًا في مِنى، قال: معنا وقت وفرصة نروح نؤدي العمرة، أكملت أعمال الحج؟، رميت الرمي الثاني ونفرت؟ ابقى في مكانك، لا يصحّ لك العمرة حتى تكمّل حجك، ولا يَصح منه العمرة.
قال: فرصة جالسين، نخرج نعتمر، لا تصحّ منك العمرة حتى تكمل أعمال الحج! أكمل، إذا رميت الجمار في اليوم الثاني ونفرت النفر الأول جاز لك أن تعتمر، أو تأخرت إلى اليوم الثالث وأكملت رمي الجمار الثلاث يجوز لك أن تعتمر، وأما قبل أن تكمل أعمال الحج لا يجوز لك أن تعتمر. أما غير الحاج: في جميع السنة يعتمر، في أي شهر كان يصح العمرة، وهكذا. إذًا؛ لغير الحاج المشتغل بالحج فجميع السنة ميقات للعمرة.
قال جمهور أهل العلم: ويستحب الإكثار منها، ولا يُكره تكرارها في السنة الواحدة، وهكذا عليه عامة أهل العلم. ويروى عن بعض السلف: أنه في كل شهر مرة. وكان أنس إذا حمّم رأسه خرج فاعتمر، يحلق هناك. وكان عكرمة إذا أمكن الموس من شعره ذهب إلى العمرة، وعلى كل حال؛ المذهب عند الجمهور: أن تكرار العمرة والمتابعة بينها داخل في السُنّة ولا شيء فيه.
وكره ذلك الإمام مالك فقال: يكره تكرار العمرة في السنة مرتين، ويروى عن الحسن وابن سيرين، جعلها مثل الحج في السنة مرة واحدة، ما يقدر في السنة يحج مرتين، والعمرة كذلك يعتمر مرة واحدة، ولكن الأمر فيه سَعَة. وقد كان بعض المجتهدين يغتنم العمرة خصوصًا في رمضان، فيعتمر في اليوم الواحد مرتين، وثلاث، إلى أربع عُمَرْ في اليوم والليلة، و "عُمرةٌ في رمضانَ كَحَجَّةٍ مَعيْ" يقول ﷺ، فحثّ عليها، ولم يعتمر هو بنفسه في رمضان، ولكنّه أخبر أنّ العمرة في رمضان تعدل حجة معه ﷺ.
وهكذا يسن للإحرام بالعمرة ما يُسَنُّ للإحرام للحج؛ من اغتسال، وتطييب البدن لا الثوب، وصلاة ركعتين سنة الإحرام، والتلبية عقيب النية؛ وهي واجبة وفرض عند الحنفية، وعند غيرهم سُنّة، ويُسن للمعتمر أن يكثر التلبية وهو الذي ذكره في الباب الثاني عندنا.
وأما ذكر: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ أبِي سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ"؛ كأنه أراد أن يعرف ما عند عُمر لأنه كان صغير السن، ولم يدرك أن رسول الله ﷺ قد اعتمر في أشهر الحج، فجاء يستأذن من سيدنا عمر، قال: نحن الآن في شوال وشهر حج، سأعتمر، فأذن له وذهب يعتمر، ورجع من مكة إلى المدينة ولم يحج في ذلك العام. فالمُتَمتِّع؛ من كان قَدَّم العُمرة ثم حجَّ من عامه، اعتمر في أشهر الحج، المعتمر في رمضان ما يُعدُّ ولو حجَّ من نفس العام ما يكون مُتمتِّعًا، ولكن من اعتمر في شوال، أو ذي القعدة، أو أول الحجة، ثم حجّ من نفس العام صار مُتَمتِّعًا.
وقلنا: يُسنّ أيضًا، أن يلبي المحرم بالعمرة كما يلبي الحاج، إلى أين يستمر؟ يستمر عند الأئمة إلى أن يصل إلى الحرم، إلى أن يبدأ بالطواف، أن يستلم الركن، فإذا استلم الركن في بداية الطواف انقطع عن التلبية واشتغل بالأذكار.
- يقول الإمام مالك: إذا أَهلَّ بالعمرة من ميقات من الخارج، فلا يزال يُلبّي إلى أن يدخل الحرم، فإذا دخل حدود الحرم قطع التلبية.
- وإن أَهلَّ من أدنى الحِلْ، كان في مكة من أدنى الحِلْ، فيُلبّي إلى أن يرى الكعبة، هذا عند مالك.
- قال غيره من الأئمة: أنه يُلبّي إلى أن يستلم الحجر، إلى أن يستلم الركن؛ يعني إلى أن يبدأ بالطواف، فيُسن له، فلا يزال يُلبّي إلى أن يبدأ بالطواف، فقد أَجبتَ النداء الآن، وصلت إلى حيث أُمِرْت، إلى البيت، حينئذٍ يشتغل بالدعاء والأذكار في الطواف غير التلبية.
باب قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ
قال: "باب قَطْعِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ" قال: "أَنَّهُ كَانَ -عروة- يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ."؛ هذا مذهب مالك. "قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ: إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ."؛ يعني من أدنى الحِلْ؛ التنعيم، أو الجِعرَّانة، أو الحُديبية، وأما من كان مُحرِمًا من ميقات بلده؛ فيُلبّي إلى أن يصل الحرم.
"سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ، مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟ قَالَ: أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ."؛ إذا دخل حدود الحرم، "قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.". إذًا؛
- المُعتمر الآفاقي عند مالك يُلبّي حتى يبلغ الحرم.
- والمعتمر من الجِعرّانة أو التنعيم أو الحديبية يلبي إلى دخول بيوت مكة أو إلى رؤية الكعبة.
- إذًا؛ المعتمد يقطع التلبية عند شروعه في الطواف واستلامه الحجر عند الأئمة الثلاثة: الحنفية والشافعية والحنابلة.
وعند الإمام مالك هذا التفصيل الذي ذكرناه، والله أعلم.
رزقنا الله الإنابة والاستقامة، والصدق والإخلاص والتوفيق، وقَبِلَنا والحُجّاج والعُمّار، وزائري زين الوجود ﷺ، وزائري بيت المقدس، بقبول يدفع به عنا شرَّ المعتدين والظالمين والغاصبين، وشر أعداء الدين، ويجعلنا في الهداة المهتدين، ويُرقّينا أعلى مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.
13 شوّال 1442

