شرح الموطأ - 184 - كتاب الحج: باب ما لا يُوجب الإحرام من تقليد الهَدي، وباب ما تفعل الحائض في الحج
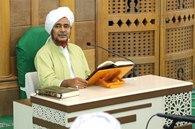
شرح فضيلة الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي، برواية الإمام يحيى بن يحيى الليثي، كتاب الحج، باب ما لا يُوجب الإحرام من تقليد الهَدي، وباب ما تفعل الحائض في الحج.
فجر الإثنين 12 شوال 1442هـ.
باب مَا لاَ يُوجِبُ الإِحْرَامُ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْي
967- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النِّبِىِّ ﷺ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً، حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْي. قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.
968- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُول: لاَ يَحْرُمُ إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى.
969- وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّداً بِالْعِرَاقِ، فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ.
970- قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْىٍ لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ؟َ قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ وَلاَ يُشْعِرَهُ، إِلاَّ عِنْدَ الإِهْلاَلِ، إِلاَّ رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ.
971- وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْي غَيْرُ مُحْرِمٍ؟ فَقَال:َ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَسُئِلَ أَيْضاً عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْي مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ، فَقَالَ: الأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ، قَوْلُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِهَدْيِهِ، ثُمَّ أَقَامَ فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ هَدْيُهُ.
باب مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ
972- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ، وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلاَ تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ.
نص الدرس مكتوب:
الحمد لله مُكرمنا بشريعته وأحكام مِلَّته، ومُبيّنها على لسان خير بريَّته سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته، وعلى أهل ولائه ومتابعته ومحبّته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الحق -تبارك وتعالى- من خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المُقربين وجميع عباد الله الصالحين من كل مَن تولَّى الرَّحمن صفاء سريرته، وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين بمحض فضله ومِنَّته.
وبعدُ،
فيذكر الإمام مالك -عليه رضوان الله تبارك وتعالى- هذا الباب من كتاب الحج وهو "مَا لاَ يُوجِبُ الإِحْرَامُ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْي".
- والهدي: اسم لِمَا يُهدى إلى الحرم من النَّعم؛ الإبل أو البقر أو الغنم.
ومعنى يُهدى؛ أي يُبعث به من خارج الحرم إلى الحرم ليُنحر ويُذبح في الحرم. قال تعالى: (هَدۡیَۢا بَـٰلِغَ ٱلۡكَعۡبَةِ)[المائدة:95]؛ أي: يُذبح في حرم مكَّة المُكرَّمة. وسوْق الهدي قُربة من القُرَب؛ أن يُساق الهدي، وقد كان يحرص على العمل به كثير من الرَّاغبين في ثواب الآخرة، حتى منهم من كان في العهد السَّابق أن يوجد في عرفة بعض الأنعام تُباع، فيشتريها فيسوقها فيكون دخل بها من خارج الحرم؛ لأن عرفة خارج حدود الحرم، فيكون ساق هديه.
- والأصل أن يُبعث الهدي من بلد المُهدي؛ بلد الذي يُهدي إلى الحرم فيبعث من بلده شيئًا من الإبل أو البقر أو الغنم لتُذبَح في مكَّة المُكرَّمة، هذا هو الهدي الذي يُتطوع به.
- وأما مَن اشترى شيئًا وسط حدود الحرم في مِنى وفي مكَّة، فذبحه؛ فليس هذا بهدي؛ ولكن هذا:
- إما أن يكون أُضحية.
- وإما أن يكون فدية عن شيء من أعمال الحج.
- وإما أن يكون قُربة عامة لا يدخُل في باب الهدي.
والهَدْيّ: ما يُهدى إلى الحرم من خارج الحرم. فيقال له: هدي. وفي لغة ضعيفة: هَدِّيٌّ؛ ما يهدى إلى الحرم. والأفصح فيه: هَدْيٌّ. قال: "مَا لاَ يُوجِبُ الإِحْرَامُ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْي" ومعنى تقليد الهدي: إلباسه القلادة، وهي الوسم والعلامة التي تُعلَم بها أن هذا الحيوان مَهديٌّ إلى الحرم، فيُقلَّد في عُنقه وتوضع قلادة علامة على أنه مُهدى إلى حرم الله -جلَّ جلاله وتعالى في عُلاه-.
وفي الهدي وبَعثِه قُربة ثم أنه:
○ قد يكون المهدي الذي يهديه هو بنفسه مُتوجه إلى الحرم، كما كان في حجَّة الوداع منه ﷺ.
○ وقد يكون باعثًا للهدي وغير متوجه لأداء النُّسك، كما كان منه ﷺ في العام التاسع من الهجرة بعث بهدي مع أبي بكر الصِّديق إلى الحرم الشَّريف يُذبح عنه هناك وينحر يوم مِنى، ولم يكن نوى الحج ولم يخرج ﷺ لأجل الحج.
فصارت مسألتان:
1- مسألة خروج المُهدي بنفسه ونيّته النُّسك من الحج والعُمرة.
2- والثاني أن لا يكون شيء من ذلك ولكن يبعث بالهدي فقط.
فمُجرد البعث بالهدي كان فيه في الأول اختلاف بين بعض السَّلف من الصَّحابة، ثم ارتفع ذلك الاختلاف بما صح من فعله ﷺ، وأنه لا يحرم شيء على من بعث الهدي ولا يمتنع عن شيء. وقد كان بعض الصَّحابة يرى أنه إذا قد بعث هديًا لا يفعل شيء من مُحرَّمات الإحرام حتى يصل الهدي هناك ويُنحر يوم العيد، يوم مِنى؛ فيتحلل. ثم لمَّا شاع خبر عائشة عن النَّبي ﷺ رجع النَّاس من فتوى بعض الصَّحابة إلى ما صح في السُّنَّة الظَّاهرة عنه صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم، فلم يكن بعد ذلك خلاف بين الأئمة الأربعة. لم يكن بينهم خلاف في أن من بعث هديًا ولم يخرج بنفسه ولم يرد النُّسك أنه لا يحرم عليه شيء.
وبقي الاختلاف فيمن يُريد النُّسك وقلَّد الهدي وخرج بنفسه، هل بمجرد تقليد الهدي يحرم عليه شيء؟ أو لا يحرم عليه شيء حتى ينوي ويُحرم؟
- وذلك كما هو عند الشَّافعية وعند معظم الجُمهور: أنه لا يحرم عليه شيء وإن قلَّد الهدي حتى يُحرِم بالنية؛ بنية الدخول في الإحرام.
- وجعل الحنفية أن مَن قلَّد الهدي أن تقليد الهدي يقوم مقام التَّلبية عندهم؛ لأن التعبير عن الإجابة إما أن يكون بالقول كـلبّيك اللَّهم لبيك أو بالفعل وهذا التقليد للهدي عندهم إجابة بالفعل. فإذا كان يريد النُّسك، فبمجرد أن يقلِّد الهدي صار مُحرمًا، وحَرُم عليه ما يحرُم على المُحرِم.
فإذًا المسألة الأولى: لا خلاف فيها الآن بين الأئمة، وهو أن يبعث الهدي من دون وهو مُقيم في بلده؛ من دون أن يُريد الحج والعُمرة؛ فلا يُحرم عليه شيء كما يأتي في الحديث بعد هذا معنا عن عائشة عن النَّبي ﷺ. والمسألة الثانية: مَن ساق الهدي معه وأراد النُّسك؛
- وذكر الإمام ابن حجر أيضًا في الفتح يقول: ذهب جماعة من الفُقهاء ومن أهل الفتوى، أن مَن أراد النُّسك صار بمجرد تقليده الهدي مُحرمًا. وذكر أن ابن المنذر حكاه عن الإمام الثّوري وعن سيِّدنا أحمد بن حنبل وإسحاق، أنه يكون بمجرد تقليده الهدي مُحرمًا.
- ونقل عن الإمام أبي حنيفة ومن يُسمى بأصحاب الرأي: مَن ساق الهدي وأَمَّ البيت فقد أوجب عليه الإحرام؛ يجب عليه أن يُحرِم ويصير بذلك مُحرمًا.
- فجمهور العُلماء أنه لا يجب عليه الإحرام وإن قلَّد الهدي، -ولا يصير مُحرمًا كما هو عند الإمام أحمد بمجرد تقليد الهدي، ولا يجب عليه الإحرام كما هو عند الإمام أبي حنيفة- فجمهور العُلماء يقولون: لا يجب عليه حتى ينوي الدُّخول في الحج أو العُمرة؛ فحينئذ يصير مُحرمًا.
- واشترط الحنفية أيضًا للذي ينوي الإحرام من دون تقليد الهدي أن يُلبّي، فما يصير مُحرمًا عندهم بمجرد النِّية ولكن مع التَّلبية.
- وقال غيرهم: يكفي النِّية بأن ينوي الدُّخول في الحج أو في العُمرة.
يروي لنا الحديث عن "عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -الأنصارية-، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أبِي سُفْيَانَ" هكذا يُروى في الكتب. وزياد هذا كان يُسمى زياد بن عُبيد، كانت أُمه سُمية مولاة الحارث بن كلدة تحت عبيد هذا حين ولدته، ولم يزل يُدعى بزياد بن عُبيد. فلمَّا كان في خلافة معاوية بن أبي سفيان شهد عنده جماعة أن أباه أبا سفيان أقرّ بأن زيادًا هذا ولده، لا شك أن هذا كان من فعلهم في الجاهلية من قبل الإسلام، تكون الزوجة لآخر ويأتيها آخر ويدَّعي الولد له وما إلى ذلك. فاستلحقه معاوية لذلك، وزوَّج ابنه بنت زياد، وأمَّر زياد على العراق، حتى قال الشوكاني: استلحقه معاوية لغرض دنيوي وأنكر عليه من أنكر استلحاقه ونسبته إلى أبيه أبي سفيان، حتى قيل في ذلك أشعار في الاستنكار لنسبة زياد إلى أبي سفيان. ولكن شيخ الإمام مالك كان في وقت قوة حُكم بني أُمية ونقلوا بلفظ زياد بن أبي سفيان توقيًا للأذى والضُّر والشَّر منهم، فقالوا ذلك. فبقي الرّواة كما هي عادتهم يروون عن ذلك، يروون ذلك بما رواه الشُّيوخ لهم في أيام، وإن كان رووا بعد ذهاب حُكم بني أُمية ولكنهم يروون كما نقله عنهم الرّواة كما هو دأبهم في أن يضبطوا ألفاظ الرّواة فيما قالوه. وقال أهل العلم: لا يجوز نسبته إلى أبي سفيان لأنه شرعًا لا تصح النّسبة بحال.
"وأَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ بْنَ أبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النِّبِىِّ ﷺ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْياً، حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ"، من الطِّيب والنِّساء ولبس المحيط إن كان رجل "حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ: فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْي"؛ الذي أبعث معه الهدي. "قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ:" عندما عُرض عليها ذلك "لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، الحكم عندي "أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ" العُقد والخيط الذي يُركَّب في رقبة البعير. قالت: "أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ"، صلحت القلائد "ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ"؛ أخذها وقلَّد الجِمال التي يريد بعثها إلى مكَّة المُكرَّمة، "ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أبِي"؛ تعني: في العام التاسع من الهجرة، إذ أمَّر أبا بكر على الحج، وأمره أن يحج بالناس وبعث بقلائده معه ينحرها عنه في مِنى. قالت: "ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أبِي"، فهي بذلك تذكر هذه الحيثيات لتُبيِّن أنها حفِظت الواقعة تمامًا بأجزائها وهي التي بيدها قلَّدت والنَّبي بيده وضع، وفي السنة التاسعة، وبعثها مع أبيها أبي بكر؛ يعني أنها تتحدث عن واقعة حافظة لوقائعها من كل الجوانب ما تحتمل الشَّك، وأن ذلك أيضًا متأخرًا في المدينة ليس بفعله ﷺ وهو بمكة قبل الهجرة، وأن هذا متأخر وفي آخر عمره وأن أبوها ما فارق ﷺ إلى حج ولا غيره إلا في عام حجة التاسع من أعوام الهجرة المُشرَّفة، حيث بعثه أميرًا على الحُجاج، وألحق معه بعده علي بن أبي طالب -سيِّدنا علي- ليُبلِّغ للناس سورة براءة، وحج مع سيِّدنا أبي بكر الصِّديق وبلَّغ النَّاس سورة براءة، ونادى أن:
○ لا يحج بعد العام مُشرك.
○ ولا يطوف بالبيت عُريان.
○ ولا يدخل حدود الحرم غير المؤمنين والموحدين وليس فيهم مُشرك.
وحج في العام العاشر للهجرة- حُجَّة الوداع ﷺ. قالت: "ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ"؛ لم يَحرُم على رسول الله ﷺ شيء أحلَّه الله له؛ ما كان حلالًا فيه، لا من لباس ولا من غيره حتى نُحِر الهدي؛ يعني: في هذه الفترة التي ادَّعى فيها ابن عباس أنه يَحُرم على من بعث الهدي شيء، لم يتوقى ﷺ شيئًا من ذلك ولم يَحرُم عليه شيء من ذلك.
وهكذا نقل ابن الدّين أن ابن عباس خالف في هذا جميع الفُقهاء، ولكن ردوا عليه بأن عددًا من الصَّحابة كانوا يقولون ذلك، لكن ارتفع الخلاف بعد ذلك بعد وضوح السُّنّة، فلم يقل أحد من الأئمة الأربعة بحُرمة شيء على من بعث الهدي وهو لم يخرج معه، ولم ينوِ النُّسك، اتفقوا على المسألة. لكن كان في الزَّمن الأول وفي القرن الأول خلاف، فعدد غير ابن عباس ممَن قالوا بحرمة ذلك.
وورد أيضًا في حديث ضعيف لا يُحتج به عن سيِّدنا جابر أنه قال: كنت عند النَّبي ﷺ فشق قميصه، وقال: إني بعثت بهديي فنسيت فلبِست القميص. فردوا أن هذا مروي من طريق ضعيف ما يحتجّ به في الأحكام، وأن الحديث الصَّحيح الذي روته عائشة عنه ﷺ أنه "لَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ". العجيب في هذا الحديث يروون رواية عند الإمام مُسلم، أن ابن زياد -ولم يقل زياد بن أبي سفيان- ولكن سيِّدنا الإمام النَّووي وكل من تكلموا على صحيح الإمام مُسلم، قالوا في هذا، وهو من أحد الرّواة، والصَّحيح ما جاء في البُخاري وغيره: عن زياد، أن زياد بن أبي سفيان هذا الذي كان يدعى بذلك. وصار يدعى بعد ذلك فيما جُدّد من الكتب بعد ذلك: زياد بن أبيه، وقالوا فيه زياد بن أبيه، ولا يقولون زياد بن أبي سفيان لكن الرّواة يروون ما رواه لهم شيوخهم وكانوا الشّيوخ رووا ذلك في أيام ولاية بني أُمية، فتوقّوا أن يتعرّضوا للضرر بلا موجب لذلك. فلهذا قالوا: إن هذه الرّواية في صحيح الإمام مُسلم ما تصح أن ابن زياد ولكن زياد بن أبي سفيان هي التي عند البُخاري وفي موطأ الإمام مالك، والإمام مُسلم نقلها عن مالك، نقل عن مالك في الصَّحيح ولكن كل روايات مالك ما فيها أن ابن زياد ولكن زياد بن أبي سفيان.
"قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُول:ُ لاَ يَحْرُمُ" عليه شيء "إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى"؛ أهلّ: يعني أحرم بالهدي ولبّى؛ وفي هذا استدلال عند الحنفية بأنه لا بُد مع الإحرام من التَّلبية؛ لأنه قالت عَائِشَةَ: ".. إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى". وقال الآخرون: يكفي مُجرد نية الإحرام، والتَّلبية سُنَّة.
ثم ذكر لنا: "عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّداً بِالْعِرَاقِ" عن الثياب "فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ"، قال: ما له لماذا هو هكذا كأنه مُحرم وهو في العراق في البصرة؟ "فَقَالُوا: إِنَّهُ أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ. قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ"، فأخبره "فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ". فعَلِم أن هذا مُخالف للسُنَّة، فإنه ﷺ قد بعث بهديه ولم يتجرّد عن ثيابه ولم يُحرِم عليه شيء، فلهذا قال ابْنَ الزُّبَيْرِ: "بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ".
جاء في رواية ابن أبي شيبة، أنه رأى ابن عباس وهو أمير البصرة في زمان علي مُتجردًا على منبر البصرة، فذكره فكان في زمن سيِّدنا علي.
قال: "وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْىٍ لِنَفْسِهِ"؛ رجُل من أهل المدينة أو من أهل الشَّام ساق هديه وتوجه به مع هديه "فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ"؛ يعني: عند ميقات أهل المدينة مثلًا إذا كان من أهل المدينة، "وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ" ما نوى الإحرام "حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَة؟َ" يعني: ميقات أهل الشَّام، "قَالَ: لاَ أُحِبُّ ذَلِكَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ"، لأنه كان ميقاته ذي الحُلَيْفة لا الجُحْفة، وهذا عند المالكية لأنه لا يدخل في الإحرام إلا بالنية كما هو عند الجُمهور.
تقدَّم معنا نقل ابن المُنذر عن أحمد: أنه بمجرد تقليد الهدي وهو خارج معه يريد النُّسك؛ يصير محرمًا. وهذا الذي يذكر عند الحنفية؛ يصير يجب عليه الإحرام بمجرد فيصير بالتقليد للبُدن محرمًا إذا قصد النُّسك وخرج مع الهدي فالتقليد عندهم يقوم مقام التَّلبية، وقد قصد النُّسك وخرج مع هديه وقلَّده؛ فبالتقليد يصير مُحرمًا. قال: "وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ وَلاَ يُشْعِرَهُ، إِلاَّ عِنْدَ الإِهْلاَلِ"؛ يعني: الإحرام "إِلاَّ رَجُلٌ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ"؛ يعني: كما فعله النَّبي ﷺ.
"وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْي غَيْرُ مُحْرِمٍ؟ فَقَال:َ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ"؛ يعني: يجوز لكن لا يتجاوز به الميقات إلا وهو مُحرم إلا أن لا يريد دخول مكَّة.
- وهكذا يقول الحنفية أيضًا: لا يجوز لمريد دخول مكَّة التجاوز عن الميقات إلا مُحرمًا؛ يعني يحرُم عندهم تأخير الإحرام عند المواقيت لمَن قصد دخول مكَّة. وهذا عند الحنفية، وجوب الإحرام على كل من قصد دخول مكَّة ولو لحاجة؛ فيُحرم. لا يدخل الحرم إلا مُحرمًا تعظيمًا للحُرمات.
- وقال غيرهم: لا يجب عليه شيء إلا أن يقصد عُمرة أو حجًا فيجب عليه أن يُحرم من الميقات.
"وَسُئِلَ" مالك "أَيْضاً عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الإِحْرَامِ"؛ أي: عن ما قالوا من إحرام مَن يبعث بالهدي من إحرام "لِتَقْلِيدِ الْهَدْي مِمَّنْ لاَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ؟" فقال سيِّدنا مالك في جواب هذا السؤال: "الأَمْرُ عِنْدَنَا"؛ أي: في المدينة المُنوَّرة؛ يعني الذي أدرك عليه الفقهاء السبعة "الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذَلِكَ، قَوْلُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِهَدْيِهِ، ثُمَّ أَقَامَ"؛ يعني في المدينة "فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ هَدْيُهُ"؛ والمعنى أنه لا يلزمه إحرام، ولا يحرُم عليه شيء، وهذا قلنا المسألة مُجمع عليها، فيما بعد بعد القرن الأول.
باب مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ
وأما المسألة الثانية "مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ"، يقول: نقل "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا" وإن كانت في حيض أو نفاس "إِذَا أَرَادَتْ، وَلَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ"؛ لأن الطَّواف بالبيت يحرم عليها أن تدخل إلى المسجد وهي حائض أو نفساء، ولا يصح لها الطَّواف إلا بطهارة صحيحة. والحنفية عدّوا الطَّهارة من الواجبات التي تختلف عن الفرائض عندهم؛ الطَّهارة عن الحدث الأصغر والأكبر عدّوه من الواجبات، ولا فرق عند غيرهم بين الواجب والفرض.
وقال: "لَكِنْ لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"؛ لأن السَّعي بين الصَّفا والمروة لا يصح إلا بعد طواف، وهذه ما تستطيع أن تطوف "وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ"، وذلك كما جاء في الحديث المرفوع لما نفَسَت السيِّدة عائشة ورآها ﷺ حزينة، قال: ما لك أنفست؟ يعني أحضتِ؟. قالت: نعم. قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، تجيء إلى مِنى وتذهب إلى عرفة، وتعود إلى مُزدلفة، وترمي الجمار، وتنحر إن كان معها هدي، وتقصر شعرها؛ تفعل كل ما يفعل الحاج إلا الطَّواف حتى تطهُر. قال: "وَهِيَ" يعني: الحائض "تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ" لاشتراط الطَّهارة، "وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ"، لأنه لا يصح إلا بعد طواف كما عليه جمهور أهل العلم.
- فالسعي تبع للطواف، لا يصح إلا أن يتقدمه طواف إما طواف القدوم أو طواف الإفاضة من عرفة، وهكذا يقول الأئمة -عليهم رضوان الله-.
- وفي رواية عن الإمام أحمد، أن السَّعي بين الصَّفا إذا سعى قبل الطَّواف فأنه يُجزئه إذا لم يتعمَّد ذلك.
- والرّواية الأخرى كما هي رواية الأئمة الثلاثة، لا يجوز أن يسعى بين الصَّفا والمروة حتى يطوف.
قال: "وَلاَ تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ"، ويمكن فيه حتى تَطهَر؛ يعني: تتطهر. إذًا، فيمتنع عليها الطَّواف لأنه في المسجد، والحائض لا تدخل المسجد، وأن الحيض حدث يمنع صحة الطَّواف، فليست بطاهرة ولا بُد لها من الطَّهارة. فإذًا، يشترط الطَّهارة للطواف، لما جاء أيضًا في الحديث أن: "الطَّواف بمنزلة الصَّلاة إلا أن الله أحل فيه النُّطق"، فالنطق والحركة يجوز لكن لا يجوز إلا بطهارة كطهارة الصَّلاة؛ طهارة عن الحدث الأصغر والأكبر.
وفيه خلاف أيضًا عن الحنفية في المسألة، ولكن المُعتمد عندهم أن الطَّهارة واجبة ليست بفرض، وعندهم أيضًا قول في مسألة الحائض إذا خافت ذهاب الرِّفقة، أنها تطوف؛ تعصب وتطوف وعليها بدنة؛ تُخرج بدنة. إذًا، لا يصح الطَّواف من الحائض، بل من المُحدث كائنًا مَن كان. فيُشترط للطواف الطَّهارة، أما السَّعي فاختلفوا هل يجب أن يكون متوضئًا أو لا؟
- وقال الأكثر منهم الشَّافعية وغيرهم: أنه يُسن له أن يكون متطهرًا عند السَّعي بين الصَّفا والمروة
- فإن لم يكن مُتطهرًا صح السَّعي وكُرِه له ذلك
والله أعلم.
الله يُكرمنا بالصلاح والفلاح والنجاح والتَّقوى والاستقامة، ويدفع عنا الآفات، ويبلّغنا الأُمنيات ويرعانا بعين عنايته، ويثبتنا أكمل الثبات ويقينا كل سوء أحاط به علمه في الدَّارين، وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصَّالحين، ويعاملنا بفضله وبما هو أهله بِسِرّ الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد ﷺ.
13 شوّال 1442

